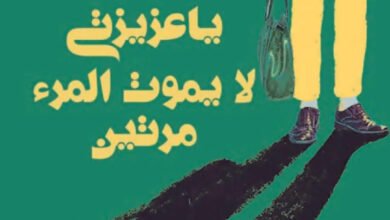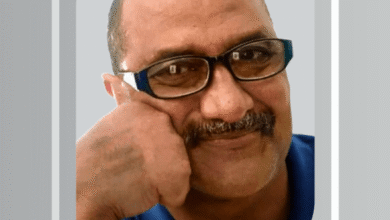حكاية من بيئتي
حلة ملوخية ستّهم

محمد أحمد الفيلابي
كالعادة صاحب تناول الوجبة ذلك الأنس البريء اللطيف الممتد لأكثر من ساعة، فقد كانت طبخة الملوخية (1) شهية، وزاد عليها أن جاءت الشقيقة الصغرى بـ(عقلة) (2) فجل. وكان كلما فرغ الصحن (الطبق) أو كاد، تسعى الشقيقة لجلب المزيد وهكذا.
وحين انفض السامر دخلت (ستهم) مطبخها الصغير لتتأكد من إحكام إغلاق الحلة، حتى يحين موعد الوجبة التالية، وإذا بها تطلق الصرخة.
ــ ووب علي ووب علي..
ــ مالك يا بت؟
جاءها الاستفسار من جارتها، لترد:
ــ حَلَّة ملوخيتي الطاعمة.
ــ ما لها.. إندفقت؟
ــ لا.
ــ أكلوها الشُّفّع؟
ــ يا ريتهم كان أكلوها؟
ــ نان مالها؟
ــ كمّلا الفجل.
وأصبحت الحكاية مما يتم تناوله في إطار تعليق الأمر على آخر. فالفجل ساعدهم على تناول كل ما وضع أمامهم، بيد أنه لم يكن هو من قضى على ما في الحَلَّة. وقد شبه أحدهم إلصاق تهمة اندلاع الحرب الأخيرة بالمدنيين بعقلة الفجل التي قضت على حلة (ستّهم).
ــ المدنيين المساكين بقوا فجل حلة ستّهم.
هي (ست البنات)، أو (ست الدار)، لا أحد يسأل، فقد طغى لقب الطفولة (ستّهم) وباتت لا تنادى إلا به. وقد كان يعني أنها (ست) إخوانها الستة، إنصافاً لها. ذلك قبل أن تختتم العقد (ست أبوها)، وحولوه إلى (سِتُّو). وكانت قد جاءت بعد سنوات طويلة بعمر تتالي الولادات هناك. أسماها أبوها هكذا حتى لا تحس الدونية أمام شقيقتها الكبرى، والتي سبقتها بسنوات كفلت لها الاستئثار بمحبة الجميع، لما تتمتع به من لطف وظرف وملاحة، حتى أن بعض أهل القرية يلقبونها (ست النعامين). وباتت لها صولات وجولات في بيوت مناسبات القرية اعترافًا بتخصصها النادر في طبخ الملوخية.
الأسرة الممتدة، والتي لا يكاد الغرباء التفريق تماماً بين أفرادها، لما يتمتعون به من تقارب في السحنات والأسماء تُنسيها لديهم الألقاب، فقد جبلوا على إطلاق الألقاب، عطفاً على ما يتمتعون به من اللطف والبساطة والمحبة. يطلقون عليهم (النعامين) نسبة لجدهم الكبير (النعمان). بيد أن الكثيرين يعتقدون أن الاسم إنما اشتُقّ من أشهر مفردة في قاموسهم اليومي (أنَّعَمِنُّو) يستخدمونها للتأكيد، ولربط الأحاديث. ولعل أصلها في اللغة (أن معناه، أو المعني أنه). لكن الغريب أن الواحدة أو الواحدة منهم لا يقال له (نعماني أو نعمانية)، بل (نعاميني ونعامينية). وهم في الأصل من قدامى السكان بالمنطقة، يحترفون الزارعة، ولا يقتنون من الأغنام والماشية والدواب إلا بما يكفي حاجتهم. يفلحون في زراعة الخضروات منذ عهد السواقي والنبرو (3). يعرفون خبايا البذور، ومواقيت الغرس، وطرق السقيا، تناسلوا وتكاثروا فيما بقيت مساحة الأرض الموروثة كما هي، بل قضم منها النيل كعادته في الأخذ والعطاء، لتزداد مساحة الجزيرة الموسمية المملوكة لغيرهم. وبعد أن ضاقت الأراضي بالورثة هاجر الرجال والشباب فزرعوا أراضي الغير، حيثما وجدوا أرضاً تصلح للزراعة، وأناساً يتوافقون معهم على إصلاح أراضيهم، يسافرون قريباً وبعيداً، وتبقى الأسر. من بينهم من جذبته الأراضي الضيقة على شريط النيل قرب الأسواق في المدينة الكبيرة.
إنه نهج التنمية العرجاء (4)، وإلا لكان لكل واحد من هؤلاء مساحة تكفيه وتكفي الأسواق هنا وهناك خضروات عضوية، وغذاء آمناً بدلاً عن شغل المساحات بالسلع النقدية، ترتفع أسواقها عاماً فتعمر الجيوب والبيوت، وتنخفض عاماً آخر فيعود الواحد إلى ما كان عليه من مكابدة الحياة. وبدلاً عن المساحات الشاسعة التي تحولت إلى صحراء بعد قطع أشجارها وحرمانها من الري. كما هي في تعبير القامة القدّال (يرحمه الله).
مزارع بتيبس.. ونيلك ممدّد جنازة . (5)
المساحات على النيل قرب المدينة الكبيرة يغدق عليها المزارعون بمن فيهم (النعامين) من المهاجرين الجُدُد أطناناً من الأسمدة الصناعية والمخصبات والمبيدات، حتى يمكنهم المنافسة في سوق المدينة الغارق في جهل المستهلكين، وتجاهل المسؤولين عن صحة المواطن وما يقدم له من منتجات. غير أنها تحظى بفترة الغمر، حين يفيض النيل وتنغسل التربة، وتعوض إطماء يضمن للزُّرّاع بداية الموسم بالإنتاج الخصب، يعودون بعده للرش وزراعة السموم في الأرض والخضروات، وفي أكبادهم فيما يسمى بالتسمُّم التراكمي (6). يتساقط على أثره المزارعون من أبناء (النعامين) قبل أن يصل الواحد منهم – أحياناً، إلى نصف العمر الذي عاشه أبوه أو جده.
(عمي السر) كان الأذكى من بينهم، وهكذا تقول الروايات، فقد كان أول من حزم حقيبته ويمّم صوب العاصمة. ولأنه لا يجيد سوى الزراعة فقد عمل في مزرعة جامعة الخرطوم، حين كان للجامعة مزرعة (6)، وللمزرعة ما تزرعه في الحقول البعيدة وفي العقول القابلة لاستقبال الغرس، ومن بينها عقل (عمي السر) الخصب. فقد خَبِر في سنوات معدودة، وهو يسمع شروحات الدكاترة والخبراء، مثلما يسمع للراديو (7) فيختزن ما يسمعه، ويهضمه ويحفظه. وقد جاء إلى أهله، بأسرار ومعارف ودروس، كان قد أسهم مع الطلاب في تجربتها، وغرسها ضمن حكاياته التي لا تُمَل في المخيلات. وعمل بيديه على تجارب نالت رضاهم، ليدخلوها ضمن قاموسهم الزراعي الفريد، ومن ذلك زراعة النادر من الخضروات والبُهار.
في مرة حاول أحد المتعلمين من أبناء الأسرة أن يداعب (عمي السر) ملامساً أكثر أوتاره حساسية (حبه للملوخية)، حين قال:
ــ هل سمعت بالحاكم بأمر الله (8) الذي حرّم أكل الملوخية.
ضحك ضحكته المعهودة حين يعدّل وضع عمامته الصغيرة إيذاناً بفتح ما يسميه بـ(القاطوع) (9)، ويقصد مخزن الذاكرة ليخرج الخبايا من المعلومات والأخبار والحكايات، وقال مخاطباً الآخرين لينزع ما قد يعلق بهم من مخافة تحريم أحب الأطعمة لديهم.
ــ ما تنغشّوا في كلام الأستاذ، الحاكم بأمر الله الفاطمي ده منع أكل الملوخية أنّعَمِنُّو كان معاوية بن أبي سفيان بحبها زيي كدي. وحاكمك ده يا أستاذ منع الجرجير الكانت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بتحبو، وكتّل كلاب البلد كلها عشان نبيحها قال عامل ليهو إزعاج.
ثم صمت قليلاً ريثما يحكّر سفته بذات الطقوس التي لا تنقص ولا تزيد. ولم يجد الأستاذ بداً من تأكيد الرواية والإشادة بمعرفة (عمي السر) وثقافته الكبيرة، وبدا كأنه يدعوه للمواصلة.
ــ هو فعلاً غريب الأطوار وقاسي، حظر صيد السمك القرموط، ومنع ذبح الأبقار.
ــ هو حاكم بأمر الله اسماً، وفعلاً هو حاكم بأمر نفسو زي حكامنا. إنت عارف يا أستاذ نحن بنحب الملوخية ليه؟
ــ أنا عارف سر محبة الفجل لأنو فيهو الألياف البتخفّف الإمساك، وبتخفّض الكوليسترول، وإنو كمان بقلّل من خطر الإصابة بقرحة المعدة وبيحمي أنسجة المعدة، وبعزّز الحاجز المخاطي. ولأنو نسبة الموية فيهو كبيرة بسهم في ترطيب الجسم. وكمان فيهو فيتامين سي وكمية من المعادن (10) الأساسية لي وظائف الجسم.
ــ تمام، ما قصرت يا أستاذ.. أها الملوخية دي قديمة قُدُم البشر، الفراعنة كانوا يسموها (خية) (11)، وكانت في البداية علاج، واتحولت طعام. وبرضك الملوخية فيها الفيتامينات البتقوّي الجهاز المناعي.
ــ نعم نعم (عمي السر) فيتامين أ، فيتامين ج، فيتامين هـ. و أ، هـ سوى بيحموا أنظمة الجسم من الأمراض عشان الخصائص المضادة للأكسدة. وكمان فيتامين ج عندو دور في تحفيز الوظيفة البتقوم بيها خلايا الدم البيضاء، وده طبعاً بساعد على منع تطور العديد من الأمراض.
ووقف (عمي السر) إيذاناً بوقف المؤانسة حتى إشعار آخر.
ــ أنا نازل (11) عندي بهايم دايرات ياكلن زي ما أكلنا نحن.
ورفع عقيرته..
ــ ستهم.. تسلم إيدك.. قلتي لي دايرة شنو من التحتانية؟
ــ ليفة عشميق (12). من نخلاتك الفي الجرف.
ــ سمح.
ونلتقي في حكاية جديدة من بيئتي
الهوامش:
(1) الملوخية إحدى النباتات الورقية التي تندرج تحت فصيلة الكوركوروس، وهي طبق شعبي عربي يعود تاريخه لآلاف السنين. وهو أحد أشهر الأكلات في الموائد العربية.
(2) عقلة تعني حزمة.
(3) النبرو هو الشادوف أو المِنْزَفة هو آلة لرفع المياه للري، تعتمد على الجهد البدني.
(4) التنمية العرجاء هي التي تتجاهل تنمية البشر، وتهتم بالعائد المادي دون الاجتماعي والبيئي.
(5) من نص (أبيت الكلام المغتغت وفاضي.. وخمج) للشاعر محمد طه القدال.
(6) مزرعة جامعة الخرطوم نشأت عام 1951 على مساحة 600 فدان بهدف تدريب الطلاب، ورفع كفاءتهم عملياً، وتوفير المنتجات الزراعية.
(7) من أكثر المقتنيات التقليدية لدي السودانيين، وخاصة في الأرياف. وقد مثل لهم منصة لا غنى عنها للإخبار والمعرفة والثقافة والترفيه. وما يزال.
(8) الحاكم بأمر الله الفاطمي (985 – 1021) هو سادس حكام الدولة الفاطمية، أمسك بزمام الأمور (996).
(9) القاطوع: مخزن صغير تقتطع مساحته من الديناب أو أي الغرف أو المطبخ، لتخزين المؤن والغلال.
(10) من المعادن التي توجد في الفجل البوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم والفسفور والحديد والزنك.
(11) وردت التسمية في كتاب كنز الفوائد لتنويع الموائد الذي يعود للقرن الثالث عشر.
(12) العشميق، أو (آشميق) وهو خيوط لحاء النخيل (الألياف) و تصنع منه الحبال.