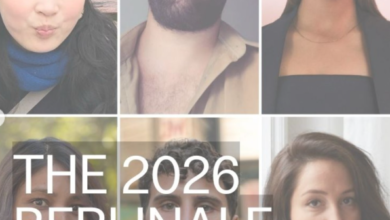لستُ من ينزوي في الملماتِ.. وللشعب دَينٌ عليّ
نانسي عجاج.. حين يصبح الفنان موقفًا والغناء مقاومة

أفق جديد
ليست مجرد صوت شجيّ أو موهبة غنائية لامعة، بل هي حالة فنية وإنسانية متكاملة، وموقف أخلاقي لا يتزحزح. نانسي عجاج هي الصوت الذي خرج من رحم الناس، من وجعهم ومآسيهم، لتغنّي للمهمّشين والغلابة والتعابة. بصوتها الذي يقطر صدقًا، اكتسحت الساحة الفنية في زمن وجيز، وتربّعت على قمتها وحدها، لا لأنها نافست أحدًا، بل لأنها اختارت ألا تشبه أحدًا.
اختطّت لنفسها طريقًا خاصًا، وانتهجت مدرسة فنية متفرّدة، تمسّكت فيها بالقيم النبيلة والرسائل الرفيعة، مما جعلها عرضة لحملات التشويه والشيطنة، في محاولة يائسة لإسكات الحنجرة التي تحرّك الساكن في الضمير. لكنّها ظلت واقفة كالنخلة، تُرمى بالحجارة فترُدّها أغنية، وتُقابل القبح بالمزيد من الجمال.
وفي زمن الحرب، حيث خيّم الصمت على كثير من الفنانين خوفًا من التخوين، وجاهر آخرون بولائهم لأطراف الصراع العسكرية، متناسين كل ما كانوا يردّدونه من قيم في أغانيهم، كانت نانسي من القلائل الذين جاهروا بموقفهم الأخلاقي بوضوح: ضد الحرب، ضد الدم، ضد الخراب. لم تجامل، ولم تهادن، ولم تختبئ خلف الحياد البارد. كانت الصوت الذي يقول “لا”، حين جعلوا من لا جريمة.
في هذا الحوار، لا تحكي نانسي عجاج عن تجربتها الفنية فحسب، بل تفتح جرحًا جماعيًا بكلمات صادقة، وتُقدّم شهادة عن ما يعنيه أن تكون فنانًا في زمن الانهيار. هو حوار مع الفن والموقف، مع الوطن المجروح، مع الأسئلة التي لا تهدأ:
هل يمكن للغناء أن يداوي وطنًا ينزف؟ وهل يستطيع الفن أن يُنقذ ما تبقّى من الذاكرة الجماعية؟
هنا لا تجد فقط حديثًا عن الفن، بل شهادة حية من قلب الخراب، ومرافعة وجدانية عن معنى أن تكون فنانًا في وطن منكوب، وعن مسؤولية الكلمة عندما يصير الصمت خيانة.
كيف تعيش نانسي واقع الحرب في السودان من موقعها كفنانة؟ وكيف أثرت هذه الحرب على علاقتك بالفن والجمهور؟
بطبيعة الحال، الحرب تُحدث تأثيرًا عميقًا ومتشعبًا، ليس فقط على الفنان بل على كل ما يحيط به. هي تُربك الإيقاع العام، تُعطّل الحواس، وتُعيد ترتيب الأولويات قسرًا. فالحرب تغيّر حتى طريقة الاستماع، تجعل الجمهور أكثر انكفاءً، وأقلّ تفاعلًا، وأحيانًا أكثر احتياجًا أيضًا. والفنان في هذه الدوامة يجد نفسه مُقيّدًا بالمكان، بالحالة النفسية، بواقع النزوح القاسي، وبغياب المعايشة اليومية التي تمثّل النبض الأصيل لأي عملية فنية .
شخصيًا، لطالما غنّيت من أجل قيم واضحة ومضامين راسخة: ضد الظلم، من أجل الحرية، والانحياز للمهمّشين والموجوعين. لكن الحرب، بوقْعها المباغت، أرغمتني على خوض تجربة لم أخترها، تجربة النزوح والانقطاع عن الجذور، ما جعل الإبداع نفسه يدخل في مرحلة من الاضطراب والتريّث. الإلهام يحتاج إلى احتضان، والاحتضان مستحيل وسط هذا الدمار.
لكن بالطبع تأخر الإنتاج لا يعني الغياب، بل قد يكون لحظة نضوج. العمل الجيد لا يُنتج بالضرورة في ذروة الحدث. أحيانًا، تحتاج اللحظة إلى أن تهدأ لتُفهم، لتُعاد قراءتها، ثم يُترجم أثرها فنيًا. فترات الخمول والهدوء جزء أصيل من عملية الخلق. قلة الإنتاج لا تعني أبدًا أن الفنان لم يعد يمتلك شيئًا ليقدّمه، بل العكس: ربما ما سيأتي سيكون أكثر نضجًا وتأثيرًا.
هل ترين أن للفنان دورًا خاصًا أو مسؤولية أخلاقية خلال أوقات النزاع المسلح؟
نعم، وبشكل لا يقبل التأويل. للفنان دور خاص ومسؤولية أخلاقية تتعاظم في زمن الأزمات. لكن هذا مرتبط أولًا بمدى وعي الفنان لذاته، لأدواته، ولفكرة التأثير، سواء الآني أو المتراكم. الفنان الذي يمتلك وعيًا حقيقيًا، لا يمكنه أن يتجاهل حجم التأثير الذي يُحدثه صوته، وأن الفن حين يُوظف إنسانيًا، فإنه يصبح قوة تغيير، لا مجرد وسيلة ترفيه.
أنا أرى أن على الفنان أن يردّ الجميل للجمهور الذي صعد به إلى المنصات. أن يقف إلى جانب الناس حين تُثقل كاهلهم الحرب، أن يُعبّر عنهم عندما يُحاصرون بالصمت والعجز. صوت الفنان يصل أبعد، والأبسط أن تستخدم هذا الصوت في قول ما يجب أن يُقال. المسألة ليست مجرّد شهرة أو متعة، بل التزام وجداني. “ما ترجع الماعون فاضي” — هذه ليست فقط عبارة بل فلسفة كاملة. عليك أن تملأ هذا الماعون بالقيمة، بالموقف، بالحقيقة.
خلال سنوات الحرب شهدنا تراجعًا في الأغاني التي تدعو للسلام مقابل تصاعد أغانٍ تعبّر عن الانتماء لطرف أو تمجّد الخطاب العسكري. ما تفسيرك لهذا التحول؟
هو ليس تحولًا بريئًا أو طبيعيًا، بل نتيجة لعمل ممنهج ومدروس. من يملك القوة العسكرية ويستعد للحرب بعتاده، يستعد أيضًا بخطابه، بصوته، بفنّه الذي يخدم الغرض. هنالك أصوات صُنعت لهذه اللحظة تحديدًا، أُعدّت لتغنّي للحرب، لا للسلام
في المقابل، يواجه الفنان الذي يغني للسلام حربًا من نوع آخر: التخويف، التخوين، الإساءة، التشهير، بل وحتى الإقصاء. هنالك فنانون لا ينتمون لأي طرف، يريدون الغناء للسلام، لكنهم يخشون هذا الهجوم العنيف، التخويف والتخوين سلاح استخدم ضد أي فنان وقف ضد شلالات الدماء هذه، يُعاقبون لمجرد أنهم لم يغنوا للقتل ويمجدون الدمار.
صوت الفن السوداني كان في مراحل تاريخية حاسماً في تشكيل الضمير الجمعي والدعوة للتعايش. لماذا يبدو هذا الصوت اليوم خافتاً أو غائباً؟
لأنهم عرفوا منذ البداية خطورة الفن، وقدرته الخارقة على التأثير، فشنوا عليه حربًا مبكّرة. الحرب ضد الفن بدأت قبل الطلقة الأولى، قبل أن يُهدد الوطن بالسلاح. تمثّلت هذه الحرب في تدمير بيئة الإنتاج، في إفقار الفنانين، في اختراق الوسط الفني وتشويهه، وفي خلق تيارات موازية للفن الجاد تحمل مضامين سطحية أو عنفية، أنا لا أرفض الاختلاف في الذائقة، بل على العكس أمتلك سعة تذوّق للأشكال المتعددة، لكن لديّ حد أدنى: أن يملك هذا الفن القدرة على الارتقاء بالوجدان. الناس في زمن الحرب ليست “فاضية” لسماع تفاهة، بل تحتاج لما يعينها، يضيء بداخلها شمعة، لا يزيد من ظلمة الواقع. أي منتج فني لا يمنحني حدًا أدنى من الجمال، لا أعتبره فنًا ولا أستطيع التفاعل معه.
هل تعتقدين أن الرقابة الذاتية أو الخوف من الاستقطاب السياسي منع كثيرًا من الفنانين من التعبير عن مواقفهم؟
نعم، هنالك الكثير من الفنانين أصبحوا رهائن للخوف. الرقابة الذاتية هنا ليست ضعفًا، بل نتيجة طبيعية لوضع خانق. بعضهم يخاف من التعبير، وبعضهم يمرّ بفترة صمت داخلية، في طور الاستيعاب والهضم العاطفي لما يحدث. لكن مما لا شك فيه أن الخوف موجود، وهو مفهوم أيضًا، في ظل الجو العام المليء بالقمع والتشهير. كثيرون يقولون في دواخلهم: “الزمن ما زمن كلام”، فيلجؤون للصمت طلبًا للسلامة.
ما رأيك في فكرة الحياد الفني؟ هل يمكن للفنان أن يلتزم الصمت في قضايا وجودية مثل الحرب دون أن يُعتبر ذلك موقفًا؟
الصمت في ذاته موقف. لا يوجد حياد حقيقي في لحظة مصيرية كالتي نعيشها. لكن لا بد أن نتفهم أن للصمت أحيانًا أسبابه، وهي تختلف من فنان لآخر. هناك من يصمت لأنه يمرّ بمرحلة استيعاب، وهناك من يصمت لأنه مجروح، وهناك من يصمت لأنه يشعر أن لا أحد ينصت، لكن في المجمل، الصمت في لحظات استثنائية ليس رفاهية. لا بد أن تُعبّر، بطريقتك، في توقيتك، حتى ولو بالصمت المدروس، لكنه لا بد أن يكون واعيًا.
الفن وخطاب الكراهية: ظهرت خلال الحرب أغانٍ تمجّد الحرب وتزدري الخصم. هل يمكن تصنيفها ضمن خطاب الكراهية؟
بالتأكيد. هذه الأغاني هي التعبير الفني عن خطاب الكراهية، وتُستخدم كأداة تعبئة وتحريض. تأثيرها مباشر، وخطرها كبير. لأنها تلبس ثوب الفن بينما هي في الحقيقة تعبير عن النزعة التدميرية داخل الصراع.
هل تعتقدين أن بعض الفنانين يساهمون من دون وعي في تأجيج الصراع؟ وما الذي يميّز الفن المقاوم من الفن المحرّض؟
نعم، هناك مساهمات تتم دون وعي، أو بوعي جزئي. الفنان قد ينحاز لمعسكر ما بقناعة شخصية، ويظن أنه بذلك يمارس دوره الطبيعي. لكنه حين يفعل ذلك دون إدراك لنتائج موقفه، يصبح أداة تأجيج. الفن المقاوم يحمل هم الإنسان، يسعى للسلام، يحاول بناء جسر لا حفرة. أما الفن المحرّض، حتى لو بدا ناجحًا لحظةً، فإنه لا ينتصر أخلاقيًا، السؤال ليس فقط عن التأثير، بل عن نوع القيمة التي تقدمها. هل منحت الناس أملًا، أو ساهمت في تعميق جراحهم؟ هل قدمت لهم الفن كعزاء، أم كسوط إضافي يلهب ظهورهم؟ لا توجد حرب لا نهاية لها، لكن هناك فن قد يُساهم في إنهاء الحروب، وفن قد يجعلها أكثر ضراوة وفتكًا وتدميرًا.
ما مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تضخيم الأغاني التي تحمل عنفًا أو شحنًا عاطفيًا ضد الآخر؟
وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد فقط منصات لعرض الرأي أو التعبير، بل تحوّلت إلى أدوات رئيسية في معركة الاستقطاب والتعبئة. إنها ليست “مجرد وسيلة”، بل هي الآلة الأكثر فاعلية في تضخيم وترويج الخطابات، خاصة تلك التي تحرّك العاطفة السريعة، مثل الأغاني التي تمجّد السلاح، وتُشيطن الطرف الآخر، وتُعبّئ النفوس بالكراهية.
هي منصات فعّالة في تشكيل الرأي العام، ليس فقط لأنها تنشر، بل لأنها تُكرّر وتعيد وتُضخّم وتسحب الجمهور نحو مراكز الجذب العاطفي. وفي حالة الحرب، يصبح الخطاب الغنائي المشحون بالعنف قابلاً للتداول أكثر من الخطاب العقلاني، لأنه يخاطب الألم بلغة الغضب، لا بلغة التروي، وهذا خطر بالغ.
نانسي عُرفت بأنها صاحبة صوت حر وملتزم. هل فكّرتِ في إطلاق مبادرة أو مشروع فني يُعبّر عن معاناة السودانيين ويدعو إلى وقف الحرب؟
نعم، في بدايات الحرب، كانت هنالك مبادرة متواضعة، فكرتها إقامة حفلات يخصص ريعها لصالح النازحين، وكذلك سعيت مع آخرين لجمع التبرعات لصالح دور الإيواء لكنها اصطدمت بالعديد من العراقيل، فنيًا كانت هناك العديد من المبادرات أثمرت عن إنتاج عمل بعنوان عيون الشوف، من كلمات الشاعر الجميل قاسم أبو زيد. هذا العمل كان محاولة أولى لقول شيء وسط هذا الدمار العارم. وما زالت هناك أفكار ومشاريع أخرى تتشكّل، منها ما هو موسيقي، ومنها ما هو مجتمعي وإنساني.
الفكرة بالنسبة لي لم تكن فقط عن “الغناء للسلام” كشعار، بل الغناء للإنسان، للمجروحين، للمُهجّرين، للمكلومين، للذين فقدوا أحباءهم ومنازلهم وأحلامهم. التعبير عن معاناة الناس ومواساتهم ومدّ يد العون المعنوي، هو مسؤولية الفنان، حتى وإن تأخر التنفيذ أو تقطّعت السبل.
ما هي الرسائل التي تحرصين على توصيلها في هذه المرحلة؟ وما الذي يعيق إيصالها وسط هذا الخراب؟
رسالتي موجهة لكل السودانيين، داخل البلاد أو خارجها. للذين يعانون من القبح اليومي في الداخل، أو الذين هُجّروا ويكابدون في المنافي. معاناة الداخل واضحة، لكنها ليست أكثر قسوة من الغربة التي يعيشها اللاجئ أو المهاجر الذي حُمّل أعباء ومسؤوليات فوق طاقته. الحرب لم تستثنِ أحدًا، كلنا مدينون لها بجراح من نوع ما.
وفي خضم هذا الحزن، أحاول دائمًا أن أُذكّر بالنصف المليء من الكوب — إن وُجد. هذه الكارثة كشفت أقنعة كثيرة، وفضحت فسادًا وظلمًا طالما صمتنا عنه. نأمل أن تضع هذه التجربة البشعة أساسًا جديدًا لبناء وطن أكثر عدالة وإنصافًا. التغيير يبدأ من المعرفة، من التعرية، من فضح القبح، ثم مقاومته، ثم تجاوزه.
كيف تتخيّلين دور الفن في إعادة بناء السودان بعد الحرب؟ وهل ترين أن للفن القدرة على رأب الشرخ المجتمعي العميق الذي خلّفته الحرب؟
نعم، أرى أن للفن دورًا هائلًا في الترميم النفسي والاجتماعي. الفن هو الذاكرة المشتركة، هو الحنين، وهو اللغة التي تتجاوز الانقسامات. متى ما اختار الإنسان أن يستمع لفنان ما، فهو قد فتح له قلبه دون أن يدري. وهنا تبدأ رحلة الشفاء
الفنانون، عبر أعمالهم، يمكنهم أن يستعيدوا الحسّ المشترك بين الناس، أن يُذكّروهم بمن كانوا عليه قبل الخراب، أن يفتحوا نوافذ للضوء وسط الحطام. نحن نحتاج إلى فن يُجمّع، لا يُفرّق. فن يُربت على الجرح لا أن يُثيره، فن يعيد إلينا الإيمان بأن الحياة ممكنة بعد كل هذا القبح.
واجهتِ خلال مسيرتك الفنية مضايقات وحملات تشهير بسبب مواقفك. من تعتقدين أنه يقف خلفها؟
يقف خلفها من لا يريدون سماع الصوت الحر. هؤلاء لا يطيقون صوتًا يُذكّرهم بأن هنالك بدائل إنسانية، بأن الفن ليس أداة تجييش، بل مساحة للتفكير والجمال والضمير. هذه حملات ممنهجة، تُدار بأدوات إعلامية وكتائب إلكترونية هدفها الأساسي هو صناعة رأي عام مُوجّه، يُرحّب بما هو مطلوب ويُقصي كل ما هو غير مرغوب فيه من قبلهم. هؤلاء يرون في الفنان المختلف تهديدًا، لأنهم يريدون أن يحتكروا حتى الوجدان، يريدون فنًا يُشبه خطاباتهم، لا يُشبه الناس.

هل تعتقدين أن مواقفك كانت السبب الرئيسي في استهدافك؟
بكل تأكيد. أنا لا أنتمي لأي حزب سياسي، لكنني أنتمي لفكرة: أن أكون ضد القهر والظلم والتفرقة والقتل. إذا كان هذا الموقف يُعتبر سياسيًا، فليكن. لكن من استهدفني لا يضايقه موقفي السياسي من حزب ما، بل يضايقه أنني أمتلك صوتًا مؤثّرًا، وأنني أقدّم فنًا يحمل قيمة، ويصل إلى الناس، ويُذكّرهم بأن هنالك حياة أوسع من ضيق المعسكرات. ما يُزعجهم هو أنني أقدّم ذاكرة فنية وجمالية تربك خطابهم التعبوي، وتشوّش على روايتهم المختزِلة للصراع. لهذا، أصبحت هدفًا.
كيف أثّرت هذه الحملات على مسيرتك الفنية ونشاطك داخل السودان وخارجه؟
الحرب والحملات أثّرت عليّ كما أثّرت على الجميع. أوقفت مشاريع، عطّلت خططًا، وأربكت الإيقاع الذي كنت أعمل به من قبل. لكنني أؤمن أن كل أزمة تحمل في طيّاتها فرصًا جديدة. ربّ ضارة نافعة. هذه المحنة دفعتني لإعادة النظر في طرائق العمل، وفي الأدوات، وفي معنى أن أكون فنانة في لحظة فاصلة من تاريخ البلاد.
بدأت أوسّع دائرة تفكيري، وأفكر خارج الصندوق. أبحث عن أدوات جديدة، وربما أكثر عمقًا وفاعلية.
هل فكّرتِ في التوقّف أو الابتعاد بسبب هذه الحملات؟
أبدًا. على العكس تمامًا، هذا الظرف هو اللحظة التي يجب أن أكون فيها حاضرة وبقوة. لا يعقل أن أكون موجودة في زمن الأمان، وأغيب عندما تحتاجني الناس. إن كنت أمتلك القدرة، والوسيلة، والصوت، فمن الظلم أن أنسحب بينما آخرون لا يملكون ما يملكه الفنان من أدوات وباتوا ابواقا للحرب والموت والخراب.
الغياب في هذا التوقيت هو تخلٍّ، وأنا أؤمن أن الالتزام الحقيقي لا يظهر في اللحظات المريحة، بل حين يكون الوجود مكلفًا وصعبًا.
هل تلقّيتِ بعد الحرب أي تهديد مباشر؟ وإن حدث، هل أخذته على محمل الجد؟
حتى الآن، لم أتلقّ تهديدًا مباشرًا، سواء قبل الحرب أو بعدها. لكن هنالك سلوكيات غير مباشرة، مضايقات، محاولات للطاقة السلبية، تُرهقك وتستهلك طاقتك ومزاجك. أحيانًا تجد نفسك تشرح وتُبرر لأصدقائك أو لمتابعيك لتوضيح أن الحملات ليست سوى ضجيج لا يستحق التوقف عنده. بعض المواقف تستوجب ردًّا أو توضيحًا، خاصة من أجل العيون التي تثق بك، وتنتظر أن ترى فيك صورة تستحق الحب والدعم مما يستهلك وقتك وطاقتك . لكن غالبًا ما أتعامل مع كل هذه التفاصيل بقدر كبير من الهدوء والتجاهل. كما يُقال: “ينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن”.