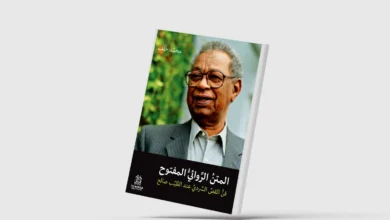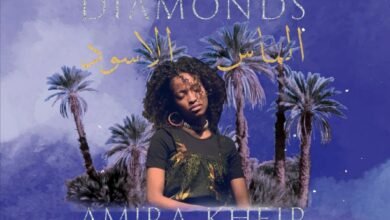حكاية من بيئتي
ود أب سواقي
محمد أحمد الفيلابي
ولأنه كان حتى وقت قريب يُنسب إلى جدته (أم شقيانة)، التي قامت بتربيته بعد وفاة أمه ابنة الخمسة عشر ربيعاً عند ولادته، وبعد اختفاء أبيه، الذي يقال إنه تزوج في تلك المدينة التي هاجر إليها، وانقطعت أخباره. ما كان لأحدٍ أن ينطق لقب (أم شقيانة) إلا همساً من خلفها، اتقاء لسانها الطويل، ويدها الأطول. وقد بات يُسمع بعد وفاتها مقروناً بالحفيد الوحيد الذي تمرغ بين مختلف المهن والألقاب، لكنه لم يكن ليستجيب لنداء، ولا يلتزم بخدمة من يناديه بلقب (ود أم شقيانة)، إذ كان يعمل على نشر اللقب الذي بعثه مجدداً (ود أب سواقي).
لم يسأل أحد إن كان (الحاج)، وهذا اسمه الذي لن تثبته الأوراق الرسمية، فهو لا يملك أي منها، إن كان يخجل من نسبه إلى جدته كونها امرأة، أو من لقبها الذي يشير الى بؤسها وبأسها في آن واحد. وهو يقسم أنه لم يلبس الشقيانة في حياته، إذ كان الحفيد المدلّل بين والد أبيه، ووالدة أمه. فـ(الشقيانة) ذلك الحذاء الجلدي الذي يصنع من جلد البقر غير المدبوغ، لا يستطيع تحمله إلا ذوي الأقدام القوية الجلد، وهو عبارة عن طبقة أو طبقتين من الجلد المتين تشكّل الموطأ (الباطس)، وتشبك فوقها رقائق القد (1) التي تربط القدم وتسمى (الفوندي)، (2) وفي حال جفاف الرقائق وحدة حوافها تُلَف بقصاصات قماش لتخفيف شقائها على سطح القدم. ولعل الاسم جاء من هنا (الشقيانة)، لأنها تقي الرمضاء والأشواك، أو لأنها تقاسم صاحبها شقاء الأيام الطوال، في زمن كان يعز فيه الذهاب إلى الأسواق بقصد شراء حذاء. رغم أن تلك الأسواق الأسبوعية كانت بمثابة معرض منتجات وسلع متحرك، يجوب القرى بشتى أنواع البضائع، وتجد فيه الحكايات والأخبار والخبرات، ومجالس الأعيان لحل المشكلات والنزاعات الصغيرة قبل أن تصل إلى المحاكم، وسوق البهائم، بل هناك ركن خاص بـ(جز البهائم)، حين يقوم أحد المتخصصين في جز وتزيين الحمير والخيل، وعمل تشكيلات جمالية عليها. وقد اختفي هذا النوع من الأسواق في نواحي عديدة، واستعيض عنها بالأسواق المستديمة، كما هو الحال في المدن والقرى الكبيرة. بيد أن الأسواق الجوالة لا تزال قائمة في بعض مناطق السودان، ويسمونه (أم دورور)، (3) في إشارة إلى الدوران المستمر بين القرى والنجوع.
يحكي (ود أب سواقي) أنه كان يرافق جده حين يزور سوق الأربعاء بالقرية، يطوف معه بين أصحاب المهن كالحداد الذي يعمل على صناعة وشحذ أدوات الزراعة من (مناجل ونجّامات وطواري والفؤوس بأحجامها المختلفة). وبائعات الفخار بأحجامه المختلفة، والأدوات المنزلية، وباعة الملابس والأقمشة والأحذية الجلدية والبلاستيكية. وقد ذكر أنه شاهد في طرف السوق من يبيع الشقيانة، وبعض المصنوعات الجلدية الأخرى من قبيل أواني الماء واللبن والسوائل الأخرى (السعن.. القربة.. السقو) (4)، بجانب الفروة المصنوعة من جلد الأغنام، أو العجول لاستخداماتها المختلفة من الصلاة إلى افتراش الدواب على السروج والحوايا (5). ويحكي باستمتاع عن إجلاسه إلى المزين (الحلاق)، وكم قد اشترى له جده التمر وغيره من الثمار والمنتجات الغابية، والحلوى أحياناً. وأنه في مرة التف الناس حول جده ليروا ما في بطن ساعته الجوفيال (6) من تروس تشبه تروس الساقية في حركتها، وملامستها لبعض، وقد راح يلمسها بإبرة في يده ويسميها “دي الأٓرقٓدي دُول والأٓرقٓدي كِنا” وهو يعني الحلقات الكبيرة والصغيرة، “وده الكٓج وده التوري والسابي…” (7) ويواصل في تفصيل أجزاء الساقية، والناس منبهرون، تتصادم رؤوسهم ليروا ما في يده.
جده دون سائر الناس يناديه (الحاج). الاسم الذي لم تكن جدته ترغب في سماعه لأنه يذكرها بالأب الذي هرب قبل أن يتعلم ابنه المشي. ويجد الجد العذر لابنه بأن لم تكن له القدرة على تحمل تلك المرأة صعبة المراس، التي كانت تتحاشاه قدر المستطاع، فيما كانت تسخر من ابنه (والد حفيدهما المشترك)، وقد فضّلت أن تنسبه إلى جده، وهي تبرر أن اسم (الحاج) يطلق على كبار السن، أو أولئك القادمين من غرب أفريقيا في رحلة عبورهم إلى الأراضي المقدسة. بيد أن الجد لم يكن يعيرها اهتماماً، ويعدها امرأة (مسترجلة) (8)، وهو في شغل شاغل عنها. إذ كان يقضى يومه بين (سادر ومتدلي) (9)، كما يقول بين ثلاث (سواقي)، والراديو، أي بين بيته في طرف القرية، والمزارع على النيل، وتلك الرواكيب وسط شجر السيال والسلم شمال القرية، حيث يغشى صباحاً ساقيته الأولى (بت تامزين) ليعبُّ دون أن ينزل من حماره عبّاراً (10) واحداً من المريسة، يسميه (مسمار القلب)، ثم يتدلّى إلى ساقيته الثانية، حيث زراعته وبستانه الصغير في (ساقية) الأسرة، ويسمونها (ساقية ولاد حامد) (11)، وقد ضُبط مرة وهو يترنم بصوته الأجش بأغنية أخذت بلبابه زمناً طويلاً:
في ربيع الحب كنا نتساقى ونغني
ونناجي الطير من غصن لغصن
ثم ضاع الأمس مني
وانطوت في القلب حسرة (12).
اقترب من الثمانين من عمره، بيد أنه كان قوي البنية، حاضر البال، لطيف المؤانسة. يحدّث عن ساقيته الأولى التي يفتتح ويختتم بها يومه، لكأنها من (حوريات الجنة) دون أن يذكر لها جمالاً أو نوعاً من العشق لشخصها، لكنها صناعتها المتقنة، التي تخصه منها بأفضل منتج. وعن ساقيته الثانية، هذه الورثة التي يراها قطعة من الجنة، وقد برع في زراعة شتول النخيل والجوافة والليمون في وسطها، تلك التي جلبها له صديق عمره من بساتين المدينة القريبة، وظل يرعاها بمشورة عامل البساتين حين يزور القرية، فيقف على البستان الصغير، ويقضي بين الساقيتين (الأولى والثانية) أياماً بعيداً عن أسرته، وضجة المدينة.
أما الساقية الثالثة عشقه الحقيقي وطعم الحياة كما يقول، فقد أبقى عليها رغم أن تكتكات طلمبات الري حوله، وعبر النهر تقول إن هناك تغيير يجري، وعليه ألا يقاوم أكثر من ذلك. بيد أنه كان يرفض استبدالها، وهو الذي خبر كل قطعة في هيكلها، وتعلم كيف يقوم بإصلاح أعطابها. وكيف يعالج مشكلات زيادة الماء أو قلتها وفقاً لحركة النهر. يُسمع غناؤه من بعيد حين يكون غارقاً في تنظيف القَوَتِّي أو الكودي (البيارة)، والبعض يسميه الضنب، يشق له المجري من النهر فيمتلئ بالماء، تدخله القواديس متدلية من حبل (الألس) عبر الحلقة الكبيرة، تغرف الماء ثم تصبه في (القُشَّق) جهاز التحكم في حبس وتوجيه الماء، فيسري في شرايين الأرض، تلك الجداول التي يعتني بها بمثل ما يعتني بكل أجزاء الساقية، ويحفظ أسماءها النوبية المعقدة، وتلك الأسماء المحرّفة أو المعربة. ويقول في فخر أنها صناعة محلية لأن كل أجزائها تتكون من خشب السنط الذي يمتاز بالمتانة والوفرة بالمنطقة. وللربط بين أجزائها يستخدم (القد) والحبال المفتولة من نبات الحلفا، أو سبيط وعشميق النخل، أو سعف الدوم. وتبنى (القواديس) من الطمي الممزوج بروث البهائم، وتحرق بحرفة ومهنية عالية، يعبّر عنها بقوله “لكل فولة كيّال”، يعني أن لكل مورد طبيعي من يستطيع أن يستخلص منه ما يفيد، وأن لكل صناعة من يتقنها.
الحفيد الذي كان ينقل عن جده حكاياته التي لا تنتهي، كان يبدو متأثراً حين يروي عن تلك اللحظات المتعلقة بالهجوم على الرواكيب بقصد إزاحتها، وطرد ساقية جده الأولى وأسرتها الصغيرة. ثم انهيار الساقية الخشبية، لعدم القدرة على إصلاحها. وجاءته ثالثة الأثافي عندما غرقت شجرات البستان في الفيضان ولم تجد من يقف عليها، في ذلك العام. وكيف أن الجد انطوى على نفسه، وبات لا يحدث أحداً، فقط يحتضن مذياعه، ويهوم في عوالم خاصة به حتى رحل، ولم يحدثهم بموته سوى الراديو الساقط على الأرض، وقد تبعثرت محتوياته.
حين أدرك (الحاج) أنه لا يمكنه السير على خطى جده، (أبوي) كما يقول، مضى في تعلم ميكانيكا طلمبات (اللستر)، وقد حظي بمرافقة الميكانيكي الأشهر بالمنطقة، ولسنوات خبر خلالها كيفية تركيب، وإصلاح أعطاب هذه الكائنات الحديدية التي هزمت ساقية جده، ومع إجادة مهنته الجديدة وجد فرصة لتخليد ذكرى جده بنشر لقبه (ود أب سواقي)، وحكايات جده في قرى المنطقة. فقد أصبح يغني لهم في مناسباتهم، ويؤانسهم في جلسات السمر يحكي عن جدته التي كانت تهزم الرجال بلسانها وقوتها البدنية، لكنه يحكي أكثر عن جده (أب سواقي). وكان أن تباعدت زياراته للقرية منذ أن جاء لتلقي العزاء، وحين يستجيب لأصحاب الطلمبات، يرسلون في طلبه عبر الأسواق والقرى. يقضى مهمته على عجل ليعود إلى حيث كان، لكنه لا ينسى أن يزور قبر جده وجدته، يخص كل منها بما يستطيعه من دعاء ودمعات.
وإلى القاء في حكاية جديدة من بيئتي
الهوامش:
1ــ شرائح من جلد البقر تستخدم للربط حين تكون لينة طرية، فتشتد وتمتن حين تجف.
2ـ الباطس والفوندي من أجزاء الحذاء بحسب صُنّاع الأحذية.
3ــ أسواق (أم دورور) تجدها أكثر في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، ومناطق أخرى.
4ــ يصنع السعن من جلد الأغنام الصغيرة، والقربة من الأغنام الكبيرة، أما السقو فيصنع من جلد الأبقار. وهي أواني لحما وتخزين الماء واللبن والسمن، ومختلف السوائل.
- الحوايا شداد الإبل، وهي أنواع متعددة الأشكال والأسماء.
6ـ الجوفيال ماركة ساعات.
7ــ أجزاء الساقية تجد أسماءها الأصلية نوبية مع بعص التحريفات هنا وهناك.
8ــ المسترجلة امرأة تهجر أنوثنتها وتقوم بالكثير مما يقوم به الرجال، ووثق لها الأديب الطيب صالح في روايته العالمية موسم الهجرة إلى الشمال (بت مجذوب).
9ــ (سدر) في البلاد أي ذهب ولم يثنه شيء. لكنها تستخدم في مناطق نهر النيل بمعني عاد إلى المنزل من المزرعة. وعكسها (متدلي) أي نازل إلى النهر حيث المزرعة.
10ــ العبّار لفظ محلي يعني قدر محدّد.
11ــ الساقية في تعبير آخر هي مساحة الأرض التي ترويها الساقية، وتخص أسرة بعينها.
12ــ ربيع الحب الأغنية الشهيرة كتبها التجاني وسف بشير ولحنها وغناها سيد خليفة.