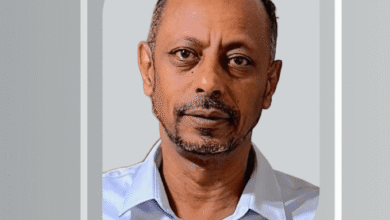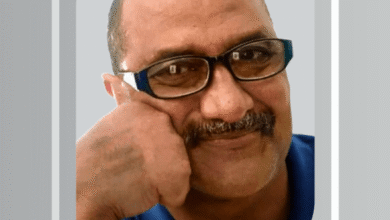من ساحة لافاييت إلى ميدان الشهداء
سلام السودان بين النظرية والتطبيق
د. عصام عباس
تأتي الدعوة لاجتماع واشنطن للرباعية الدولية المعنية بالسلام في السودان (الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ومصر) في لحظة مفصلية من تاريخ السودان الحديث، إذ يتسارع الانزلاق نحو هاوية الدولة الفاشلة مع اشتداد وطأة النزاع الدموي بين الجيش والدعم السريع، في ظل انهيار شبه تام لمؤسسات الدولة وانقسامها بين حكومتين في بورتسودان ونيالا. ومع ارتفاع معدل اليأس والإحباط وسط السودانيين جراء تعنت طرفي الحرب ومناصريهم في الوصول إلى حل ينهي الأزمة، تعود المبادرات الدبلوماسية إلى الواجهة مرة أخرى، حاملةً في طياتها أسئلة ملحة عن مدى قدرتها على كسر الحلقة المفرغة من الفشل المتكرر. فرغم ما يكتنف هذه التحركات من أهمية سياسية ودبلوماسية، إلا أن التحدي الجوهري يظل في مواءمة هذه المبادرات مع تعقيدات الواقع السوداني، الذي يتجاوز حقيقة إنه صراع مسلح إلى كونه تعبيرًا واقعيًا عن أزمة هوية وطنية، وانقسام مؤسسي، وصراع مصالح إقليمية.
أولًا: إرهاصات الحرب وفزاعة الاتفاق الإطاري
قبيل الانفجار العسكري، الذي كانت بوادره تلوح في الأفق، وقوى الظلام تربط الليل بالنهار لإشعال الفتنة عشمًا في عودتهم محمولين على ظهور الدبابات، وللنيل من ثورة ديسمبر ومناصريها، كانت الجهود الوطنية منصبة للتوافق على إطار جامع يخاطب التحديات الراهنة، وقد توافق شركاء تلك المرحلة على تسميته بـ “الاتفاق الإطاري” كمشروع حل وطني برعاية القوى المدنية الفاعلة في الساحة السودانية، وكبوابة عبور نحو الانتقال الديمقراطي. تضمن ذلك الاتفاق بنودًا إصلاحية تمس قضايا جوهرية مثل دمج الجيوش المتعددة في جيش مهني موحد، وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، وتفكيك بنية النظام السابق، وتحقيق العدالة الانتقالية. لم يصمد الاتفاق، برغم توافق معظم الشركاء الأساسيين حوله، لأسباب تتعلق بعجزه عن معالجة التناقضات العميقة بين رؤيتين متنافرتين حول الجيش: الأولى تراه مؤسسة قومية تحمي الوطن وإن ما قام به في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 ما هو إلا خطوة تصحيحية، وأن الإصلاح الأمني والعسكري وتوحيد الجيوش يجب أن يتسق ويتوافق مع رؤية الجيش، والثانية تعتبره امتدادًا لسلطة انقلابية لا يؤتمن جانبها ما لم يتم إصلاحها اصلاحًا جذريًا. نجح الإسلاميون في العزف على وتر هذه التناقضات التي لم يحسن القائمون على أمر تلك المشاورات التعامل معها بالحنكة والدراية الكافيتين. فقد انتهج الإسلاميون سياسة ترتكز إلى سرديتين طورتا بإحكام، السردية الأولى تخويف المجتمع من القادم المجهول من خلال الترويج للاتفاق الإطاري بأنه هو أقصر الطرق لتفتيت السودان، وأنه قد تم تطويره لتفكيك الجيش السوداني وتمكين الدعم السريع، وهو بلا أدنى شك ادعاء باطل، بينما السردية الثانية تقوم على إضعاف ثقة المواطن الذي فجر ثورة ديسمبر المجيدة في قواه المدنية من خلال اتهامها بالسعي لإشعال الحرب، وأنها الذراع السياسي للدعم السريع. استغل الإسلاميون المنابر المجتمعية القاعدية والإعلام الشعبوي في ترويج هذه السرديات التي لا ننكر أنها لعبت دورًا مؤثرًا في تقليل فعالية الاتفاق الإطاري، وتسببت في نكوص الجيش لاحقًا عن المضي قدمًا فبه. كما أن تأجيل حسم قضايا مثل قيادة الجيش وجدول الدمج الأمني فتح الباب أمام التصعيد المتنامي، مما جعل الاتفاق شاهدًا على ما كان يمكن أن يكون تحولًا سلميًا، لكنه أضحى مقدمة لانهيار شامل.
ثانيا: الإرث المثقل بالفشل – قراءة في تاريخ المبادرات
لم يكن التعثر الذي صاحب الاتفاق الإطاري بدعًا في تاريخ السودان السياسي والأمني، بل ألقى بظلاله أيضًا على جهود ما بعد الحرب. فمنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، لم تتوقف المساعي الإقليمية والدولية لإيجاد مخرج سياسي، إلا أن هذه المبادرات اصطدمت جميعها بعوائق بنيوية وموضوعية أدت إلى فشلها. تجلى ذلك بوضوح في تجربة منصة جدة التي، رغم أهميتها الرمزية ورعاية السعودية والولايات المتحدة، لم تنجح سوى في تحقيق هدن هشة سرعان ما انهارت، وظلت تركّز على الجوانب الإنسانية دون الغوص في حل الأزمة السياسية. وفي موازاة ذلك، تعثرت جهود منظمة الإيغاد التي سعت لجمع طرفي الصراع، لكنها واجهت تحديات كبيرة في تحقيق التوافق بين أعضائها، وقوبلت بفتور من الأطراف المتحاربة، مما أضعف مصداقيتها وفعاليتها. كما أن المبادرات الأخرى، مثل مساعي الاتحاد الأفريقي ومؤتمر دول الجوار الذي استضافته مصر، بقيت حبيسة الإعلانات السياسية دون أن تُترجم إلى ضغط حقيقي أو آليات تنفيذ موثوقة على الأرض. وحتى مؤتمر جنيف، الذي سعى لحشد الدعم الإنساني الدولي للسودان، ورغم أهميته في تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية، إلا أنه لم ينجح في خلق مسار سياسي موازٍ يوقف الحرب، وظلت قراراته مجرد إعلانات نوايا لم تتحقق بشكل كامل على الأرض. عكست هذه المحاولات المتباينة غياب إجماع دولي وإقليمي، وفشلًا في بناء رؤية موحدة، فضلًا عن غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الأطراف المتحاربة للوصول إلى تسوية شاملة، مما جعل هذه الجهود أشبه بمحاولات لتسكين الألم لا معالجته من جذوره.
ثالثًا: وقف إطلاق النار – فعلًا لا قولًا
تتفق الرؤية المطروحة في هذا المقال مع ما تنادي به القوى المدنية في السودان، حيث تشدد على أن أي نجاح محتمل لاجتماع دول الرباعية يجب أن ينطلق من وقف إطلاق نار شامل وفعّال. لكن هذا الوقف لا يمكن أن يكون مجرد إعلان شكلي أو اتفاق غير ملزم، بل لا بد أن يُترجم إلى آليات تنفيذ ومراقبة صارمة تضمن الالتزام الكامل من جميع الأطراف. تكمن أهمية هذا المسار في ضرورة توحيد الموقف الدولي، إذ من دون اتفاق واضح وموحد بين دول الرباعية على رؤية قابلة للتطبيق، فإن جهود وقف إطلاق النار ستظل عرضة للفشل، كما حدث في جولات سابقة بسبب غياب الإرادة السياسية. توحيد الموقف يعني الضغط الجاد على الأطراف المتحاربة للالتزام بإجراءات واضحة تنهي النزاع ولا تترك مجالًا للمراوغة. في السياق ذاته، يشكل إشراك القوى المدنية في آليات مراقبة وقف إطلاق النار ضرورة حيوية تمنح العملية بعدًا شعبيًا وشرعية مجتمعية. تمثيل المدنيين، وخاصة المتضررين من الحرب، في هذه الآليات يضمن أن تكون أصواتهم حاضرة في مسار السلام، بعد أن ظلت مغيبة طويلًا عن طاولات التفاوض التي احتكرها العسكريون وأطراف الصراع. من جانب آخر، ينبغي أن يُعامل أي خرق لوقف إطلاق النار باعتباره جريمة ضد السلم، وأن يتم تجريم نشاط المليشيات الموالية لكلا الطرفين على نحو واضح وصريح. هذا التوجه من شأنه أن يفتح الباب أمام مساءلة دولية وقانونية جادة، ويشكل رادعًا فعّالًا أمام من يسعى لإطالة أمد الحرب أو تقويض جهود السلام.
رابعًا: المفسدون في الأرض – القوى المعرقلة للسلام
لا يمكن الحديث عن أسباب استمرار الحرب دون الإشارة إلى الدور التخريبي للقوى التي تسعى لإعادة إنتاج نظام الثلاثين عامًا من الاستبداد. فبعض بقايا نظام البشير، خصوصًا من الإسلاميين، وجدوا في الحرب فرصة لإعادة التموضع، سواء بالتخفي عبر دعم الجيش، أو العمل السري لتعطيل أي تسوية لا تضمن نفوذهم المستقبلي. كما أن جميع الحركات المسلحة التي أبرمت اتفاق جوبا للسلام، اختارت الاصطفاف إلى جانب طرفي الحرب، ليس من منطلقات وطنية، بل لحماية امتيازاتها أو توسيع مكاسبها.
خامسًا: بناء السلام وتجذير الحلول – نحو عقد اجتماعي جديد
إن وقف إطلاق النار، رغم ضرورته القصوى لعودة الأمن في مناطق الصراع، لا يمكن أن يشكل مدخلًا حقيقيًا للسلام الدائم ما لم يُربط بمسار سياسي يعالج الجذور البنيوية للصراع. فالسودان لا يعاني فقط من نزاع مسلح، بل من أزمة حكم وتنازع هويات وفشل تنموي مما يتطلب إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس جديدة.
المسار المطلوب يبدأ بإصلاح جذري لنظام الحكم، يقوم على بناء دولة مدنية ديمقراطية تنهض على أنقاض الدولة الأمنية التي عمّقت الانقسامات والولاءات الضيقة. ولا يمكن لهذا التحول أن يتحقق من دون عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة واسعة للقوى المدنية والمجتمعية، وتُعيد تأسيس العلاقة بين المواطن والدولة على قاعدة الحقوق والمساءلة، لا الولاء والانتماء السياسي أو الجغرافي.
كما أن تحقيق العدالة التنموية يقف شرطًا جوهريًا لإنهاء دورات العنف المتكررة، إذ لا بد من إعادة بناء السودان انطلاقًا من الأطراف لا من المركز. ويعني ذلك الاستثمار الجاد في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي طالها التهميش مثل دارفور، النيل الأزرق، جبال النوبة، وشرق السودان. هذه المناطق لم تكن فقط مسارح للصراع، بل أيضًا شاهدة على غياب الدولة في تجلياتها التنموية والعدلية.
ومن خلال معالجة قضايا الحكم والتنمية بشكل عادل وشامل، يمكن التأسيس لهوية سودانية جامعة تتجاوز الانتماءات القبلية والجهوية الضيقة، وتقوم على مفهوم المواطنة المتساوية والمشاركة الفاعلة في الشأن العام. الهوية الوطنية هنا ليست شعارًا سياسيًا، بل نتيجة حتمية لمسار إصلاحي يعيد إنتاج السودان على أسس جديدة، أكثر عدلًا وشمولًا.
ختامًا: واشنطن، بورتسودان، نيالا – الطريق الصعب نحو السلام
لست من القائلين إن اجتماع الرباعية في واشنطن يمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ السودان من الانهيار ولكنه قطعًا الفرصة الأهم والأكثر تفاؤلًا لتحقيق السلام. هذه الفرصة لن تتحقق إذا ما اكتفت الدول المعنية بإصدار بيانات دبلوماسية تقليدية، أو تجاهلت الدور المحوري للقوى المدنية الحية. ما يحتاجه السودان اليوم هو رؤية شجاعة ومتكاملة وقابلة للتطبيق تجمع بين وقف فوري لإطلاق النار، وتفكيك تحالفات الحرب، والانتقال نحو عقد اجتماعي جديد يعالج جذور الصراع. وهذا يتطلب إرادة سودانية جامعة، والتزامًا دوليًا صادقًا لاجتراح طريق جديد نحو السلام.