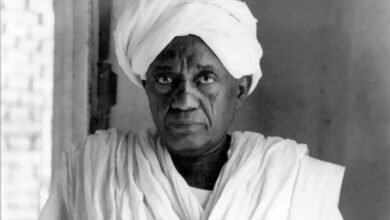العقل السياسي السوداني: بين جرأة التشريح وثغرات المنهج
عبد المطلب المحيسي
في مقاله المعنون “العقل السياسي السوداني: تفكيك الأسطورة وإعادة البناء (2)”، المنشور بالعدد رقم (٣٣) من مجلة أفق جديد يذهب د. صلاح عمر في مغامرة فكرية طال انتظارها؛ مغامرة لا تحاكم الفعل السياسي من منطلقاته الظرفية، بل من داخله البنيوي، من الطريقة التي يفكر بها، ويقارب بها الواقع، ويتعامل بها مع التاريخ والسلطة والمجتمع. فالمقال، في حقيقته، ليس مجرد وصف لعلل السياسة السودانية، بل محاولة لفتح “صندوقها الأسود” والإنصات لما تراكم فيه من سرديات وعُقد ومسلمات، تستعصي على التغيير السطحي.
منذ الجملة الأولى، يُعلن الكاتب موقفه التحليلي الصارم: أن أزمة السياسة في السودان ليست فقط في الخيارات الخاطئة أو الانقلابات المتكررة أو فشل الانتقالات، بل في “العقل المنتج لهذه الممارسات”، في بنية تفكير تتسم بالتردد، والتجزيء، والإنكار، والاختزال، أكثر مما تتسم بالحسم والرؤية والتأسيس. ولعل هذا التوجه وحده كافٍ لمنح المقال قيمة استثنائية، في زمن لا تزال فيه الكتابة السياسية في السودان أسيرة الانقسام بين العاطفة والولاء، أو بين التقريظ والشتيمة.
الدكتور صلاح لا يتورّع عن تسمية الأشياء بأسمائها، حين يسرد سبع سمات يرى أنها تشكّل الملامح العامة لما يسميه بالعقل السياسي السوداني:
غياب الرؤية الاستراتيجية، سيطرة الشخصية على المؤسسة، تمركز النخبة وإقصاء التعدد، وهم امتلاك الشرعية، التبرير بدل النقد الذاتي، اختزال التعقيد السياسي، وأخيرًا، ثقافة التسويات السطحية التي تهرب من جذور الأزمات.
هذا النسق السردي المتدرج يمنح المقال طابعًا بنيويًا، لا يبحث في نتائج الأزمات، بل في منابعها، ولا في المواقف، بل في منطق اتخاذها. فالفعل السياسي السوداني، كما يراه الكاتب، لا يفشل فقط لأنه ضعيف أو مرتبك، بل لأنه يحمل في داخله عطبًا هيكليًا ناتجًا عن تراكم طويل من النزاعات، والإرث الطائفي، والحروب، وميراث ما بعد الاستعمار، وعدم التوافق على مشروع وطني جامع.
ومع ذلك، ورغم القيمة النظرية العالية لهذا الطرح، إلا أن المقال، في لحظات كثيرة، بدا كمن يتحدث عن “عقل سياسي” لا ملامح له، ولا جسد يحمله. لم نعرف بوضوح: من هو هذا العقل؟ هل هو عقل النخب؟ أم الحركات المسلحة؟ أم الدولة العميقة؟ أم الشارع الثائر؟
هذا التعميم المفاهيمي أربك الحدود التي يتنقل فيها النص، وأضعف من قدرته على تقديم توصيف دقيق أو حلول قابلة للبناء. فـ”العقل السياسي” ظل متحولًا بين كونه ذهنية ثقافية، وسلوكًا نخبويًا، وبنية مؤسساتية، من دون أن يُضبط بمفهوم محدد.
كما أن اعتماد الكاتب على التحليل المجرد دون تضمين أمثلة واقعية من الحقل السياسي السوداني، أضفى على المقال طابعًا نظريًا صرفًا، أقرب إلى المقالات الفكرية منها إلى النقد السياسي العملي. فمثلًا، حين يتحدث عن غياب الاستراتيجية، لماذا لا يستدعي تجربة اتفاقية نيفاشا مثلًا، أو الوثيقة الدستورية التي فشلت في هندسة الانتقال؟ وحين ينتقد ثقافة الزعامة، ألا يجدر به أن يورد أسماء حركات سياسية أو طائفية أو حتى رموز مدنية تؤكد هذه الملاحظة؟ إن غياب التمثيل الواقعي جعل النص يدور حول الفكرة، لا يغوص في تفاصيلها.
والأكثر لفتًا للانتباه أن المقال، رغم حديثه المتكرر عن التهميش والمركز والهامش، يفتقر لتحليل طبقي حقيقي لبنية السلطة في السودان. لا يُناقش المقال مثلًا كيف ساهمت البرجوازية الطفيلية في إنتاج هذا العقل، أو كيف ارتبط تحالف السلطة والثروة بتكريس الولاء الجهوي والطائفي. كما لم يُقدّم قراءة في أثر اقتصاد الريع، أو تمركز الدولة حول طبقة بعينها، أو تحالف العسكر مع الرأسمال الحربي.
وهذا يجرّنا إلى ثغرة أخرى لا تقل خطورة: إغفال الدور الخارجي. فالعقل السياسي السوداني لم يتشكّل في فراغ. فاعلو السياسة، من المدني إلى العسكري، كانوا – ولا يزالون – جزءًا من شبكة إقليمية ودولية معقّدة، تضغط وتؤثّر وتموّل. كان حريًا بالمقال أن يُسائل هذا البُعد، وأن يربط “الاختزال السياسي” و”الوهم بالشرعية” أحيانًا، لا فقط بالبنية الداخلية، بل بتدفقات الدعم، وخرائط النفوذ، وتحالفات الحرب والسلام العابرة للحدود.
وفي زوايا النص، يظهر تجاهل تام لمنظور النوع الاجتماعي. رغم أن النساء السودانيات كنّ في طليعة الحراك الثوري، وهن من أكثر الفئات تضررًا من عسكرة السياسة والإقصاء، إلا أن المقال لم يشر لهن لا من قريب أو بعيد. وهذا يُعد نقصًا بيّنًا في أي تحليل يتوخّى الشمول البنيوي.
رغم كل هذه الملاحظات، لا يمكن إنكار أن المقال يُمثّل خطوة شجاعة نحو مساءلة العمق العقلي الذي تنتج عنه السياسة السودانية في كل أطوارها. فبدلًا من الإغراق في السرد السياسي المألوف، يفتح الكاتب بابًا نحو ضرورة بناء عقل سياسي جديد، لا يرتكز على الزعامة، بل على المؤسسية، ولا ينخدع بالتكتيك، بل يحتكم للرؤية، ولا يعيد تدوير الشعارات، بل يبني الوعي، ويتجه نحو مشروع وطني جامع.
ما كتبه الدكتور صلاح لا يُعد وصفة مكتملة، لكنه إعلان صريح بأن الطريق إلى الدولة السودانية يبدأ من تفكيك الذهنية لا فقط إسقاط الأنظمة، ومن نقد الذات لا تبرير العجز، ومن الاعتراف أن التغيير لا يُنجز في الشوارع وحدها، بل في بنية الوعي أيضًا.
نصٌ كهذا، على ما فيه من قصور، يبقى ضروريًا، لأنه لا يُصفّي حسابًا مع أحد، بل يصفّي حسابًا مع فكرٍ سياسيٍ أعجز البلاد عن تجاوز دائرة الانكسار المتكرر.