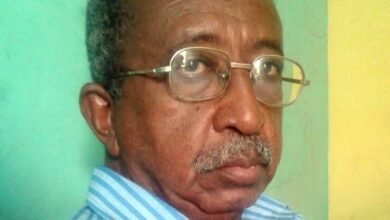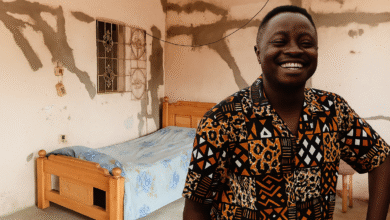ظلال.. عن الناقد أبو طالب محمد:
السر السيد
نشر الناقد أبو طالب محمد كتابه الأول، الذي جمع فيه بعضًا من نصوص الكاتب السوداني الطيب المهدي وكتب مقدمته، الموسوم بـ (وانفرج الستار ومسرحيات أخرى للطيب المهدي محمد الخير)، وقد صدر
الكتاب عن الهيئة العربية للمسرح في العام 2018. ما تجدر الإشارة إليه هنا هو، أولًا النزوع المبكر لأبو طالب في الاهتمام بالإرث المسرحي السوداني قراءة وتوثيقًا بالنظر إلى عمره 41 عامًا، وإلى تاريخ تخرجه، وإلى البحث المسرحي والنشر المسرحي في السودان ووضعيتهما الحرجة، وثانيًا اختياره للكاتب المتميز الطيب المهدي الذي تحتشد نصوصه بأسئلة فلسفية ووجودية واجتماعية معقدة، لتكون مدخله إلى عالم النشر والكاشفة بطريقة ما عن مسار تذوقه ووعيه الاستراتيجي بأهمية النشر، فقد دعم هذا الكتاب وبقوة ذاكرة المسرح السوداني المثقوبة وأفرد أجنحتها للتحليق عاليًا، ويكفي أنه صدر عن الهيئة العربية التي تمثل جسر التعارف الخلاق بين المسرحيين العرب.. هنا يجدر بي أن أشير وتأسيسًا على معرفتي الطويلة بأبو طالب، فهو إضافة إلى تخصصه في النقد المسرحي في كلية الموسيقى والدراما – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، قد نال الدبلوم العالي في الفلكلور من معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية – جامعة الخرطوم، كما له شغف عظيم ولا يزال بعوالم السرد وحقول النقد المتنوعة.
يتوفر هذا الشاب النحيف، باهتمام يصل حد الولع بالحركة الثقافية المتنوعة السودانية والعربية والأفريقية، فقد كتب عن الرواية الأفريقية والرواية العربية. وكتب عن سعدالله ونوس، وكتب عن الكثير من الروايات السودانية، وكتب عن الروايات الفائزة في جائزة الطيب صالح (جائزة شركة زين).. هنا لا أنسى مساهماته الكبيرة في المهرجانات المسرحية السودانية، تنظيرًا وتنظيمًا (مهرجان البقعة/مهرجان المسرح الحر/مهرجان مركز عبدالكريم ميرغني الثقافي للمسرح)، إضافة إلى مشاركاته المتميزة في المهرجانات المسرحية العربية. هذا الحضور الكبير لم يكن مجانيًا وإنما كان حضورًا مستحقًا قاعدته تمتعه بالشغف والحيوية والهمة العالية والركض خلف المعلومات، فقد مثّل أبو طالب بالنسبة لي ولآخرين مصدرًا للمعلومات “الغميسة” في المسرح السوداني، فقد فاجأني مرة وأنا أشرع في أعداد كتاب عن (المسرحيات السودانية المنشورة)، بأن السيد الفيل له مسرحية منشورة بعنوان “الجحود”، وأن جمال عبدالملك ابن خلدون له مسرحية منشورة في مجلة القلم السودانية، كما كان هو من مدني بمسرحية “ملحمة أكتوبر”، ولا غرابة هنا فهو العليم بجغرافيا الوراقين على طول العاصمة المثلثة، وهو السادن العليم بدار الوثائق القومية.
رفد أبو طالب المكتبة السودانية إضافة للعديد من المقالات والدراسات المنشورة في الصحف السودانية والعربية بالكتب التالية:
– أنماط السرد في الرواية الأفريقية – رواية الحوالة نموذجاً لعثمان سامبين – دراسة بنيوية تكوينية:
– سوسيولوجيا الرواية الأفريقية صادر عن دار رفيقي 2021م.
-حفريات نقدية – دراسات ومقالات في المسرح – هيئة الخرطوم للصحافة والتشر 2018م.
-القومية والمسرح في السوداني 1920-2020- عن مركز يوسف عيدابي لفنون المسرح.
– الرواية التاريخية العربية من منظور نقدي – صادر عن دائرة الثقافة إمارة الشارقة 2022م.
– جدل الخطاب والتجديد – الروايات الفائزة بجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الروائي 2010-2020 صدر عن شركة زين في العام 2023م.
– مقاربات تطبيقية في نقد الرواية السودانية صادر عن دار النشر جامعة الخرطوم – القاهرة ٢٠٢٥.
– المسرح السوداني في زمن العنف ودراسات أخرى- ضمن إصدارات المهرجان الدولي لشباب الجنوب – القاهرة ٢٠٢٥.
وله تحت الطبع كتاب (المسرحية الشعرية العامية في السودان ١٩٢٠- ٢٠٢٠م).
في الجوائز، نال جائزة النقد التطبيقي في مسابقة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي الدورة السابعة، فبراير2017م، وجائزة البحث العلمي للشباب، مهرجان المسرح العربي، الدورة العاشرة، تونس 2018م. وجائزة د. يوسف عايدابي للبحث المسرحي – السودان 2021م.
لا يكتمل هذا المقال من دون الإشارة إلى مقالته المختلفة وذات الجدة التي نشرها في قروبات المسرحيين السودانيين الموسومة بـ(الدرامي والممارسة:
الحرفي، العاطل، والمستنير)، التي حاول فيها تشريح أوضاع الممارسين للعمل المسرحي السائد في مجالات النص والإخراج والأداء، والتقاليد، وقسم هؤلاء الممارسين إلى ثلاثة نماذج، الحرفيين، العاطلين، والمستنيرين، محددًا إسهام كُلُّ نموذج، وكان مما توصلت له هذه المقالة أن الممارسة السائدة في المشهد المسرحي السوداني ومن خلال الممارسين تشير إلى أن الحرفيين قد ساهموا في شلّ حركة التطوُّر المسرحي وذلك بسبب أنهم، (أقرب لحرفيي القهاوي، حيث تنقصهم التجربة المسرحية، وتنقصهم الموهبة، وعدم المعرفة الإيجابية بالدور الذي زجّوا أنفسهم فيه). أما
العاطلين فقد وصفتهم المقالة بأنهم (خريجي فنون مسرحية أو مُدّعين أو عابري سبيل)، وأنهم “ينظِّرون” ولا يقدمون ما يخدم الحركة المسرحية وأفكارهم حبيسة أذهانهم وليس لها تعين في الواقع العملي، أما بخصوص المستنيرين فالمقالة تقول: (هؤلاء مثقفون مستنيرون، وأصحاب مشاريع مسرحية. أسسوا وأضافوا الكثير للحياة المسرحية، لأنهم ولجوا المجال المسرحي عبر مداخل شتّى وبمواهب فذة ومتنوّعة).
بالطبع قد لا أتفق بكل ما جاء في المقالة من فرضيات وتوصيف ونتائج، إلا أن قولي باختلافها وجدتها يكمن في أنها قد تكون البادرة الأولى في النظر إلى شريحة المسرحيين كوسط او كمجموعة بشريه لها حرفتها وعلاقاتها وأساليب تعاطيها مع ما تمارسه على مستويات الكتابة والإخراج والاداء والتقاليد، وأعتقد أن هذا مبحث مشروع وضروري، غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع بعض ما توصلت له المقالة من نتائج.
إن كان من خاتمة لهذه المقالة فهي الإشارة إلى جهود أبو طالب في جمع النص المسرحي السوداني وحفظه، وإن كانت الحرب الراهنة قد جعلت معظم هذه الجهود في خبر كان.