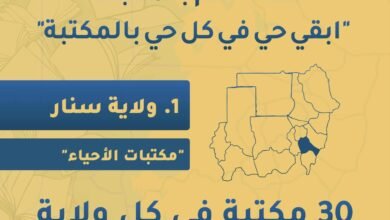في الذِّكرى المئويَّة لميكانيكا الكم وانهيارِ اليقينِ العلميِّ التَّقليدي

بقلم: محمَّد خلف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ[١]الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[٢]الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ[٣]مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ[٤]إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ[٥]
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ[٦]صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ[٧]
لمَّا سُمِعَ للرَّعدِ هزيمٌ في القضارف، سارَعَ أخي بابكر الوسيلة إلى جَوَّالِه، فكتب لي في رسالةٍ على تطبيق “واتساب” هذه الجُزئيَّة من الآية رقم “١٣” من “سورة الرَّعد”: “ويُسَبِّحُ الرَّعدُ بحمدِه والملائكةُ من خِيفَتِه ويُرسِلُ الصَّواعِقَ فيُصيبُ بها مَن يشاءُ ..”؛ ثمَّ قال لي: “إن شاء الله أكون كتبت الآية صاح”. ساعتَها، أحسستُ بشكلٍ غريزي أنَّها صحيحة، لكنَّها ناقصة؛ ففتحتُ المُصحَف، فاستيقنتُ من تكمِلَتِها، وهي: “.. وهُم يُجادِلونَ في اللهِ وهُوَ شديدُ المِحالِ”. فقلتُ في ردِّي لبابكر: “أيوا؛ دي تِلتين الآية، لكنَّها صحيحة”. بمعنى أنَّ الآية رقم “13” من سورة “الرَّعد” هي في واقعِ الأمر، مكوَّنةٌ من ستِّ وَحداتٍ دَلاليَّة، تمَّ إيرادُ الأربعِ الأولى منها من قِبَلِ أخي بابكر، وتبقَّت منها وَحدتانِ حاسِمَتانِ في توضيحِ معنى الآية، وهو الفرقُ الشَّاسع بين قُدرةِ الخالقِ وجبروتِه وقِلَّةِ حيلة المجادِلين فيه أمامَ كيدِه وقوَّةِ تدبيرِه بالحقِّ.
ثمَّ تذكَّرتُ أنَّنا أعددنا في السَّابقِ ملفَّاً مبدئيَّاً بشأنِ البنيةِ الدَّلاليَّةِ للآياتِ القرءانيَّة. وعندما بدأنا في تصفُّحِه مجدَّداً، تبيَّن لنا أنَّه من ناحية المبنى -مثلما هو معروف- فإنَّ الآياتِ في المصاحف تخلو من علاماتِ التَّرقيم الأليفة، مثل الفاصلة (،) والفاصلة المنقوطة (؛) والنُّقطة (.)، وتستعيضُ عنِ الأخيرة بقوسٍ مُحَلًّى في داخلِه رقم ﴿﴾ أو بدائرةٍ في جَوفِها رقم ، للإشارةِ معاً إلى انتهاء الآيةِ وعددها؛ وعِوَضاً عن علاماتِ التَّرقيم المعروفة، تَستخدِمُ المصاحفُ طائفةً من علاماتِ الوقفِ ومصطلحاتِ الضَّبطِ الَّتي تُعينُ المقرئ على ترتيلِ الآيات. ذلك ما كان بشأنِ المبنى؛ أمَّا من ناحيةِ المعنى، فإنَّ هناك وَحداتٍ دَلاليَّةً مميَّزة، ولكن لا توجد علاماتٌ مرقَّمةٌ تدلُّ عليها، إلَّا أنَّه يُمكِنُ التَّعرُّفُ عليها لِتَميُّزِها بسماتٍ دالَّة؛ منها على سبيل المثال لا الحصر، ابتداؤها بعبارةٍ اسميَّة (“السَّارق والسَّارقة”)؛ أو فعليَّة (“يُرسِلُ الرِّياحَ”)؛ أو حاليَّة (“جزاءً بما كسبا”)؛ أو بضميرِ رفعٍٍ منفصل (“وهُم يُجادلونَ في الله”)؛ أو بضميرِ نصبٍ منفصل (“إيَّاكَ نعبدُ”). إلَّا أنَّ هذه الوَحداتِ الدَّلاليَّةَ تتفرَّع في دَرَجِ الآية المحدَّدة وأحياناً عبر عددٍ محدودٍ من الآياتِ الَّتي تليها، وقد تتشعَّبُ إلى وَحداتٍ دَلاليَّةٍ أصغرَ، لكنَّها تلتئمُ وتلتحمُ جميعُها وفقاً لنَسَقٍ منطقيٍّ واضح يقودُ باكتمالِ ورودِ آخِرِ وَحدةٍ منها إلى إيضاحِ الدَّلالة الكلِّيَّة للآية المحدَّدة والآياتِ التَّالية المرتبطة بها دلاليَّاً؛ وأحياناً تكونُ الوَحدةُ الدَّلاليَّةُ الَّتي تأتي في نهاية الآية، قابلةً للتَّكرار في نفسِ السُّورة أو تكونُ صالِحةً للاستخدامِ الملائمِ مع آياتٍ أخرى.
وهذه الخاصِّيَّةُ الأخيرةُ هي الَّتي أربكت عالِماً في قامةِ أبي سعيد الأصمعي، إلَّا أنَّها لم تفُت على الفطرةِ السَّليمة لأعرابيٍّ يُقالُ إنَّه سَمِعَ العالِم اللُّغويَّ البَصريَّ يستشهِدُ بآيةٍ من القرءان الكريم، فقال: “والسَّارق والسَّارقة فاقطعوا أيديَهما جزاءً بما كسبا نَكالاً من الله والله غفورٌ رحيم”؛ فقال الأعرابي: “هذا ليس كلام الله”. وكان هناك عددٌ من الحاضرين، سادَ بينهمُ هَرَجٌ ومَرَج. وحَسماً للجِدال، تمَّ إحضارُ المُصحَف؛ ففتَحَ الأصمعيُّ المُصحَف على سورةِ “المائدة”، الآية رقم “38”، وقال للأعرابي، اسمع هذه هي الآية: “والسَّارق والسَّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نَكالاً من الله والله عزيزٌ حكيم”. فقال الأعرابيُّ للأصمعي: “لكنَّك قلتَ آنفاً واللهُ غفورٌ رحيم”. وعندما فطِنَ الأصمعيُّ إلى الخطأ، سأل الأعرابيَّ قائلاً: “يا أعرابيُّ كيف عرَفتَ”؟ قال الأعرابي: “يا أصمعيُّ عَزَّ فَحَكَمَ فَقَطَعَ؛ ولو غَفَرَ ورَحِمَ، لما قَطَعَ”. فالأعرابيُّ قد فطِن بفطرتِه إلى التَّرابطِ المنطقيِّ للوَحداتِ الدَّلاليَّة للآية، رغم عدم حفظِه للسُّورة؛ بينما لم يفطنِ العالمُ اللُّغويُّ الفذُّ إلى أنَّ الوَحدةَ الدَّلاليَّةَ الأخيرةَ للآية قابلةٌ للاستخدام في آيةٍ أخرى، فقط عندما تكونُ ملائمةً لسياقِها.
وقبل أن ننتقِلَ إلى الحديث عن الآية رقم “88” من سورة “النَّمل” لصلتِها بانهيارِ اليقينِ العلميِّ التَّقليدي، نودُّ أن نقِفَ قليلاً عند الوَحدة الدَّلاليَّة، لأهمِّيَّتِها في توضيح صلةِ هذه الآية الكريمة بميكانيكا الكم. فالوَحدة الدَّلاليَّة تنقسِمُ في تصوُّرِنا لها إلى قسمَيْن: وَحدةٌ رئيسيَّة ووَحدةٌ فرعيَّة (أو وَحداتٌ فرعيَّةٌ أصغر). وتشتملُ الوَحدةُ الدَّلاليَّةُ الرَّئيسيَّةُ على مفردةٍ أو عبارةٍ دالَّةٍ قابلةٍ للتَّكرارِ أوِ الاستتارِ بضميرٍ صريحٍ أو ضمني؛ أمَّا الوَحدة الدَّلاليَّة الفرعيَّة أو الوَحدات الفرعيَّة الأصغر، فهي مرتبطةٌ بصددِ تبيين دَلالتِها بذاتِ المفردةِ أوِ العبارةِ الدَّالَّة الَّتي تشتملُ عليها الوَحدةُ الرئيسيَّةُ الَّتي تسبِقُها أو ترتكزُ عليها. ولتوضيح ذلك، سننظُر إلى البنية الدَّلاليَّة لسورة “الفاتحة”. تتكوَّن الآية الأولى من هذه السُّورة الافتتاحيَّة -والَّتي تُعرَف بـ”البَسمَلَة”- من وَحدتَيْن دَلاليَّتَيْن مُبسََّطتَّيْن: رئيسيَّة وفرعيَّة (من غيرِ وجودِ وَحداتٍ فرعيَّة أصغر)؛ فالرَّئيسيَّة هي “بِسْمِ اللَّهِ”، وتحتوي على عبارةٍ قابلةٍ للاستتار ضمن الوَحدة الدَّلاليَّة الفرعيَّة الَّتي تليها، وهي “بِسْمِ”، الَّتي تستترُ في الوَحدة الفرعيَّة الَّتي تليها، وهي “الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ”؛ فكأنَّنا نقولُ دَلاليَّاً أيضاً بعد “بِسْمِ اللَّهِ”: بِسْمِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.
وتشتملُ الآية الثَّانية -والَّتي تُعرَف بـ”الحَمدَلَة”- على الوَحدة الدَّلاليَّة الرَّئيسيَّة الثَّانية في هذه السُّورة الكريمة، وهي “الْحَمْدُ لِلَّهِ”؛ وبدورِها تشتملُ هذه الوحدة الدَّلاليَّة على العبارةِ الدَّالَّة المُضمَّنة داخلها وهي “الْحَمْدُ لِـ”، الَّتي تنتقلُ إلى ثلاثِ وَحداتٍ فرعيَّة متساوية في الرُّتبة، تليها مباشرةً في نفسِ الآية: “رَبِّ الْعَالَمِينَ”؛ وتمتدُّ عبر الآيتَيْنِ التَّاليتَيْن: “الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ”، و”مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ”؛ فكأنَّنا نقولُ على وجهٍ دَلاليٍّ أيضاً بعد “الحمدُ لله”: الْحَمْدُ لرَبِّ الْعَالَمِينَ، والْحَمْدُ للرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، والْحَمْدُ لمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. وتشتمل الوَحدةُ الدَّلاليَّةُ الرَّئيسيَّةُ الثَّالثةُ لهذه السُّورة -وهي “إِيَّاكَ نَعْبُدُ”- على ضميرِ نصبٍ متَّصلٍ قابلٍ للتَّكرار ضمن الوَحدة الفرعيَّة الَّتي تليه، وهو “إِيَّاكَ”. أمَّا الوَحدة الدّلاليَّة الرَّئيسيَّة الرَّابعة والأخيرة، فهي “اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ”، الَّتي تحتوي على الدَّالة “اهْدِنَا”، والمفردة القابلة للتَّكرار والاستتار، وهي كلمة “الصِّراط”، فتتكرَّرُ في الوَحدة الدَّلاليَّة الفرعيَّة الَّتي تليها: “صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ”، وتستترُ في الوَحدتَيْن الدَّلاليَّتَيْن: “غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ” و”وَلَا الضَّالِّينَ”؛ فكأنَّنا نقول على وجهٍ دَلاليٍّ: “صِرَاطَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ” و”وَلَا صِرَاطَ الضَّالِّينَ”.
في كتابه “دلائل الإعجاز” الَّذي يُعنى معرفيَّاً بعلمِ المعاني ويؤسِّس له داخل الثَّقافة العربيَّة في عهدِها العبَّاسيِّ، يُعَرِّفُ الجرجانيُّ النَّظمَ بأنَّه “تعليقُ الكَلِمِ بعضها ببعض، وجعلُ بعضِها بسببٍ من بعض”؛ وإذا كانتِ الكلِمُ نفسُها (اسمٌ وفعلٌ وحرف) هي تعلُّقُ بعضِ الحروفِ ببعضِها البعض (ومعظمُها لا ينتِجُ كلماتٍ لها معنًى لمجرَّدِ تعلُّقها ببعضها البعض)، فإنَّ الوَحداتِ الدَّلاليَّةَ الفرعيَّة –حتَّى عند تشعُّبها إلى وَحداتٍ فرعيَّةٍ أصغر- تتعلَّقُ بالوَحدة الدَّلاليَّة الرَّئيسيَّة -الَّتي تأتي في الغالبِ متقدِّمةً على غيرِها من الوَحداتِ الفرعيَّة- بواسطة مفردةٍ أو عبارةٍ دالَّةٍ، ظاهرة أو مُستَتَرَة، كما جاء ذكرُه آنفاً. لذلك، يُمكِن تشبيهُ تعلُّقِ الحروف -بوصفها أصواتٍ لا دَلالة منفرِدَةً لها- بالتَّرابط الفيزيائي؛ وتشبيه تعلُّق الكلِمِ المُنتِجة للجُمل -كما جاء في تعريف النَّظم عند الجرجاني- بالتَّرابط الكيمائي؛ أمَّا تعلُّقُ الوَحدات الدَّلاليَّة الفرعيَّة المتشعِّبة بالوحدات الرَّئيسيَّة، فإنَّه يُشبه التَّرابطَ البيولوجي، كما هو الحال في عِلمِ الأحياء الجُزيئي. هذا على أن يُشَبَّهَ ترابطُ الآياتِ في السُّورةِ نفسِها ومكانُ نزولِها وأسبابُ ذلك النُّزُولِ بالتَّرابُطِ الاجتماعيِّ الأوسع.
مرَّت يومَ الثُّلاثاء (٢٩ يوليو ٢٠٢٥) الذِّكرى المئويَّة لتوصُّلِ عالمِ الفيزياء الألمانيِّ فيرنر هايزنبيرغ إلى مصفوفتِه الرِّياضيَّة الشَّهيرة الَّتي وَصفت حركةَ الجُسَيماتِ المُتناهيةِ في الصِّغر -وهي حِزَمٌ منفصلةٌ من الطَّاقة تختلفُ عنِ النَّظرةِ القديمة الَّتي تعتبرُها ظاهرةً مستمِرَّة- وهي جُسَيماتٌ لا يُمكِنُ وصفُها بقوانين الحركة السَّائدة الَّتي صاغها إسحق نيوتن. وفي نفسِ العام، توصَّل عالمُ الفيزياء النَّمساوي إيرفن شرودنغر إلى وصفٍ لها أفضلَ وأسهلَ في التَّصوُّرِ من مصفوفةِ هايزنبيرغ، وهو استخدامُه للموجة عِوضاً عنِ المصفوفة؛ وكلا التَّصوُّرين لا يُحدِّد مَوضِعاً معلوماً لمكانِ الجُسَيمات أو سرعةِ متَّجهها (أي زَخَمِها)، وأنَّ كلَّ ما يتنبَّأُ به التَّصوُّران هو كلُّ الأماكنِ المحتملة الَّتي قد يتواجدُ بها الجُسَيمُ في نفسِ الوقت، والَّذي لا يتحدَّدُ موضِعُه بشكلٍ قاطع إلَّا عند الرَّصدِ أو المشاهدة (“أوبزرفيشن”) الَّتي تؤدِّي إلى انهيار الدَّالَّة المَوجيَّة في تصوُّر شرودنغر، الَّذي أصبح مقبولاً لدى غالبيَّة العلماء؛ وهو ما رفضه ألبرت آينشتاين بعبارتِه الشَّهيرة: “اللهُ لا يلعبُ بالنَّرد”؛ وهو القولُ الَّذي ينسجمُ مع منطوق الآية رقم “16” من سورة “الأنبياء”: “وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ”. إلَّا أنَّ أغلبيَّة العلماء في أعقاب مؤتمر “سولفاي” الخامس عام 1927 ببروكسل لم يقفوا مع آينشتاين، بلِ اتَّفقوا مغ نظيرِه عالمِ الفيزياءِ الدِّنماركيِّ نيلز بور، الَّذي يرى أنَّ الجُسَيم يكون في حالة “تراكُب” (“سوبربوزشن”)، أي أنَّه موجودٌ في نفسِ الوقتِ في جميع مواضع الدَّالَّة الموجيَّة قُبيلَ انهيارِها بالمشاهدة أوِ المراقبة الآليَّة. وعلى هامشِ ذلك المؤتمر الشَّهير، أخذ العالمانِ الكبيرانِ يتحاورانِ بلا انقطاع، واستمرَّا في تبادلِ الرَّسائل والتَّجارب الفكريَّة (“غيدانكن إكسبريمنتن”) لسنواتٍ طويلة، في مسعًى منهما لإيجادِ تفسيرٍ معقولٍ لكيف يُمكِنُ لجُسَيمٍ أن يكون في حالة “تراكُب” في كلِّ الحالات الممكنة حتَّى يتمَّ مشاهدته.
وقد ظلَّ تصوُّرُ نيلز بور للجُسَيم هو الوضعُ الافتراضيُّ المقبول لأغلبيَّةِ العلماء؛ وهو ما بات يُعرَف بتفسير كوبنهاغن، في إشارةٍ لمَوطِنِ العالمِ الدَّنماركي؛ غير أنَّ هذا “التَّفسير” ليس هو في واقعِ الأمرِ تفسيراً، بل قبولاً بالوضعِِ الافتراضيِّ السَّائد باعتبارِه هو الفهمُ الأساسيُّ لميكانيكا الكم، لأنَّه يُعطي من ناحيةٍ رياضيَّةٍ بحتة نتائجَ معمليَّةً جيِّدة. غير أنَّ آينشتاين لم يقبل بهذا الوضع، لأنَّه لا يستقيمُ عَقلاً من جِهَةِ دَلالتِه على “الواقع”؛ وظلَّ العالِمُ الأشهرُ يبحثُ بلا طائلٍ يُذكَر عن عواملَ أو متغيِّراتٍ مخفيَّةٍ -بخلافِ المُشاهِد- تقودُ إلى تحديد موضع الجُسَيم. كما أخَذَ العديدُ من العلماء يأتونَ، على غِرارِ آينشتاين، بتفسيراتٍ لميكانيكا الكم تدحضُ “التَّفسيرَ” السَّائد، ولكن هيهات؛ بل أنَّ هذه التَّفسيراتِ المتلاحقة ما فتئت تفترضُ وقائعَ أغربَ من حالتَيِ “التَّراكُب” أوِ “التَّشابك” (“إنتانغلمينت”) الَّتي تمَّ اكتشافُها لاحقاً في أعقابِ ورقةٍ قدَّمها كلٌّ من آينشتاين وبَدولسكي وروزِن (“إي بي آر”)؛ ومن ضمن تلك الوقائع الغريبة، نظريَّة “العوالمِ المتعدِّدة”، الَّتي ترى أنَّ الدَّالَّة الموجيَّة لا تنهارُ بعد المشاهدةِ أو الرَّصد، بل أنَّ جميعَ الاحتمالاتِ تظلُّ قائمةً، وتتكرَّرُ في أكوانٍ موازية؛ وهناك أيضاً نظريَّة دا بروي-بوم الَّتي تسمح بحدوثِ تفاعلاتٍ أسرعَ من الضَّوء بين الجُسَيمات، ممَّا يتعارض مع نظريَّة النِّسبيَّة الخاصَّة الَّتي صاغها ألبرت آينشتاين في عام 1905.
وهناك أيضاً تفسيرٌ ضمنيٌّ للآية رقم “88” من سورة “النَّمل” يفترضُ واقعاً غريباً لم يخطُر على بالِ المفسِّرين الأوائل أو أنَّهم استبعدوه على الفور بشكلٍٍ غريزيٍّ، واعتبروا أنَّ حدوثَه سيكونُ فقط في يومِ الحشر، مع أنَّ الوَحدتَين الدَّلاليَّتَيْنِ الأخيرتَيْن من الآية الكريمة (وهما الوَحدتانِ الرَّابعة والخامسة) تُشيرانِ بشكلٍ واضح إلى إتقانِ صَنعةِ الصَّانعِ في هذه الدُّنيا وعِلمِه بما يفعلُ عبادُه فيها من خيرٍ أو شر. ففي هذه الآية، يقولُ جلَّ جلالُه: “وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ”. وفي الوَحدة الدَّلاليَّة الرَّئيسيَّة الأولى (وَتَرَى الْجِبَالَ)، ليس بالضَّرورة أن تكونَ هناك ساعةَ تلاوةِ الآية جبالٌ واقعيَّة يُمكِنُ مشاهدتُها، ولكن إذا رأينا جبالاً أو تصوَّرناها في الذِّهن، فإنَّنا سنظُنُّها ثابتةً أو بتعبيرِ القُشَيريِّ “واقفةً في مرأى العين”، حسب الوَحدة الدَّلاليَّة الَّتي تليها (تَحْسَبُهَا جَامِدَةً)؛ وهذا هو انطباعُنا المُعتادُ بشأنِ صلابةِ الجبال وقوَّتها؛ ومن أجلِ ذلك، يتمُّ استخدام الجبال في القرءان للتَّعبير عن هذه الدَّلالةِ تحديداً؛ ففي الآية رقم “72” من سورة “الأحزاب، يقولُ تعالى، جلَّ شأنُه: “إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا”، فالسَّماواتُ والأرضُ تُغطِّي كلَّ أشياء الكون، فأُضيفتِ الجبالُ للتَّعبير عن قوَّة الحِمل. وكذلك في الآية رقم “88” من سورة “النَّمل”، إذا كانتِ الجبالُ في قوَّتِها وصلابتِها تمرُّ في واقعِ الأمرِ مرَّ السَّحاب، كما جاء في الوَحدة الدَّلاليَّة الثَّالثة من الآية، فإنَّ كلَّ الجُسَيماتِ في هذا الكونِ سيكونُ هذا هو حالُها.
وبناءً على هذا الفهم، نعتقدُ أيضاً -تمهيداً لتفسيرٍ معاصرٍ للآية رقم “88” من سورة “النَّمل”- أنَّ العبارة الدَّالَّة المِفتاحيَّة في الوَحدة الدَّلاليَّة الثَّانية من الآية الكريمة (تَحْسَبُهَا) تحتملُ معنيَيْن؛ فبالرَّغم من أنَّ أهلَ الكوفة يقرءون بفتحِِِ السِّين، وهو القياس، إلَّا أنَّه قد رُوِيَ أيضاً عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنَّه قرأ بالكسر، حسب قول القُرطبيِّ؛ فالقراءةُ القياسيَّة تُشير إلى معنى الظَّنِّ: “تحسَبُها” أي تظُنُّها؛ لكنَّ القراءةَ بالكسرِ الَّتي نُسِبت إلى النَّبي ربَّما تُشيرُ إلى دَلالةٍ أعمقَ غوراً؛ فبالإضافةِ إلى معنى الظَّنِّ، ربَّما تُشيرُ العبارةُ بالكسرِ إلى مَهمَّةِ القيامِ بكافَّةِ العمليَّاتِ الحسابيَّة؛ وهي في نظرِنا تلك العمليَّات المُعَقَّدة الَّتي يقومُ بها الدُّماغُ -بيولوجيَّاً- بدءاً من عمليَّاتِ التَّنفُّس والدَّورة الدَّمويَّة والهضم الَّتي يضطَّلعُ بالقيام بها جذعُ الدُّماغ، ومروراً بالاعتمالاتِ العاطفيَّة من خوفٍ وغضبٍ وحزنٍ وكَرْبٍ وهستيريا الَّتي يقومُ بها الجهازُ الحوفيُّ المُشرِف على كافَّةِ الانفعالاتِ المتعلِّقة بغرائزِ البقاء والتَّرابطِ الاجتماعيِّ وتعزيزِ الذَّاكرة، وانتهاءً بالقشرةِ المُخِّيَّة المسؤولة بشكلٍ رئيسيٍّ عنِ الحواسِّ والحركة. وحتَّى هذه الوظائف الَّتي يبتدرها بوعيٍ فصٌّ أماميٌّ في مقدِّمة الدُّماع لا يُمكِنُ الاضطِّلاعُ بها من غير تلك العمليَّاتِ الحسابيَّة التَّمهيديَّة الَّتي تُنفِّذُها قشراتُ الحواسِّ (بصريَّةٌ، سمعيَّةٌ إلى آخرِ الحواسِّ) والحركة.
بمعنًى آخر، أنَّ المشاهدةَ (أوِ الرَّصدِ الآلي) في تفسير كوبنهاغن لميكانيكا الكم لا يُمكِنُها التَّسبُّب في انهيار الدَّالَّة الموجيَّة إلَّا بعد تنفيذ تلك العمليَّات الحسابيَّة الدَّقيقة بواسطة القشرة المحدَّدة في الدُّماغ. وبمعنًى ثانٍ، إنَّ تفسير الآية رقم “88” من سورة “النَّمل” لا يدعمُ فقط “تفسيرَ ” كوبنهاغن بشأنِ “التَّراكُب” (وهو كما قلنا ليس تفسيراً بل تأطيراً للمشكلة القائمة وقبولاً بوضعيَّتِها الإشكاليَّة، وعدم القدرة على الخروج منها بتفسيرٍ مقبول عِلميَّاً)، وإنَّما يؤكِّد كذلك رؤية آينشتاين الَّتي ظلَّ مقتنِعاً بها إلى آخر نفسٍ في حياتِه العلميَّة الثَّريَّة، وهي الحاجةُ إلى سبرِ واستكناهِ “المتغيِّراتِ المخفيَّة” (“هِدَن فيريابلس”) الَّتي تكمُنُ خلف ظاهرة “التَّراكب”؛ ولكن هيهات، فليس بالإمكان سوى رؤية الجبالِ وهي جامدة (وهي رؤية الظَّواهر الخارجيَّة)، ولا يُمكِنُ رؤيتها وهي تمرُّ مرَّ السَّحاب (فذلك مكمنُ الجواهر)؛ ولا يعلمُ الجواهرَ إلَّا الَّذي يعلمُ كلَّ شيءٍ عِلماً مطلقاً؛ وهو “الحقُّ”، في مقابل ما نُطلِق عليه مجال “الحقيقة” الَّذي ينحصرُ في العِلمِ بالظَّواهرِ فقط: “يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ” (الآية رقم “7” من سورة “الرُّوم”).
عندما أكمَلَ المركيز بيير-سيمون لابلاس أُطروحتَه بشأنِ الميكانيكا السَّماويَّة (“ميكَنيك سيليست”)، طرح عليه نابليون سؤالاً مستفسِراً فيه عن خلوِّ ذلك النِّظام من الخالقِ الَّذي أبدعَه وأنَّه لا يذكُرُ فيه اللهَ ضمن تفسيرِه العلمي، فأجابَ العالمُ الفرنسيُّ بأنًّه ليس في حاجةٍ إلى هذه الفرضيَّة (“جو نافي با بيزوا دو سيت ايبوتيز-لا”)؛ وكانت تلك الإجابة منسجِمَةً للغاية مع روحِ اليقينِ العلميِّ الَّذي أرساه إسحق نيوتن. أمَّا في عام ١٩٢٥، عندما أبدع هايزنبيرغ مصفوفتَه، وفي أعقابِ إرسائه أيضاً لمبدأ الرِّيبة أوِ اللَّايقين (وهو استحالةُ معرفةِ موقعِ الجُسيمِ وزخمِه في ذاتِ الآن) ضمن بنيةِ المعرفةِ العلميَّة في إطارِ ميكانيكا الكم، لم يعُد من الممكن لعالِمٍ أن يُدلي بإجابةٍ لابلاسيَّةِ اليقين. إلَّا أنَّه مع ذلك، فإنَّ العلومَ الطَّبيعيَّة لا تصلُحُ -بسببِ تعرُّضِ أسُسِها النَّظريَّة للتَّغيُّر- أساساً لإثباتِ وجودِ الخالقِ مبدِعِِ هذا الكون، ولكنَّها تُساعِدُ بمقتضى طبيعتِها الكاشفة على تعزيزِ أحقيَّةِ الدِّينِ في أن يجِدَ له مكاناً إلى جانبِها والتَّنافسِ معها في مَهَمَّةِ سبرِ أغوارِ الكون، عِوضاً عن اعتبارِ خالقِه “فرضيَّةً” لا تنشأُ حاجةٌ إليها أوِ اعتبارِ أنَّها (أي العلوم الطَّبيعيَّة) لا محالةَ مُقدِمَةٌ في تطوُّرِها المتسارِعِِ على “التهامِ غَداءِ الدِّينِ” وتجفيفِ كافَّةِ مواردِه.