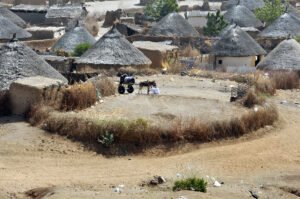
لفت نظري أحدهم، وهو يخاطب مصلين وكان موضوع حديثه القناعة. هنا تحرّكت في نفسي شهوة التفكير والتأمل. وكعادتي، سرحت مع لهجتنا السودانية التي تزخر بالكلمات ذات الأصول العربية، وأحيانًا المحرّفة منها، ووجدتني أتساءل: كم من كلمة نستعملها يوميًا قد انحرفت دلالتها عما كانت عليه؟ إضافة طبعًا إلى اللغة النوبية أصل لغة البلاد الأصليين مع القليل من التعابير الأفريقية أوجدتها ظروف الجيرة وبالطبع التداخل.
اليوم، وقفت عند كلمة القناعة. نحن في الريف نقول: فلان قنعان، في إشارة إلى من استسلم لواقعه وتنازل عن حقه، وكأنها أقرب لمعنى الخذلان أو الإحباط. بينما الأصل في العربية أرفع شأنًا وأسمى معنى؛ فقد جاء في المعاجم أن القناعة: الرضا بما قسم الله من الرزق، حتى ضرب العرب المثل المشهور: القناعة كنز لا يفنى. كما أن هناك كلمة مقنعة وتقال للمرأة المحتشمة وهي بالقطع عكس الكاشفة، وقد قال شاعرهم: يا مقنِّع الكاشفات
والسؤال هنا كيف تحوّلت الكلمة من كنزٍ لا يفنى إلى رمزٍ للتنازل والانكسار؟
فهل هو انعكاس لواقعنا الاجتماعي، حيث يضطر الناس أحيانًا إلى الصمت بدعوى القناعة؟ أم هو تحوير شعبي لمعنى أعمق كان في الأصل فضيلة؟
ويبدو أن هناك ألفاظًا أخرى تشاركها هذا الانزياح: قنعت، قنعوني، قنعوا… كلها اليوم تقال حين ييأس المرء، لا حين يرضى.
فهل نحن من بدّلنا المعنى، أم أنّ اللغة – كما الحياة – تتشكل وفق ألسنة الناس وظروفهم..
عثمان يوسف خليل
المملكة المتحدة