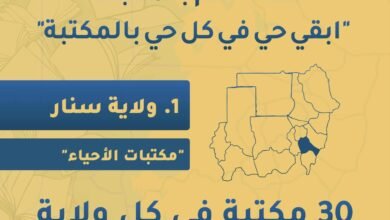من تسييس المؤسسات إلى دولة المؤسسات

بقلم : عبده الحاج
سلسلة مقالات قصيرة حول بناء الدولة السودانية الحديثة على المفاهيم الصحيحة، وتحليل مسارها من الفشل إلى الوعي والوحدة. تهدف المقالات إلى تحريك بركة الوعي المفاهيمي، أو قل: بغرض الدعوة للثورة الثقافية، حيث يلتقي الفكر الثائر بالواقع، وهي دعوة للناشطين بصورة خاصة، وللشباب من الجنسين بصورة أخص.
المقال الأول: من تسييس المؤسسات إلى دولة المؤسسات – البداية من المفهوم لا من المحاصصة
في خضمّ الحرب السودانية الراهنة، وتعدد المبادرات الإقليمية والدولية الساعية لإنهائها، تعود إلى السطح من جديد دعوات لإشراك المؤسسات المدنية والعسكرية في الحكم باعتباره شرطًا لتحقيق العدالة والمساواة وضمانًا للاستقرار. تبدو هذه الدعوات في ظاهرها منطقية، لكنها في جوهرها تعكس أحد أخطر المفاهيم المغلوطة في الفكر السياسي السوداني، وهو الخلط بين المؤسسة بوصفها كياناً خدمياً يؤدي وظيفة محددة داخل الدولة، وبين السلطة بوصفها كياناً حاكماً مفوضاً من الشعب ومساءلاً أمامه. هذا الخلط هو الذي قاد السودان عبر تاريخه إلى أزماتٍ متكررة، وحال دون قيام دولةٍ حقيقية تقوم على القانون والمؤسسات، لا على توازنات القوة وتقاطعات المصالح.
المؤسسة في معناها الحديث هي كيان قانوني مستقر أُنشئ لخدمة غرض محدد في منظومة الدولة، فالجيش للدفاع عن الوطن ، والشرطة لحماية الأمن ، والقضاء لتحقيق العدالة، والتعليم لبناء الإنسان ، والخدمة المدنية لتسيير شؤون الناس . وهذه المؤسسات ليست أطرافاًسياسية تتنافس على السلطة أو تُقسم بينها المناصب، بل أدوات تنفيذٍ لسياسات الدولة التي يقررها الشعب عبر ممثليه المنتخبين. أما الحكم فهو سلطة سياسية مؤقتة تُفوض من الشعب وتُحاسب أمامه وتُمارس وفق القانون. ومن هنا تترسخ القاعدة التي لا تنهض أي دولةٍ من دونها: السياسة تُقرر ماذا يُفعل، والمؤسسة تُنفذ كيف يُفعل. وعندما تختلّ هذه المعادلة ويتحول الجهاز الخدمي إلى فاعل سياسي، تفقد الدولة توازنها الداخلي وتغيب عنها روح الحوكمة الرشيدة.
لقد أدت المفاهيم المغلوطة حول دور المؤسسات إلى أضرارٍ عميقة في بنية الدولة السودانية، فاعتبار المؤسسة طرفاً سياسياً مستقلاً جعلها تنحاز إلى الولاءات لا إلى القانون، وتحولت من أداة خدمة إلى أداة سلطة، كما أن الاعتقاد بأن مشاركة المؤسسات في الحكم ضمانٌ للاستقرار ثبت خطؤه بالتجربة، إذ لم تؤدِّ هذه المشاركة إلا إلى إضعاف الخدمة المدنية، وتسييس الجيش والأمن، فانهارت هيبة الدولة، وانقسمت أجهزتها على نفسها. أما مفهوم المساواة بين المؤسسات، الذي يُطرح أحيانًا في سياق “العدالة السياسية”، فهو مفهوم مغلوط أيضًا، لأن المساواة التي يُفترض السعي إليها هي المساواة بين المواطنين أمام القانون، لا بين الأجهزة أمام السلطة.
الإصلاح الحقيقي يبدأ من تصحيح المفاهيم ، فالمؤسسة يجب أن تخضع لسلطة مدنية منتخبة، أو مُفوضة ، وتعمل ضمن الدستور، وتتمتع بإستقلالها المهني، بعيداً عن نفوذ الأحزاب أو الفصائل ، مع خضوعها في الوقت نفسه للمساءلة القانونية والرقابة المجتمعية، ويجب أن تقتصر مهامها على وظائفها الدستورية دون أن تتحول إلى أداة تفاوض سياسي أو كيان إقتصادي منافس. عندما تُبنى المؤسسات على هذا الأساس، تصبح عمود الدولة الفقري لا عبئاً عليها، وتتحول من أدوات نفوذ إلى أدوات خدمة عامة تسعى لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
غير أن قيام دولة المؤسسات لا يتحقق فقط بتصحيح العلاقة بين السلطة والمؤسسة، بل يتطلب كذلك رأيًا عامًا مستنيرًا، يراقب الأداء العام، ويقيّم سلوك الدولة وأجهزتها، فالمجتمعات لا تستقر بالقوانين وحدها، بل بوعي الناس بحقوقهم، وقدرتهم على المراقبة والمحاسبة. إن غياب الرأي العام المستنير هو ما سمح للمفاهيم المغلوطة أن تسود، وللخطابات المضللة أن تتكرر جيلًا بعد جيل. حين يضعف الوعي، يُختطف مفهوم (المصلحة العامة) لصالح شعاراتٍ آنية أو انفعالية، وتتحول أجهزة الدولة إلى غنيمةٍ يتقاسمها الأقوياء باسم حماية الوطن أو تحقيق العدالة.
إنّ بناء هذا الرأي العام لا يتم إلا عبر مشاركة فاعلة من الشباب من الجنسين، أولئك الذين زهدوا في الانخراط في الأحزاب السياسية بعد أن رأوا ضياع البوصلة بين المصالح الوطنية والمصالح التنظيمية، وكذلك أولئك الحزبيين الذين تحلّوا بروحٍ وطنيةٍ صادقة وقدّموا مصلحة البلاد على مصلحة الحزب. هؤلاء الشباب هم أصحاب المصلحة الحقيقية في استقرار الدولة، وهم المالكون لزمام الحق في الرقابة والتقويم والمساءلة، فحين يمتلك الجيل الجديد أدوات الوعي والمعرفة، يصبح الرأي العام قوة رقابية تفوق في أهميتها أي جهازٍ من أجهزة الدولة، ويصبح الضمير الجمعي هو الضامن لاستقامة الحكم واستدامة الاستقرار.
إنّ السودان بحاجة إلى أن يُعاد تعريف السياسة بوصفها خدمةً لا سلطة، وأن يُعاد تعريف المواطن بوصفه مالكًا وشريكًا لا تابعًا، ولا يمكن لذلك أن يتحقق إلا عندما تتكامل ثلاثية الوعي والمؤسسة والقانون، فعندما تكون المؤسسة مهنية، والقانون نافذًا، والرأي العام مستنيرًا، يستحيل أن تنجح مغالطةٌ أو تمرّ مؤامرةٌ أو يُختطف الحكم من الشعب. أما إذا غاب الوعي وتبلّد الرأي العام، فإن المفاهيم الخاطئة تجد طريقها إلى العقول، ويُعاد إنتاج الفشل في كل دورة سياسية.
إنّ معركة السودان اليوم ليست فقط في الميدان، بل في العقول، معركة الوعي ضد المفاهيم المقلوبة، ومعركة الرأي العام المستنير ضد التزييف والتبرير، فإذا انتصر الوعي، انتصرت الدولة، وإذا انتصرت الدولة، استقر الوطن. أما إذا ظلّت المفاهيم المغلوطة سائدة، فسنظل نعيد إنتاج الأزمة نفسها بأسماء جديدة وألوان مختلفة. إنّ الطريق إلى الخروج من دوامة الفشل يبدأ من إدراك أن الدولة لا تُبنى بالمحاصصة، ولا بالتحالفات، بل بالمفاهيم الصحيحة، وأنّ الرأي العام الواعي هو الحارس الحقيقي للمؤسسات وللوطن معًا.
(نواصل: سأتناول في الحلقة القادمة التجربة السودانية للإصلاح المبنية على خلل في المفهوم)