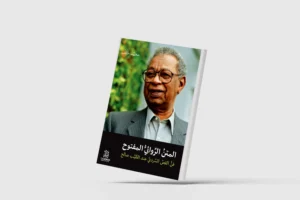
لم يكُن ضمنَ مقاصدِ هذا الكتاب صياغةُ تعريفٍ للقصِّ في أصوله أو ما يتعرَّض له من خلخلةٍ سرديَّة في أبنيتِه التَّزامُنيَّة أو أزمنتِه التَّعاقُبيَّة؛ كما لم يكُن في البالِ تعريضُ النَّصِّ إلى ترهُّلٍ لا لزومَ له، بتناولِ فحصٍ تفصيليٍّ لمفاهيمِه الرَّئيسيَّة، ومنها فكرةُ المتنِ وانفتاحُه على آفاقٍ مستقبليَّةٍ لا يمكن التَّكهُّنُ بكلِّ مآلاتِها بصددِ كلِّ إنتاج روائيٍّ مُحتَمَل. بل كان المقصد الأكثر إلحاحاً هو إنتاجُ نصٍّ إبداعيٍّ موازٍ، غرضُه الأساسيُّ أن يُمكِّنَ أيَّ قارئٍ بعينِه من استحصالِ متعةٍ خاصَّةٍ تُمَهِّدُ لإحداثِ معرفةٍ متميِّزةٍ بالمقروء. وفي هذه السَّانحة الَّتي وفَّرها لنا النَّادي العربي بالشَّارقة، أصبح من الممكن ابتدارُ أفكارٍ بشأنِ التَّعريف والمجازفة بتنضيدِ بعضِ المفاهيم، بغرضِ الاستضاءة بآراءِ الحاضرين والسَّعيِ من جانبِنا إلى استمالتِهم في اتِّجاهِ ما نطرَحُ من آراء، على أمَلِ أن نجِدَ منطقةً وسطى تُمهِّدُ إلى إنتاجِ بدائلَ أفضلَ في المستقبل، فالمعرفةُ الإنسانيَّة في جذرِها الثَّابتِ جهدٌ جماعيٌّ متغيِّرٌ بحَسبِ السِّياقاتِ ومقتضياتِ الأحوال.
يرتبطُ القصُّ في جوهرِه بمكنونِ الذَّاكرة وما انحفرَ فيها من آثارٍ باقية؛ كما ترتبطُ الذَّاكرة، بدورِها، بالزَّمان، الَّذي تعرَّض مع انبثاقِ الحداثةِ الأوروبيَّة لهزَّاتٍ عميقة، الأمر الَّذي انعكس بشكلٍ لا تُخطئه العين على مِسيار تطوُّر الرِّواياتِ الحديثة، ومن بينها روايات الطَّيِّب صالح. وقد يبدو من أوَّلِ وهلةٍ أنَّنا هنا أمام مترادفاتٍ لا فارقَ جوهريَّاً بينها؛ ففي كثيرٍ من الأحيان، لا يُقيمُ الكُتَّابُ فرقاً يُذكَرُ بين القصِّ والحَكِي والسَّرد؛ إلَّا أنَّنا في هذا العرض، سنضعُ إلى جانبِ التَّرادُفِ المعهودِ حدوداً إجرائيَّةً فاصلة بين هذه المصطلحاتِ المُتداخِلة: فالقصُّ، حسبُ هذه الإجراءات الفاصلة، هو تتبُّعُ مسارِ أمرٍ بشكلٍ تعاقبيٍّ متسلسلٍ منذُ بدايةٍ مُفترضةٍ له؛ وهي في الغالب، كما في فنونِ القصِّ التَّقليديِّ، لا ترتبطُ بتاريخٍ محدَّد، وإنَّما بفترةٍ غامضة في الماضي البعيد: “كان يا ما كان في سالفِ العصرِ والأوان”؛ والحَكِي هو مصطلحٌ عام (“جنريك”) يُستخدَمُ في عرضِ محتوياتِ الذَّاكرة، سواءً كان ذلك مرتبطاً بتتابُعِ الأحداث أو مستنِداً إلى تجزئتها بالتَّواتر؛ أمَّا السَّردُ، فهو خلخلةٌ مُربِكةٌ لأزمنةِ القصِّ المعهودة والتَّصرُّفُ الحُرُّ في طريقةِ الحَكِي تقديماً وتأخيراً؛ ومن ضمنِ ذلك، تقنِّياتُ “الفلاش باك”، وما يُسمَّى تيَّار الوعي، وتنوُّع الأجناس الأدبيَّة، وتعدُّدُ الرُّواةِ وتداخُل حكاياتِهم، وتبايُن مواقعِهم، وعدمُ الثِّقةِ فيما يتناولونَ من أحداثٍ وما يطرحونَ من أفكار.
ولم تعُدِ الذَّاكرة، كما في الفهمِ القديم، هي ذلك المستودع الَّذي يحفظ الصُّوَرَ والموادَّ من غيرِ أن يطرأَ عليها أيُّ تغيير، بل صارت حقلاً ديناميكيَّاً يتبدَّلُ فيه المخزون، بحسب تقادُمِ العهد واكتسابِ المعارف وتغيُّرِ السِّياقات؛ وفي كلِّ ذلك، يلعبُ الزَّمانُ دوراً أساسيَّاً في التَّأثيرِ على كلِّ أَثَرٍ حُفِظَ بالذَّاكرة، وفي تشكيلِ الهُويَّة الشَّخصيَّة، ومن ثمَّ في إعادة بناء الهُويَّة الوطنيَّة أوِ القوميَّة. إلَّا أنَّ الزَّمانَ ليس واحداً، بل هو كثير؛ كما أنَّ النَّظرَ إليه يتعدَّدُ بتعدُّدِ مواقعِ النَّاظرينَ إليه؛ فهو يُبطئُ بالسَّهلِ ويتسارَعُ على أعلى الجبل، وقد يُبطئُ في لحظاتِ الانتظار المُمِلَّة ويمضي كالسَّهمِ في اللَّحظاتِ المُفرِحة؛ وقد يتوقَّفُ تماماً إنِ اقترب من ثقوبٍ سوداءَ أوِ يختفي تماماً إنِ اختبأَ بداخلها. هذا ما توصَّلت إليه العلومُ الطَّبيعيَّة الحديثة؛ وقدِ انعكسَ كلُّ ذلك، بصورةٍ أو بأخرى، في الأبنية السَّردِيَّةِ المعاصرة؛ فلم يعُدِ الحكيُ فيها يتَّبِعُ مساراً خطِّيَّاً، كما في القصِّ التَّقليدي، بل صار هناك تقافُزاً من زمانٍ إلى آخر، فكأنَّ الزمانَ مُلتَحِمٌ بالمكان أو أنَّه موجودٌ مثله في اللَّحظةِ الحاضرة في كلِّ الأنحاء، مثلما هو الحال في الفهم القديم للحاضر الماثل للعيان وكأنَّه قائمٌ بالفعلِ في كلِّ الأرجاء. وقد تأثَّر الطَّيِّب صالح في سَردِه بالفهم المعاصر لمفهومَيِ الزَّمانِ والمكان، ولكنَّه لم يتخلَّ تماماً عن المسارِ الخطِّيِّ، بل بعَجَ له شكلاً جديداً يسمِحُ بحمايةِ النَّصِّ المنفرد من تأثيرِ أيِّ خَلجَلةٍ سرديَّةٍ محتملة على مستوى المتنِ الرِّوائيِّ بمُجملِه.
ولكن قبل توضيح هذا الشَّكلِ الجديد، علينا أن نُبيِّن أوَّلاً ماذا نعني بمصطلح “متن”، إذ إنَّ هذا المصطلح يتمُّ مقابلته كالمعتاد بمصطلح “هامش”؛ إلَّا أنَّ هذا المعنى ليس هو مقصودُ الدِّراساتِ النَّقديَّةِ الحديثة، إذ إنَّ مقصودَها أقربُ إلى فكرة “المجموعة” أوِ “الأعمالِ الكاملة”؛ وعليه يكونُ المتنُ الرِّوائيُّ للطَّيِّب صالح هو جميعُ أعمالِه الرِّوائيَّة؛ ولكن بما أنَّه قدِ اختارَ شكلاً تنمو فيه ذاتُ شخصيَّاتِه الرِّوائيَّة وتترعرعُ ضمن مكانٍ روائيٍّ واحد يُمكِنُ، كما فعل النُّقَّادُ وتبِعَهُمُ الكاتبُ نفسُه، أن نُطلِقَ عليه (أي هذا المكان) اسمَ “ود حامد”؛ وقد كان هذا المتنُ مفتوحاً على احتمالِ إنتاجِ رواياتٍ جديدة في إطارِه، كأن تكونَ هي “جبرُ الدَّار”، كما كان في تصوُّرِ الكاتب؛ وقد يظلُّ المتنُ مفتوحاً على المستوى النَّظريِّ، لأنَّ شخصيَّاتٍ مثل “الطِّريفي ود بكري” و”الطَّاهر ودَّ الرَّواسي” و”محيميد” و”بت مجذوب” و”محجوب النَّمِر”، وغيرِها كثير، تستحِقُّ تناولاً روائيَّاً منفرِدَاً ضمن المتنِ الرِّوائيِّ المفتوح. وهو المتنُ الَّذي تمَّ افتتاحُه باكراً بقصَّة “دومة ود حامد”، الَّتي صارت أساساً للحكِي على أساس القصِّ الخطِّيِّ: (كان يا ما كان في سالفِ العصرِ والأوان مكانٌ به دومةٌ لم يزرَعْها أحد) لِيتمَّ خلخلتُه سرديَّاً عبر رواياتٍ منفردة، يتطوَّرُ فيها المكانُ في مسيارٍ لا ينقطع.
ففي “دومة ود حامد”، تمَّ مُبكِّراً إنشاءُ خشبةِ المسرح الَّتي يتحرَّك فوقها شخوصُ المتنِ الرِّوائي؛ كما مهَّدَ عددٌ من القصصِ القصيرة لإرساءِ الخصائص الرَّئيسيَّة لتلك الشَّخصيَّات؛ فزواجُ مصطفى سعيد وجون موريس في “موسم الهجرة إلى الشَّمال” قد تمَّ الإرهاصُ به منذ قصَّة “رسالة إلى إيلين”: “إنَّك مهووسٌ. أنتَ أهوسُ رجلٍ على وجهِ البسيطة. ولكنَّني أُحِبُّكَ. إذا رأيتَ أن تتزوَّجني فأنتَ وشأنُكَ”؛ كما أنَّ “مكتب التسجيل في فولام” الَّذي تمَّ فيه الزَّواج يُشار إليهِ في قصَّة “خطوة إلى الأمام”؛ وذلك “الطَّيفُ السَّاخر” في عينَي “مصطفى سعيد” الَّذي يُكَذِّب كلَّ ما يقول، قد تمَّ الإشارةُ إليهِ مبكِّراً في قصَّة “هكذا يا سادتي”؛ أمَّا مكتبته في القريَّة، فقد تمَّ تَعدادُ مثيلٍ لمحتوياتِها في قصَّة “إذا جاءت”. إلَّا أنَّ الأهمَّ من كلِّ ذلك أنَّ علاقة الجَدِّ بالحفيد قد تمَّ الإرهاصُ بها منذُ قصَّة “حفنة تمر”: “لم أكُن أخرجُ أبداً مع أبي، ولكنَّ جَدِّي كان يأخُذُني معه حيثما ذهب”؛ وبما أنَّ الجَدَّ شخصٌ “عليمٌ بحَسَبِ كلِّ أحدٍ في البلدِ ونسَبِه، بل بأحسابٍ وأنسابٍ مبعثرةٍ قبلي وبحري، أعلى النَّهرِ وأسفلِه”، فقد استُخدِمَت معرفتُه بصلة القرابة كعمودٍ فقريٍّ للمتنِ الرِّوائي.
وهذا العمودُ الفقريُّ هو الَّذي أعطى للمتنِ قوامَه، وهو الَّذي مكَّن النُّصوصَ المنفردةَ من امتصاص الخلخلة السَّرديَّة والصُّمود أمام عاديات الزَّمن؛ ففي “دومة ود حامد” كان النَّاس يتنفَّسونَ برئةٍ اجتماعيَّةٍ واحدة، حيث كان الرَّاوي كبيرُ السِّنِّ يبدأ أحاديثَه بضميرِ المتكلِّمين: “نحنُ قومٌ”؛ وفي عرس الزِّين”، بدأ النَّاس في البلد ينقسمون إلى “معسكراتٍ واضحةِ المعالم إزاء الأمام”؛ وفي “موسم الهجرة”، يتمُّ التَّداخلُ بين الرَّاوي و”مصطفي سعيد” وتختلطُ أزمنةُ بقائهما في القرية وإنجلترا، إلى درجةٍ يصفها بول إستاركي من جامعة “دَرَم” بالاضطِّراب الزَّمني، إلَّا أنَّ قوَّة المتن تُكسِبُ العملَ المنفردَ سلاسةً تُذهِبُ عن القارئ أثر ذلك الاضطِّراب؛ وفي رواية “ضو البيت”، الَّذي تتمُ فيها إضاءةُ المتنِ بمُجمَلِه، يتمُّ لأوَّل مرَّة تسمِيةُ المكانِ الرِّوائيِّ بقرية “ود حامد”، بينما خلتِ النُّصوصُ المنفردةُ قبلها تماماً من هذا الاسم. وفي ود حامد، يرى الرَّاوي بأنْ لا تغييراتٍ ستجري في البلد، ومنها “مكنةُ الماء والمشروعُ الزِّراعيُّ ومحطَّةُ الباخرة”، إلَّا حينما يكثُرُ فيها “الفتيانُ الغرباءُ الرُّوح”؛ وفي “عرس الزَّين”، نعلمُ أنَّ الحكومة أقامت بالفعلِ مشروعاً زراعيَّاً كبيراً؛ وفي “ضوِّ البيت” (أو ضوِّ المتنِ الرِّوائيِّ المفتوح) تُصبِحُ البلدُ وكأنَّها مستعِدَّةٌ للتَّغيير، حيث أنَّ الطِّريفي ود بكري، الَّذي “كان في سَمتِه وطبعِه شيءٌ من سَمتِ الضَّبعِِ وطبعِه”، قد تمَّ انتخابُه رئيساً للجمعيَّة التَّعاونيَّة، وأنَّه أخيراً، فإنَّ “محجوب النَّمِر [قد]هزمته الضِّباع” هزيمةً مُنكَرَة.
ومنذُ الجُملةِ الافتتاحيَّة، تُعلِنُ رواية “بندر شاه- ضوِّ البيت” عنِ ارتباطها بما قبلها: “كان محجوبٌ مثل نَمِرٍ هَرِم، جالِساً جِلسَتِه القديمة”، إذ إنَّ محجوباً هو الشَّخصيَّة الرِّوائيَّة الَّتي تتقاسمُ مع الرَّاوي الموقع الثَّاني في كلٍّ من روايتَي “عرس الزَّين” و”موسم الهجرة”؛ وفي “بندرشاه-ضوِّ البيت”، يتمُّ أيضاً لأوَّلِ مرَّةٍ تسمِيةِ الرَّاوي باسم “محيميد”؛ وفي “مريود”، يروي الرَّاوي عن محيميد بلفظةِ ضميرِ الغائبِ المُفرَدِ “هو”، إشارةً إلى تماثُلِ الرَّاوي مع المرويِّ عنه: “محجوب وعبد الحفيظ والطَّاهر وسعيد وهو. يغمضُ عينيه. يراهم كما كانوا”. وفي “دومة ود حامد”، بعد حادثة الدَّومة وسَجنِ عشرينَ رجلاً وإطلاقِ سَراحِهِم فيما بعد، جاء إلى القريةِ “أُناسٌ نظيفو الثِّياب، تلمع على معاصمِهِم ساعاتٌ مذهَّبة وتفوحُ نواصيهم برائحةِ العطر”؛ وفي “موسم الهجرة”، نعلمُ أنَّ أولئك النَّاس هم “سادةُ إفريقيا الجدد، مُلسُ الوجوه، أفواهُهُم كأفواهِ الذِّئاب، تلمعُ في أيديهم خُتُمٌ من الحجارةِ الثَّمينة، وتفوحُ نواصيهم برائحةِ العطر”. وفي “بندرشاه”، نعلمُ أيضاً أنَّ الطِّريفي كان “في السَّادسة والثَّلاثين، أو السَّابعة والثَّلاثين، فقد كان في نحو الثَّانية عشرة، في عام عرس الزَّين. كان محجوبٌ في الخامسة والأربعين حينئذٍ.. وكان أحمد الَّذي أصبح الآنَ أباً لبناتٍ كثيرات، وبناتُهُ صرنَ للزَّواج، كان عامها (أي عام عرس الزَّين) في نحو العشرين.
كما نُخطَرُ، معشر القرَّاء، بأنَّ “عبد الكريم ود أحمد [أصبح] متصوِّفاً”، وأنَّ “سيف الدِّين قد أوشك أن [يُصبِحَ] نائباً في البرلمان”، وأنَّ “الزَّين أصبح من الأعيان”. فهكذا عن طريق تقنِياتِ القصِّ التَّقليديِّ يتمُّ حماية النُّصوص المنفردة من البَلبلةِ الَّتي قد تُحدِثُها الخلخلةُ السَّرديَّة أوِ “الاضطِّرابِ الزَّمني”، الَّذي أشار إليه بروفيسر إستاركي الأستاذُ الفخريُّ في قسم اللُّغة العربيَّة بجامعة دَرَم، على نطاقِ المتنِ الرِّوائيِّ المفتوح. ومن غرائبِ المفارقاتِ أنَّ ’موتيف‘ الفوضى في “بندرشاه” قد اُستُخدِمَ كلازِمةٍ متكرِّرة للنَّصِّ المنفرِد، ممَّا يمنحه ثباتاً إضافيَّاً يحميه، إلى جانبِ تقنِياتِ القصِّ التَّقليدي، من أثرِ اضطرابِ الأزمنة والخلخلةِ السَّرديَّة.