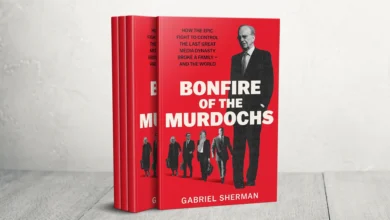وطنٌ يتآكل ونخبةٌ تكرّر الأخطاء: قراءة نقدية في أصل الداء

بقلم : محمد عمر شمينا
في مارس 2016، وقف الدكتور منصور خالد في النادي الدبلوماسي بالخرطوم ليقدّم ورقة لا تُشبه ما اشتهر به من سرديات وذكريات. لم تكن الورقة تأريخاً لحياة، ولا استعادة لمشاهد من الماضي، بل مواجهة فكرية جريئة مع جذر الأزمة السودانية، وتشريحاً لطبقات الفشل التي تراكمت فوق صدر الوطن حتى أثقلته. وعلى ضوء هذه الورقة تنعقد هذه القراءة التي تحاول الإمساك بما وراء الظاهر،لماذا يتآكل السودان بينما تصرّ نخبه، جيلاً بعد جيل، على الدوران في الدائرة ذاتها؟ ولماذا تبدو حرب اليوم امتداداً طبيعياً لمسار طويل أكثر من كونها مفاجأة؟
يبدأ الداء من النقطة التي ظل منصور خالد يرددها بلا مواربة غياب الرؤية. فمنذ لحظة الاستقلال، انشغلت النخبة بالسؤال الصاخب من يحكم السودان؟ بينما ظل السؤال الأعمق والأجدر بالطرح معلقاً في الهواء كيف تُعاد تأسيس الدولة؟ لم تتجه الإرادة السياسية يوماً نحو مشروع لإعادة بناء الدولة على تعاقد واضح يضمن إدارة واعية للتنوع الواسع الذي يميّز السودان، بل تُرك التنوع بلا إدارة، وبلا خيال سياسي قادر على تحويله من عبء إلى مصدر قوة. ومن هنا انفتح الباب لباكورة الإخفاقات المبكرة في الحياة السياسية السودانية.
ويشكّل مؤتمر المائدة المستديرة عام 1965 المثال الأكثر وضوحاً لهذا الانكسار. فالمؤتمر، الذي كان يمكن أن يكون لحظة تأسيس جديدة، تحوّل بسبب تعنّت النخب إلى فرصة ضائعة أخرى. لم تستطع القوى السياسية أن تتجاوز حساباتها الصغيرة لتصل إلى رؤية مشتركة حول معالجة أزمة الجنوب، فانتهى المؤتمر إلى خلافات داخلية عقيمة، أعقبها تشكيل لجنة الاثني عشر، التي ورثت الخلاف بدلاً من أن تحله. وهكذا ضاعت آخر محاولة جادة لاحتواء الأزمة، ليتحول الفشل في إدارة التنوع إلى الشرارة الأولى التي مهّدت للحروب المتعاقبة، ولانزلاق البلاد إلى دوامة من النزاعات التي ما تزال تتوالد حتى اللحظة. بهذا المعنى، لم يكن غياب الرؤية مجرد نقص فكري، بل غياباً لمشروع إعادة بناء الدولة نفسها، بما يجعل الحرب الراهنة امتداداً طبيعياً لهذا الفشل المتراكم لا حدثاً منفصلاً عنه.
وإذا كان فقدان الرؤية أصل العلة، فإن الأيديولوجيا كانت وقودها. فاليساري ظل يطارد شبح الإمبريالية، والإسلامي انشغل ببناء دولة العقيدة، والقومي حلم بوحدة تمتد من البحر إلى البحر، والأفريقاني سعى إلى نزع كل ما هو عربي عن هوية السودان. مشاريع كبرى، مُستعارة في معظمها، لم تطرح على نفسها السؤال البدهي ماذا يحتاج السودان الآن؟ وهكذا تحوّل الوطن إلى مختبر تجارب كبرى، بينما كانت أزماته اليومية من التعليم إلى الخدمات إلى التماسك الاجتماعي تزداد تعقيداً، حتى أصبحت اليوم وقوداً لحرب لا يعرف أطرافها ما الذي يريدونه حقاً، سوى ألا ينتصر الطرف الآخر.
ويشير منصور خالد إلى أن إنكار الذات، بقدر ما هو عيب أخلاقي، فإن أثره السياسي أشد وطأة. فقد رفضت النخبة الاعتراف بخطيئة تجاهل أزمة الجنوب، وخطيئة إلغاء اتفاقية أديس أبابا، وخطيئة عسكرة الدولة وتسييس الخدمة المدنية، وخطيئة احتقار التنوع وإلغاء الآخر. لم يعترف أحد بذلك حين كان الاعتراف ممكناً، وها هي الحرب الحالية تذكّر الجميع بأن التاريخ لا يصفح حين تُهدر دروسه، وأن الخطأ الذي لا يُعترف به يعود في صورة كارثة أعنف.
وفي قلب هذا الانهيار المؤسسي تتبدّى ظاهرة يعرفها التاريخ جيداً، تكاد تشبه قانوناً من قوانين الطبيعة،حين تخفت ظلال الدولة، يهرع الإنسان إلى أول ظل يصادفه. وحين تنكسر يد القانون، يمدّ يده إلى الدم والقرابة. فالفراغ الذي تتركه الدولة لا يبقى فراغاً،سرعان ما تملؤه العصبيات القديمة، تعود مثل رِمّةٍ جافة تنتظر قطرة خوف لتنهض. وحين لا تكون هناك دولة، لا يلجأ المرء إلى القبيلة حباً فيها، بل اتقاءً لوحشة العالم من دونها تماماً كما يعود المسافر إلى أقرب ضوء حين تنطفئ كل الأنوار التي يعرفها. وفي مثل هذه اللحظات ينقلب ميزان الانتماء،يصبح الوطن احتمالاً بعيداً، وتغدو القبيلة حقيقة يومية، تمدّ خيمتها فوق الحاجة، وتقول للمرء،أنا هنا إن خذلك الآخرون. وهكذا ينحدر المجتمع من فضاء الدولة إلى ضيق القبيلة، ومن سعة حكم القانون إلى غوغاء الحماية الغريزية، ومن فكرة الوطن إلى ملاذ الخوف. وما كان ينبغي أن يبقى في ذمة الماضي يعود ليتقدّم الصفوف، لا لأنه أصلب، بل لأن الدولة التي كان يجب أن تكون أكبر منه انسحبت من مكانها.
وتضاعفت حدة الأزمة لأن السياسة نفسها انحدرت منذ زمن بعيد إلى مستوى الخصومة الشخصية. فبدلاً من أن تكون السياسة حواراً حول البرامج، تحولت إلى ساحة اشتباك بين الأشخاص، تتبدل فيها الاختلافات إلى تخوين، والرؤى المختلفة إلى تهم جاهزة. وفي الحرب الراهنة يتكرر المشهد ذاته، حيث يغيب النقاش حول مستقبل الدولة، وتحضر لغة الاتهام والانتقام، وكأن البلاد تعيد إنتاج ذاتها داخل دائرة مغلقة لا ترى نهاية.
وكشفت الورقة حجم الانهيار في التعليم والصحة والخدمات والهجرة والفساد، وهو انهيار جعل المجتمع هشّاً أمام الحرب. فحين يتفكك التعليم، وتتراجع الصحة، ويغيب حكم القانون، وتتهاوى مؤسسات الخدمة المدنية، يصبح المجتمع بلا حصانة، وتصبح الحرب قادرة على ابتلاع ما تبقّى من تماسكه. لم تكن الحرب التي نعيشها اليوم حالة استثنائية، بل نتيجة منطقية لسلسلة طويلة من الإهمال والإنكار وتراجع الدولة.
ويرى منصور خالد أن النواقص الذاتية للنخبة هي المرض المستتر الذي يفسّر جانباً كبيراً من هذا الفشل، تضخم الذات، الغيرة الجيلية، تقديس الماضي، ضيق الصدر تجاه النقد، كراهية الآخر، وتحويل الولاء الحزبي أو القبلي إلى معيار للترقي. هذه ليست مجرد عيوب فردية، بل مزاج عام حكم العقل السياسي السوداني وظهر اليوم في أكثر أشكاله فجاجة، حين بات كل طرف يرى نفسه المخلّص الوحيد، ويرى الآخرين خطراً وجودياً لا اختلافاً سياسياً.
ورغم هذا المشهد الداكن، لا يغيب الأمل. فجيل الشباب الذي أشار إليه منصور خالد الجيل الرقمي، النقدي، المتجاوز للمسلمات هو اليوم الأكثر تضرراً من الحرب، لكنه أيضاً الأكثر قدرة على صياغة مستقبل مختلف. هذا الجيل لا يرى السياسة كخصومة، ولا الوطن كغنيمة، ولا يقبل بإعادة تدوير الفشل القديم. وهو يدرك، بحكم تجربته ووعيه الجديد، أن السودان لا يمكن أن يُبنى بالأدوات ذاتها التي هدمته.
وبعد هذه القراءة، ومع استحضار الحرب الحالية، يمكن القول إن السودان لم يفشل لأن شعبه فشل، بل لأن نخبه رفضت رؤية نفسها. الحرب ليست بداية الفشل، بل نتيجته الطبيعية. ولن ينهض السودان ما لم يحدث اعتراف شجاع بالأخطاء، ونقد ذاتي بلا تبرير، وانتقال سلس للقيادة إلى جيل جديد، ووضع الوطن فوق الأيديولوجيا، والعودة إلى بناء المؤسسات لا بناء الزعامات. حينها فقط يمكن لهذا الوطن أن يتوقف عن التآكل، وأن يبدأ رحلة التعافي من حرب اليوم، لا باعتبارها نهاية، بل بداية لإعادة التأسيس.