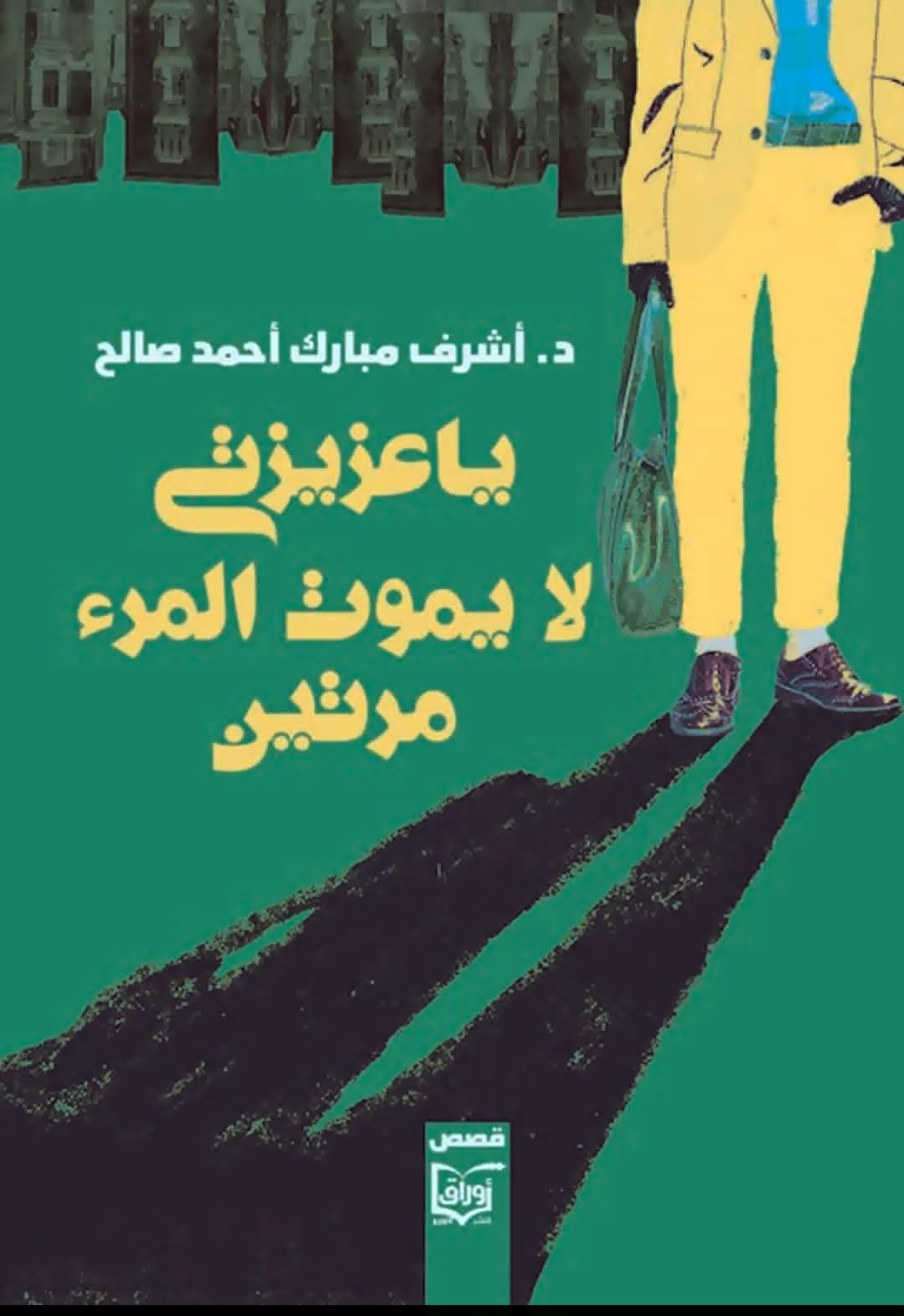بالكتابة نؤجل الهزيمة قليلاً ..
:لا يمكن الكتابة بلا موقف إنساني الحياد وهم.
:الطب يعالج الجسد، والأدب يحاول فهم الروح.
د. أشرف مبارك كاتب سوداني وطبيب، أحب الكتابة منذ الصغر، منذ المرحلة المتوسطة، وقد وجد التشجيع والدعم من والده الكاتب والأديب والسياسي مبارك أحمد صالح، المحامي، رحمه الله، كما وجده من أساتذته الذين كان منهم أدباء وكتاب وشعراء معروفون. نشر قصصه في الصحف اليومية في فترة التسعينيات وبداية الألفينات، وكذلك في مجلة الخرطوم التي كانت تصدر عن الهيئة القومية للثقافة والفنون في تسعينيات القرن الماضي.
صدرت له مجموعة قصصية بعنوان (رجال مجنحون) عن دار عزة للنشر والتوزيع.
وكذلك، وبسبب ظروف اغترابه وعمله خارج السودان (بالسعودية)، وُفِّق إلى طباعة مجموعته الثانية (يا عزيزتي لا يموت المرء مرتين) عن دار أوراق للنشر والتوزيع في القاهرة، وشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام.
في هذا الحوار نقترب من تجربته الكتابية والحياتية.
حوار: محمد إسماعيل
- عرفنا عن نفسك: مكان الولادة، الجو العائلي، المحفزات الأدبية في الطفولة، وكيف تشكّل عالمك القصصي؟ وما أهم المؤثرات التي صقلت تجربتك الأدبية؟
وُلدت في حي بيت المال بأم درمان، في بيئة تتداخل فيها الحكاية اليومية مع الذاكرة الشعبية، حيث كان البيت ممتلئاً بالكلمات قبل الكتب، والسياسة قبل الخبز. الجو العائلي لعب دوراً محورياً؛ النقاشات، السياسة، السرد الشفاهي، والحكايات التي تُقال أكثر مما تُكتب. في طفولتنا لم تكن القراءة ترفاً، بل نافذة لفهم العالم، ومع الوقت صار القص وسيلتي الخاصة لإعادة ترتيب هذا العالم.
تأثرت بالتراث الشفاهي السوداني، وبالواقعية الإنسانية، وبكتّاب جعلوا من الإنسان العادي بطلاً خفياً لنصوصهم. من الروس، خاصة تشيخوف ودوستويفسكي، تعلّمت الإصغاء للهامشي واليومي، ومن الأمريكيين مثل همنغواي دقة التفاصيل واقتصاد اللغة، ومن كتّاب عرب مثل يوسف إدريس، والطيب صالح، وغسان كنفاني، تشكّل وعيي بالسرد بوصفه فعل معرفة ومساءلة.
. يتوزع مشروعك الإبداعي بين القصة والشعر، ما سر هذا التوفيق؟
لا أتعامل مع الأجناس الأدبية كحدود صلبة. أكتب القصة حين أحتاج إلى الامتداد، وألجأ للشعر حين تكون الحاجة للإقتصاد ولا تحتمل السرد. التوفيق بينهما ليس قراراً واعياً، بل استجابة لحاجة داخلية، فبعض التجارب لا تُقال إلا مكثفة، وبعضها لا تكون إلا بالحكي.
. في مجموعتك القصصية “يا عزيزتي لا يموت المرء مرتين” يتقاطع الشعر مع القصة، هل هو جنس جديد؟ وما أبرز القضايا التي ركزت عليها؟
لم يكن تداخل الشعر مع القصة سعياً لابتداع جنس أدبي جديد بالمعنى الاصطلاحي، بقدر ما هو انحياز واع إلى منطقة التماس بين السرد والشعر؛ تلك المنطقة التي تصبح فيها القصة منشغلة بالحكاية الخالصة، وملتفتة إلى لغة فيها الإيقاع، والصورة، والكثافة الدلالية.
الشعر هنا ليس زينة لغوية، ولا استعارة فائضة، بل هو أداة سرد يشتغل على تعميق اللحظة، وتكثيف الإحساس، وفتح النص على ما لا يُقال مباشرة. لا أسعى لتأسيس جنس جديد بقدر ما أبحث عن شكل يليق بالتجربة. التعبير الشعري ليس زينة لغوية، بل ضرورة تعبيرية. ركزت المجموعة على الذاكرة والحنين: بوصفهما ساحة صراع بين ما كان وما لم يعد ممكناً، وبين ما نحتفظ به وما يخذلنا حين نستدعيه. الفقد، الإنسان وهو يواجه الفقد، والانكسار، والخذلان، لا في لحظاتها الصاخبة بل في تفاصيلها اليومية الصامتة. المنفى، الخسارات الصغيرة التي لا تُدوَّن، وعلى سؤال: كيف يموت الإنسان معنوياً قبل أن يموت جسدياً؟ ليس الموت الفيزيائي وحده، بل الموت المعنوي، موت الأمل، والعلاقات، والأوطان في الذاكرة. و الموت الذي يتكرر في الداخل.
. لماذا الإقبال على القصة والرواية بالدرجة الأولى مقارنة بالشعر والفن التشكيلي؟
لأن السرد أقدر على احتواء التعقيد الاجتماعي والسياسي والإنساني الذي نعيشه. القصة والرواية تمنحان مساحة للتفاصيل، للتناقض، وللأسئلة المفتوحة، بينما الشعر عندي لحظة كثافة لا مشروع إقامة طويل.
أمّا الفن التشكيلي، فهو عندي تأمل صامت للعالم، يختصر ما تعجز اللغة أحيانًا عن قوله، لكنه يظل بالنسبة لي لغة شديدة الخصوصية ومساحة للتلقي والانبهار أكثر من كونه حقل ممارسة إبداعية في الأخذ والرد والتفصيل.
. أيهما تفضل أكثر ، الكاتب الذي يستقي شخوصه من الواقع المعاش أم الخيال ؟
أين يبدأ الخيال وينتهى فى عالمك الإبداعى؟
لا أؤمن بالفصل بينهما. الواقع هو المادة الخام، والخيال هو طريقة إعادة ترتيبها. الخيال يبدأ حين تعجز الذاكرة عن الاحتمال، وينتهي حين يصبح النص صادقا حتى لو كان مختلقا.
. نلحظ في قصصك ميلا نحو السرد الواقعى؟
أظن لأنني منحاز للهم الانساني واليومي، لما يبدو عابرا لكنه عميق الأثر. العنوان الواقعي ليس تقريرا، بل طُعما يدخل القارئ إلى منطقة تأمل أعمق مما يوحي به الاسم.
. تشكيل شخوصك القصصية وتحديد سماتها . هنالك هوس بوصف المكان. اين هو ذلك المكان في ذاكرتك ؟
المكان عندي ليس جغرافيا فقط، بل شعور. هو الحي، البيت، المستشفى، المقهى، الوطن وهو يتغير. المكان مخزن الذاكرة، وكل شخصية تحمل جزءا منه.
“والليل مكان
الوقت مكان
في نفس اللحظة في كرة الأرض وقتان
ليل في الشرق
وصبح في الغرب”
(من قصيدة يوميات الحلم المنفي)
.في مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر التجارب القصصية التي تفتقر إلى الإبداع على أنها أدب مقروء مقيَّم له جمهوره..
ما رأيك؟
هي ظاهرة طبيعية في زمن الإتاحة المفتوحة. المشكلة ليست في النشر، بل في غياب الفرز والفرز النقدي لتمحيص الجيد من الغث ليعرض للجمهور. ولكن الإبداع الحقيقي سيبقى، أما النصوص الهشة فمصيرها الزوال مع الزمن.
.وهو ما يدعونا للسؤال ..هل الشعر فى تراجع امام السرد الروائى والقصصى؟
الشعر لا يتراجع، لكنه يمر بتحولات. السرد أصبح أكثر قدرة على تمثيل اللحظة العربية المعقدة، لكن الشعر سيظل فن المقاومة الداخلية.
. من هم الأشخاص الذين أثروا في حياتك الأدبية؟
الأسرة أولا. والدي مبارك أحمد صالح رحمه الله، وكان محاميا وكاتبا وشاعرا وقاصا، عرفته صحفنا مثل الأيام والسياسة والميدان، ومجلة الحياة، ولا يزال كتابه يوميات معتقل سياسي من الأعمال التي أتمنى إعادة نشرها، إلى جانب مجموعاته القصصية والشعرية ومقالاته في الشأنين القانوني والعام.
عمي حيدر، الذي له إسهام كبير في توثيق أدب المدائح عبر تلفزيون الجزيرة، وجدي أحمد الزبير، صاحب أول برنامج للمنوعات في الإذاعة السودانية “أشكال وألوان” والذي عبره عرف الناس الكثير من المغنيين الكبار.
ثم الأساتذة مثل مهدي محمد سعيد وعبد المنعم الكتيابي، بما قدماه من معرفة وانضباط فكري، والأصدقاء، وهم كُثر لا يسعهم هذا المقام. ولا أنسى الكتّاب الذين قرأت لهم بعمق، وأولئك المجهولين الذين قابلتهم في الحياة وتركوا أثرهم في داخلي دون أن يدروا.
. هل تؤمن بأن الأدب قادر على المساهمة في صناعة رأي عام . ؟
ليس بشكل مباشر، لكنه يزرع الأسئلة، ويزعزع اليقينيات، وهذا أخطر وأعمق من الخطاب المباشر.
. هل يمكن الكتابة بعيدا عن الأيديولوجيا؟
يمكن تجاوز الشعارات، لكن لا يمكن الكتابة بلا موقف إنساني. الحياد الكامل وهم.
. ماذا عن والدك الكاتب والسياسي مبارك أحمد صالح؟
كان مدرسة في الفكر والاستقامة، ترك أثرا إنسانيا قبل أن يكون أدبيا أو سياسيا. عرفته المحافل الأدبية والسياسية وتلقفته المعتقلات عندما كانت الأنظمة تخشى الرأي وترعبها الكلمة. حضوره في حياتي كان محفزا ومسؤولية في آن واحد. علمني أن الكلمة شرف وموقف وأن الأدب لا ينفصل عن الناس.
. ماذا عن مجموعتك «رجال مجنحون»؟
هي تجربتي الأولى في النشر، وفيها ملامح التكوين، أسئلة الإنسان البسيط، ومحاولات الإمساك باللحظة الإنسانية في هشاشتها.
. أنت طبيب، ما المشترك بين الطب والأدب؟
كلاهما اشتباك مع الألم. الطب يعالج الجسد، والأدب يحاول فهم الروح. وكما عرفت نفسي مرة بأنني طبيب أداوي أمراض الصدور وكاتب يفتش في الصدور المعنى.
ـ التجارب السياسية القاسية فى المجتمعات العربية تتحول الى سردية كبرى شهدت الرواية العربية نماذج بارزة. غير أن التجربة السودانية بما تنطوي على حروب وانقسامت حادة .في لقاء معك في إحدى الصحف قلت إن غياب المشروع الروائى والقصصى السوداني واسع الحضور .مالذى أعاق هذا المشروع انتشاره عربيا؟
لأسباب تتعلق بالتهميش، وضعف النشر، وغياب المؤسسات الداعمة، رغم غنى التجربة السودانية وتعقيدها.
الأسباب مركبة تتعلق بالتهميش الثقافي، وضعف حركة النشر والتوزيع، وغياب المؤسسات الداعمة والمشاريع الثقافية المستدامة، رغم الغنى الهائل والتعقيد الإنساني للتجربة السودانية. يضاف إلى ذلك ضعف الترجمة، ومحدودية الحضور الإعلامي العربي، وانشغال الكاتب السوداني غالبا بأسئلة البقاء اليومي أكثر من الانخراط في سوق ثقافية عربية غير عادلة في فرصها. لذلك ظل السرد السوداني حاضرا بقوة في جوهره، لكنه غائب في تمثيله وانتشاره.
– كتبت عن بدر شاكر السيّاب وأمل دنقل هل كان خيارا نقديا محايدا، أم جاءت بوصفها استجابة لتجربة قراءة مبكرة شكّلت وعييك بالشعر الحديث؟
لم يكن خيارا نقديا محايدا محضا، بقدر ما كان استجابة لتجربة قراءة مبكرة ومؤثرة. السيّاب ودنقل شكلا لحظتين مفصليتين في وعيي بالشعر الحديث. الأول علّمني كيف يمكن للشعر أن يكون سيرة ذاتية جماعية، والثاني كشف لي كيف تتحول القصيدة إلى موقف أخلاقي. الكتابة عنهما كانت محاولة لفهم الأثر الذي تركاه في داخلي قبل أن تكون حكما نقديا عليهما.
– هل ما زالت للكتابة القصصية ذات المكانة. التي كانت لها قديما لدى الكاتب القاص وقارئ القصة؟
في زمن الموبايل والكمبيوتر المحمول والفيديو والتسجيل الصوتي السريع والسهل الكتابة القصصية لم تفقد مكانتها، لكنها فقدت بعض ألقها المؤسسي. لم تعد القصة القصيرة في صدارة المشهد كما كانت، لكنها ما زالت الفن الأكثر قدرة على التقاط اللحظة الإنسانية المكثفة. القارئ الحقيقي للقصة لم يختف، بل صار أكثر انتقائية، وربما أكثر صمتا. وربما هذا الصمت نفسه هو علامة الوفاء الأخيرة لهذا الفن.
حدثنا عن معناتك ككاتب ومثقف سوداني في ظل هذه الحرب التي يعيشها الوطن؟
الكتابة في زمن الحرب فعل مقاومة. أن تكتب يعني أن ترفض الصمت، وأن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المعنى.
الحرب لم تترك للمثقف ترف المسافة. صارت الكتابة مجاورة للخسارة، ومشبعة بالقلق، لكنها أيضا محاولة للتشبث بالمعنى في وطن يتفكك أمام أعيننا.
المعاناة تبدأ من الإحساس بالعجز أمام حجم الخراب، ومن ثقل الكتابة في زمن يبدو فيه الكلام أقل من الواقع. أجد نفسي ممزقا بين واجب الشهادة، وبين الخوف من أن تتحول الكتابة إلى اعتياد على الألم. الحرب كسرت الإيقاع الطبيعي للحياة، ووضعت الكاتب أمام أسئلة أخلاقية قاسية: متى يكتب؟ وكيف؟ ولمن؟ ومع ذلك، تظل الكتابة بالنسبة لي فعل مقاومة هادئة، ومحاولة للحفاظ على ما تبقى من إنسانيتنا، وتوثيق ما لا يجب أن يُنسى.
– كيف أثرت ثورة ديسمبر والحرب على منتوجك الإبداعي؟
ثورة ديسمبر أعادت لي الإيمان بقدرة الإنسان العادي على صناعة المعنى، ودفعتني إلى كتابة أكثر انحيازا للأسئلة الكبرى دون الوقوع في المباشرة. أما الحرب، فقد جاءت كجرح مفتوح؛ جعلت الكتابة أكثر وجعا، وأقل يقينا، وأقرب إلى الشهادة. في الحالتين، لم تعد الكتابة ترفا، بل ضرورة أخلاقية.
. هل من كلمة أخيرة؟
أؤمن بأن الأدب، في جوهره، محاولة لإنقاذ الإنسان من النسيان. وربما كل ما نفعله بالكتابة هو أن نؤجل الهزيمة قليلا، ونمنح المعنى فرصة أخيرة للبقاء.