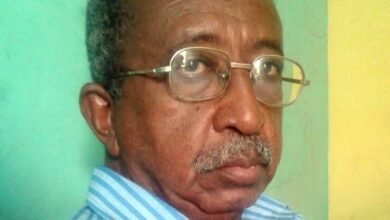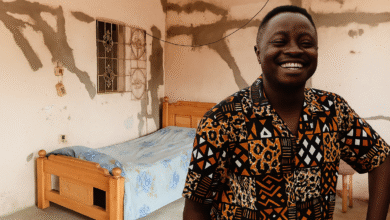المسرح السوداني.. فترة التأسيس:
السر السيد
كأي ظاهرة ثقافية كانت للمسرح السوداني بدايات تطور من خلالها وصولًا إلى ما يمكن وصفه بفترة التأسيس، وهي الفترة التي نحن بصدد الكتابة عنها.
يمكن اعتبار الفترة الممتدة من 1967م تاريخ إنشاء المسرح القومي وما بعدها هي فترة التأسيس وفترة العمل على توطين المسرح في الحياة السودانية، فقد شهدت هذه الفترة بداية ما عرف بالمواسم المسرحية المنتظمة، التي عنت فيما عنت أن المسرح أصبح يقع تحت رعاية الدولة بعد أن كان في الفترات السابقة نشاطًا يرعاه المجتمع، فقد أصبح محكومًا “بميزانيات ونظم رقابية وتقسيمات وظيفية”. أيضًا تم إنشاء عدد من المسارح في مدن السودان الكبرى.
لقد رأت عبقرية الرائد المسرحي الفكي عبد الرحمن، مدير المسرح القومي في ذلك الوقت، وأول من ابتدع فكرة الموسم المسرحي، أن يأتي برموز بدايات التأسيس في الثلاثينيات كالكاتبين المؤسسين خالد أبو الروس وإبراهيم العبادي، وبرموز الخمسينيات وبدايات الستينيات كالأستاذ الفاضل سعيد، وذلك عندما تم عرض مسرحيات ” المك نمر” للعبادي و”إبليس” لأبو الروس و”أكل عيش” للفاضل سعيد، في الموسم المسرحي الأول 1967-1968، وأكثر من ذلك فقد عملت المواسم المسرحية بعد ذلك على إتاحة الفرص للفرق المسرحية الطليعية كجماعة المسرح الجامعي “جامعة الخرطوم”، التي قدمت مسرحيات، “مأساة الحلاج” و”ماراصاد” و”حفل سمر من أجل 5 حزيران”، وهنا يقول البروفيسور سعد يوسف في كتابه “أوراق في قضايا الدراما السودانية”: (خلال نهضة الستينيات والسبعينيات انفتح الباب على مصراعيه لتقديم ألوان مختلفة من العروض المسرحية، فكانت مواسم المسرح القومي الأولى تجميعاً لبعض عروض الثلاثينيات ومسرح الكوميديا جنباً إلى جنب مع اتجاهات الواقعية وألوان المسرح المعاصر).
إن إنشاء المسرح القومي وبداية مواسمه في عام 1967م هو ما شكل أساس النهضة المسرحية مستقبلاً، فعبر هذه المواسم بدأ حضور المرأة واضحاً خاصة في مجال التمثيل، كما شهد العرض المسرحي تطوراً في شكله بمساهمات خريجي كلية الفنون الجميلة والتطبيقية، “صالح الأمين، صلاح تركاب، الطيب الشيخ وغيرهم” الذين تم استيعابهم في مؤسسة المسرح القومي، إضافة إلى المساهمات النوعية التي قدمها الذين ابتعثهم المسرح القومي بمختلف تخصصات فن المسرح إلى مصر وغيرها.. باختصار لقد شكل المسرح القومي أساساً متيناً للنهضة المسرحية في السودان فهو من فتحها على تجارب المسرح المختلفة والمتنوعة إقليمياً ودولياً. أيضاً شهدت هذه الفترة إنشاء معهد الموسيقى والمسرح 1969م الذي تطور مع الأيام ليصبح كلية الموسيقى والدراما بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مشكلاً خطوة متقدمة في تأسيس المسرح وتوطينه، كما شهدت هذه الفترة انتخاب أول لجنة تنفيذية لاتحاد الممثلين السودانيين عام 1975 كما أفادني الأستاذ علي مهدي، وكذلك افتتاح أول مسرح في السودان على مواصفات عالمية هو مسرح قاعة الصداقة بالخرطوم 1976م، كما تم افتتاح قصر الشباب والأطفال الذي أصبح مسرحه فيما بعد متنفساً للنشاط المسرحي الشبابي خاصة عندما بدأت فيه كورسات الدراما عام 1977م، وأُنشئت كذلك مراكز للشباب في مختلف ولايات السودان بدءًا من العام 1974م، وأتاحت هذه المراكز فرصاً مقدرة لهواة المسرح (كما تم إنشاء قسم خاص بالدراسات المسرحية بمعهد الدراسات الإضافية بجامعة الخرطوم عام 1983م، الذي كان من أهدافه المساهمة في خلق جيل واعٍ يتمتع بالعلم والمعرفة والإلمام بفن المسرح والدراما، حسب إشارة الأستاذ عبدالله الميري في كتابه “المسرح في السودان-أوراق للذاكرة”.
في مطلع التسعينيات شهدت هذه الفترة وبمبادرة ومثابرة من الفنان الكبير محمد شريف علي إنشاء “المسرح الأهلي بأمبدة”، وهو مسرح خاص مما يعد خطوة كبيرة في توزيع الإبداعات المسرحية، وتمكين أكبر قاعدة من الناس في التمتع بها والاستفادة منها. وهكذا يتسع الحراك وتتسع دائرة الاهتمام بالمسرح في هذه الفترة رسمياً وشعبياً، فيظهر القطاع الخاص وينشط في العمل المسرحي في مطلع الثمانينيات، وتظهر الفرق والجماعات المسرحية التي وصل عددها في بعض الأحيان ما يفوق الثلاثين فرقة وجماعة مسرحية، وتظهر مهرجانات المسرح في العام 1990م عندما أقام اتحاد الممثلين السودانيين أول مهرجان مسرحي في السودان هو مهرجان “الفرق والجماعات المسرحية”، وتظهر مختلف الدراسات والبحوث والكتب في المسرح السوداني، ويبدأ الكتاب المسرحي السوداني في الظهور منذ منتصف التسعينيات، كما تزداد مشاركات السودان في المهرجانات العربية والأفريقية إلا أن أهم ما شهدته هذه الفترة هو ظهور الأسئلة المركزية ذات الطابع المعرفي حول هوية المسرح السوداني، التي تمخضت في الدعوة لمسرح سوداني يقوم على موروثات الفرجة في الثقافات السودانية، كدعوة د. يوسف عيدابي المعروفة بـ”مسرح لعموم السودان”.. هذه الأسئلة التي استنبطت أسئلةً حول التجريب في المسرح وحدوده، وحول وضعية العرض المسرحي السوداني، وحول موقع الجمهور في العملية المسرحية وغيرها من الأسئلة.
نشير إلى أن فترة التأسيس هذه وما صحبها من نهضة مسرحية لم تكن على سوية واحدة وهي تسعى لتوطين وتمكين المسرح في الحياة السودانية، لا على مستوى العرض ولا على مستوى التنظير ولا على مستوى السياسات التي حكمت المسرح، شأنها كأي ظاهرة مجتمعية بالضرورة محكومة بالشروط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تحيط بها، ومحكومة بشرطها الخاص المتمثل في وضع الظاهرة نفسها من حيث الموقع الذي يحتله المسرح ويحتله المسرحي في اللحظة التاريخية المعينة وهو موقع بالضرورة قابل للمد والجزر.
من هذه الفترة نستخلص الآتي:
1) تحول المسرح من حالة كونه نشاطاً أهلياً تدعمه مؤسسات المجتمع إلى نشاط مؤسسي تدعمه وترعاه وتراقبه الدولة.
2) اتساع دائرة العمل المسرحي ليشمل العاصمة ومدن السودان المختلفة.
3) التحول النوعي في مهمة المسرح ودوره، فلم يعد منحصراً في دعم الأعمال الخيرية وموضوعات التعبئة، بل تعداهما ليعبّر عن مجمل قضايا اجتماعية ووجودية وفكرية ومعرفية.
4) تحوّل من حالة كونه فعلاً يقوم به الهواة ومحبو المسرح إلى علم تنشأ له المؤسسات الأكاديمية.
5) انفتح المسرح بصورة لم تكن موجودة في الفترات السابقة على تيارات المسرح العالمي المختلفة، فقد عرفت التجربة المسرحية السودانية، مسرح الشارع والمسرح الوثائقي والمسرح الاحتفالي ومسرح المقهورين وغيرها من الاتجاهات والتيارات.
6) تصعيد الأسئلة المركزية حول هوية المسرح السوداني ووضعيته في سياق التجربة الإقليمية والدولية.