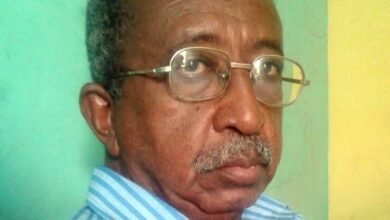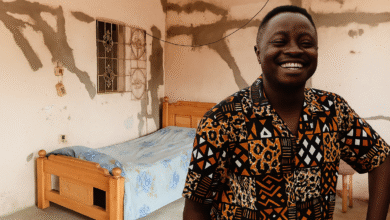(المسرح من أجل الحياة)

مقابلة مع المخرج ربيع يوسف الحسن
المسرح التفاعلي واحد من أهم الخيارات المناسبة لجمهورنا
لم يعد هناك مركز وهامش كلنا أصبحنا أطرافًا مجروحةً
واجهنا تحدي التصديق من جهات أمنية
لا مستقبل ولا بناء لحركة مسرحية إن لم نرد الاعتبار لهذا التنوع الإثني والثقافي
محمد إسماعيل – أفق جديد
وصف الممثل محمد نصر الدين الشهير بـ”ود الوجيه”، المخرج ربيع يوسف بالملهم القدوة، حيث استطاع من داخل مركز إيواء تنفيذ عدد من المسرحيات.
ربيع يوسف الحسن :
مخرج وناقد مسرحي قدم الكثير من العروض المسرحية داخل معظم مدن وقرى السودان، وله العديد من المشاركات المسرحية الدولية التي حصد فيها الجوائز، لكن سيرة ربيع الحسن المهنية لا تقتصر على صناعته وتجويده لعروضه المسرحية أو كتابته النقدية في الصحف والمجلات والمنصات السودانية والعربية، وإنما هو أحد أهم المسرحيين أصحاب المساهمات والمواقف في الشأن العام المسرحي، فهو مشغول بـ سوسيولوجيا المهن بقدر انشغاله بمشروعه الإبداعي، يأتي حوارنا معه هذه المرة لتغطية سيرة مهنية كبيرة راكمها وطورها أثناء نزوحه الطويل طيلة هذه الحرب.. إلى مداخل الحوار :
* حدثنا عن تجربتك في المسرح التفاعلي داخل الولايات المتأثرة بالحرب؟
أنا نزحت بداية الى ولاية الجزيرة التي كانت وقتها غير متأثرة بشكل مباشر بالنزاع إلا بقدر تَأَثُر كل إنسان السودان بما جرى ويجري في عاصمته المثلثة، حيث نتجت آثار جديدة على كل ولايات السودان باعتبارها ولايات لزم على إنسانها أن يقاسم موارده وخدماته – المحدودة – النازحين من العاصمة، وهنا بدأت تنشأ أزمات إجتماعية واقتصادية رمت بظلالها على البنية النفسية للنازح والمجتمع المستضيف على حد سواء، نسبة لهذا الواقع الجديد شرعنا في طرح الأسئلة التي يجب أن يقاربها المسرح، أي مسرح الذي يفرضه هذا الواقع؟
وإجابة هذا السؤال فجرتها حقيقة أننا كمسرحيين لسنا استثناءً من باقي قطاعات المجتمع الأخرى، وأننا قبل أن نؤثر ونتدخل على هذا الواقع إنما يؤثر ويتدخل في حياتنا هذا الواقع، وأبلغ وأفدح تأثيراته وتدخلاته علينا هي فقدنا لهويتنا المهنية والإبداعية تلك التي كانت متعينة في واقع وجغرافيا الاستقرار لا النزوح.
بعد هذه المقدمات الضرورية أقول لك إن إجابتي المباشرة لسؤالك هي أن تجربتي في ولاية الجزيرة وولاية البحر الأحمر بعد أن نزحت إليها، تمحورت بداية في الحفاظ على هويتي المهنية والإبداعية (هويتي المسرحية)، لعدد من الأسباب أولها حتى لا أكون عبئا اقتصادياً واجتماعياً على من استضافني في تلك الولايات، بمعنى إنني انشغلت بالسؤال التاريخي بالنسبة لنا نحن مسرحيّو السودان وأعني: كيف للمسرح أن يشكل مورداً اقتصادياً لممارسيه وللمجتمع؟
ولمقاربة هذا السؤال شرعت وزملائي من مسرحي النزوح ومسرحي مدني في تصميم وصناعة عروض تجتذب رؤوس الأموال من منظمات المجتمع المدني، تلك التي تعمل على درء آثار الحرب والنزوح من انتشار لخطاب الكراهية، وتضاعف العنف على النساء والأطفال وتدهور البنية النفسية، وتهديد لحمة النسيج الاجتماعي، وغير ذلك من قضايا تعمل المنظمات على معالجتها.
وبما أن المجتمعات المستهدفة من قبلنا ومن قبل شركائنا من المنظمات إنما هي مجتمعات بمراكز الإيواء حيث لا يتوفر أي شروط للمسرح بشكله التقليدي، عليه كان خيار المسرح التفاعلي واحدًا من أهم الخيارات المناسبة لجمهورنا المستهدف، فضلًا عن الضرورات المنهجية التي تحتاجها القضايا التي اشتغلنا عليها .
هكذا تبلورت تجربتنا المسرحية في النزوح مما مكننا من حماية هويتنا المسرحية التي بدورها وفرت لنا مصادر دخل نغالب بها احتياجاتنا ومطلوباتنا الأسرية، والأهم مكنتنا من المساهمة في قضايا واقعنا ومجتمعنا الجديد الذي فُرض علينا إكراها.
*ما هي التحديات التي واجهتها في تقديم عروض مسرحية في بيئات نازحة أو هشة؟
أهم التحديات بالنسبة لنا كانت مقاومة هويتنا كنازحين لصالح استعادة هويتنا المسرحية، بالضرورة تعلم أن الحرب طالتنا نحن المسرحيين كما طالت جميع قطاعات المجتمع الأخرى، ولا أظن أن أحدًا ينتظر من شخص يعاني ذات واقع الحرب والنزوح ويعاني نفس المآسي والفقد، أن يكون متوقعًا من هذا الشخص المساهمة في معالجة أو تخفيف آثار هذه المآسي عند غيره، وهو تحدٍ واجهناه بالصبر وتبديل الثأر الشخصي لفقدنا ولمآسينا لمبادرات نؤمن بأنها ستحول هذا التحدي لفرصة نجاح كبيرة، سيما لو نجحنا في التحرك الخلاق في المسافة ما بين سيرنا الشخصية وما بين سيرنا العامة، وقتها سيجد كل فرد من جمهورنا المستهدف سيرته في المعاناة وفي مقاومتها وبالتالي سيرته في النجاة الممكنة.
ثاني أكبر التحديات التي واجهتنا كانت توفير الموارد وكسب شركاء وهو تحدٍ عالجناه كما قلت في الإجابة على السؤال الأول بتصميم وصناعة عروض تجتذب رؤوس الأموال من منظمات المجتمع المدني.
أيضاً واجهنا تحدي التصاديق الأمنية من الجهات المسؤولة، فحتى يتسنى لنا الدخول لمراكز الإيواء كان مطلوب منا سلسلة من الإجراءات الرسمية والأمنية العقيمة، التي كنا نشرع في تنفيذها من وقت مبكر من التاريخ الذي ننوي تقديم عروضنا فيه، لن تصدق لو قلت لك إن أحد عروضنا وهو عرض (متاريس) وبعد تقديمه الأول انتظرنا ما يقارب الثلاثة شهور لنقدم باقي عروضه الأخرى، وذلك لأن جمهوره الذي خارج القاعة التي قدمنا فيه العرض كان أكثر من الجمهور داخلها، وأن استجابة هذا العدد الكبير لدعوتنا حضور العرض وهتافهم تفاعلاً مع العرض كلفنا ثلاثة شهور من لجان تجتمع وتنفض بلا قرار يسمح باستئناف تقديم عرضنا، ولولا تمسكنا بحقنا في التعبير والعمل لما نجحنا في تقديمه بعد ثلاثة أشهر .
*الفرق بين جمهور المركز وجمهور المناطق الطرفية أو المتأثرة بالنزوح؟
لم يعد هناك مركز، كلنا صرنا أطرافاً مجروحةً، تبددت أوهام وادعاءات المراكز، تعرينا جميعاً وصارت عوراتنا مكشوفة لبعضنا البعض، إما أن نعمل على سترتها ومواجهتها أو ستحرقنا الشمس. هكذا وعيت المسرح بعد الحرب لذلك اجتهدت أن ينتمي ما سأفعله من مسرح لهذا التوحد المأساوي لهذه الأطراف المجروحة، إما أن تبدع مسرحاً يعزز هذا التوحد ويدعمه نحو الخروج من عمق المأساة، أو لن يكون هناك مراكز أو أطراف.
*هل يمكن للمسرح أن يؤدي وظائف علاجية في بيئات ما بعد الصدمة، وما حدود المسرح التفاعلي كأداة للتغيير وسط تلك البيئات؟
على وجه العموم بقدر ما يمكن للمسرح وكل الفنون أن تكون أداة لنشر وتعزيز الوعي الحقيقي، بقدر ما يمكن أن يكون المسرح وكل الفنون أدوات لنشر وتعزيز الوعي الزائف، فالأمر يتعلق أولا بوعي ومعرفة الفنان لفنه ثم ما إن كان هذا الفنان منتمٍ للجماهير والمستضعفين أم للسُلط والحُكام، بمقدار انتمائه إلى المستضعفين بمقدار عمله لترسيخ الوعي الحقيقي والعكس صحيح، بمقدار تماهيه مع الطغاة بمقدار ترسيخه للوعي الزائف .
أما وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بمسرحٍ يُنتظرُ منه وظائف علاجية فإجابتي أن نجاح تجارب مسرح المقهورين وتجارب السايكودراما في العالم تؤكد إمكانية أن تحقق تجاربنا ذات النجاح.
بالنسبة للشق الثاني من سؤالك أعتقد أن حيوية المسرح التفاعلي وفاعليته إحدى أسرارها تكمن في تذويب الحدود ما بين المؤدي وبين المتلقي للحد الذي يجعل منهما شريكين في إنتاج وتخلق العرض هنا والآن، فكلما ضاقت المسافة بين المؤدين والجمهور كلما توسعت وتعددت فرص التغيير، ببساطة لأن مشاركة الجمهور الذي هو صاحب القضية المطروحة من قبل المؤدي إنما مشاركة تعني أنه لا حلول ولا وصاية فوقية وإنما ها هو (صاحب الوجعة) في قلب ميدان الوعي.
*مستقبل المسرح في السودان ما بعد الحرب.. رؤيتك لإعادة بناء الحركة المسرحية في البلاد؟
اسمح لي بالإجابة عن هذا السؤال بالقول إنني في رحلة نزوحي هذه قدمت عددًا من العروض المسرحية بلغات سودانية عديدة دون أن أخضع لأوهام ضرورة ترجمة هذه اللغات بأي شكل من أشكال الترجمة، حيث قدمت عرض مسرحية (هسمني) التي تعني بلغة البداويت تخطي، في هذا العرض تحدثت شخصية (سند) البجاوية بلغتها الأم.
كذلك قدمت عرض (مشاوير) الذي تحدثت فيه شخصيات المسرحية بالتقراي وبالنوبية والهوسا والبداويت وبالعربية، تحاورت وتنازعت وتواصلت جميع هذه الشخصيات دون أن تحتاج أي منها التنازل عن لغتها الأم. أيضاً قدمت عرض (قومات) التي تعني بالتقراي مشورة، وهذا الأخير تحديداً كانت اللغة الأساسية فيه هي التقراي بينما العربية حضورها يكاد يكون هامشياً، وشاركتنا الجماهير الصمت والتأمل والضحك والبكاء، صفقنا لحضورهم الخلاق وبادلونا التحايا على أمل اللقاء مجدداً في عروض آخر.
قصدت بحكايتي لهذه التجارب القول إنه لا مستقبل ولا بناء لحركة مسرحية إن لم نرد الاعتبار لهذا التنوع الإثني والثقافي واللغوي، إن لم نعمل على أن تكون خشباتنا ومنصاتنا المسرحية والدرامية حافلة بهذا التنوع فيا لخيبتنا وتضييعنا للمستقبل.
*ما الذي تعلمته من العمل مع النازحين أو في بيئات صعبة؟
اسمح لي بالضحك على نفسي فما تعلمته يثير سخريتي على نفسي وعلى كل من كان يتوهم معي من مسرحي المركز فرضيات نقدية ساذجة، أولى هذه الفرضيات تلك التي تدعي أن لغة مسرحنا السوداني يجب أن تكون بالعامية العربية أو بالعربية الفصحى ليتواصل معها الجمهور، هذه كذبة كبرى يا صديقي، كذبة أضاعت علينا كمسرحيين ألسنة ولغات غنية بالمجاز وبالشعر وبالفكر والعواطف، ما كان علينا إلا أن نجود ونصدق في عملنا المسرحي ووقتها لنتحدث بأي لغة فقط لتكن منّا.
كذلك تكسر عندي وهم سلطة الممثل النجم أو المعروف كشرط لنجاح العروض وإقبال الجماهير عليها، فقد عملت مع هواة وشباب كانت أعمالنا تجاربهم الأولى في المسرح إلا أنها بلا شك تجارب ستظل خالدة في ذهن ووجدان من شاهدوها سيما الأطفال في مراكز الإيواء .
* نماذج من أعمالك التي تناولت الحرب أو عالجت آثارها النفسية والمجتمعية ؟
توفقنا في نزوحنا إلى مدينة ود مدني ومدينة بورتسودان في تقديم الكثير من العروض المسرحية، بجانب الكثير من ورش العمل التدريبية والأنشطة الفكرية، من بين هذه الأعمال ما له علاقة وطيدة بسؤالك لذلك دعني أذكر لك عرض (هسمني)، حيث تكافح المهندسة الميكانيكية فطومة والفراشة النول في تثبيت وجودهن في الفضاء العام وممارسة مهنهن والتمتع بحق التنقل والحركة رغم تعنت وتسلط شخصية الخبوب ومحاولة منعهن الركوب معه في المواصلات، تلك المشكلة التي ينفجر بسببها العرض طارحاً أشكال التمييز والعنف ضد النساء وقضايا العدالة الإنتقالية .
أما المرأة والرجل الصامتان في عرض مسرحية (صمت) والجالسان لوحدهما في مكان موحش ومقطوع، حيث يثرثر بلا انقطاع الرجل ليحث المرأة على مشاركته الحديث دون أن ينجح إلا بعد دخوله في نوبة بكاء، مما يضطر المرأة لسرد وتقديم حكايتها مع الحرب والنزوح الأمر الذي يقلب الأمر ويجعل الرجل في صمت تام رغم محاولات المرأة حثه للكلام وتقديم حكايته، التي يتكهنها الجمهور بتدخل الممثل المايسترو، تكهنات تقترب من حكاية الرجل للدرجة التي تدفعه لسد فراغاتها وتكملتها بعد اطمئنانه أن هناك من يشاركه حكايته، إنما كان عرضاً عن وحول صدمة ما بعد الحرب والنزوح.
في مشوار نساء ورجال مختلفي الأعمار والسحنات واللغات ومن مناطق جغرافية مختلفة جميعهم يتحتم عليهم إنجاز مشوار محدد لا ينفع فيه تخلف أي واحد منهم لأن مهمة كل منهم في هذا المشوار مرتبطة بالآخر، وبالتالي عليهم التخلص من تحديات العنصرية والتمييز وخطاب الكراهية، مع التذكير أن من بينهم امرأة تعدى حملها الشهر العاشر ورغم ذلك يرفض جنينها الذي قالت إنه ناغمها وأخبرها برفضه الخروج من رحمها ما لم يتخلصوا من جميع من أوساخهم من عنف ضد النساء وخطاب كراهية… إلخ ، وبالفعل لا يفاجئ الحامل المخاض إلا بعد مواجهة أصحاب المشوار آخر تحدٍ لهم، لتكون نهاية العرض صوت الفتاة المولودة الجديدة.
هذه كانت بعض من تجاربنا في النزوح .