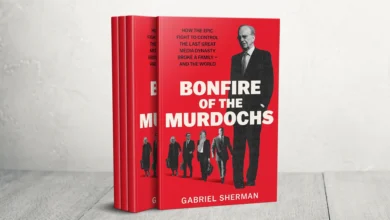صحيفة الإندبندنت:يجب على العالم أن يتحرك الآن لوقف الكارثة التي تتكشف في السودان

إذا كانت التقارير الصادرة من مدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي السودان تحمل ولو جزءًا من الحقيقة، فإن ما يحدث هناك يُمثّل وصمة عار على جبين العالم. فقد استولت قوات الدعم السريع المتمردة مؤخرًا على المدينة بعد حصار خانق استمر 18 شهرًا، تاركة خلفها آلاف القتلى من المدنيين في سلسلة من الفظائع التي وصفها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل بأنها “موجة عنف مفرط تشبه ما حدث في رواندا عام 1994″، مستندًا إلى صور الأقمار الصناعية وشهادات من الميدان.
وربما لا يُفاجئ هذا الوصف أحدًا، إذ أصبحت الوحشية والعنف العرقي في السودان مشاهد مألوفة في حربٍ تجرّدت من كل معنى للإنسانية. وبينما تتجه أنظار العالم إلى النزاعات الطاحنة في أوكرانيا وغزة، ظلت الحرب الأهلية في السودان الأقل ارتباطًا بتوازنات القوى العالمية تُخاض بصمت قاتل بعيدًا عن اهتمام الإعلام والدبلوماسية.
ومع ذلك، فإن حجم المأساة الإنسانية هناك مذهل: أكثر من 11.7 مليون شخص شُرّدوا قسرًا، بينهم 4.2 مليون لاجئ في الخارج، ومئات الآلاف من الأطفال ماتوا جوعًا، بينما يُستخدم الاغتصاب كسلاح حرب، وتُرتكب الإعدامات الجماعية بحق المدنيين، معظمها بدوافع عرقية واضحة.
وقد وصفت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفون كوبر، المشهد بأقسى العبارات: “فظائع لا توصف، مجازر جماعية، وتجويع ممنهج، واغتصاب يُستخدم كسلاح ضد النساء والأطفال إننا أمام أكبر كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين”.
يتقاتل في السودان عدد لا يُحصى من الميليشيات والفصائل المسلحة، تتغير تحالفاتها بين ساعةٍ وأخرى، مدفوعة بالكراهية العرقية والطموحات القبلية والمصالح المرتزقة. ومنذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، انزلقت البلاد التي لم تعرف استقرارًا منذ استقلالها إلى جحيم من الرعب والفوضى.
حتى إدارة ترامب، التي نادرًا ما كانت تتسرع في إصدار الأحكام، أقرت بوقوع جرائم ضد الإنسانية في السودان. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة تعيينه في يناير/كانون الثاني: “في زمنٍ يُساء فيه استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، ما يحدث في السودان هو إبادة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. استهداف عرقي لمجموعات بعينها بهدف القضاء عليها”.
قلة الاهتمام الدولي تُعزى إلى تعقيد الصراع السوداني، الذي يتخذ أشكالًا متداخلة من النزاعات حول الأرض والماء والهوية، زادتها التغيرات المناخية اشتعالًا، فصار السلام هناك يبدو بعيد المنال.
ويعود أصل الأزمة إلى تناقضات تاريخية بين العرب وغير العرب، المسلمين وغير المسلمين، الشمال والجنوب والغرب تناقضات لم تُحل منذ الاستقلال عن بريطانيا ومصر عام 1956. وحتى بعد انفصال الجنوب عام 2011، لم تهدأ النيران، بل انتقلت إلى الخرطوم ودارفور، حيث تقاتل قوات الدعم السريع المنبثقة من ميليشيات الجنجويد — الجيش السوداني على أنقاض الدولة.
على مدى السنوات الماضية، حاولت قوى إقليمية ودولية مثل السعودية ومصر وإثيوبيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد التوسط لإنهاء الحرب، دون نجاح. الجديد هذه المرة هو حجم التدخل الأجنبي غير المسبوق: من الإمارات وروسيا ومجموعة فاغنر، إلى تركيا وإيران، بل وحتى فصائل من اليمن. ونتيجة لذلك، أصبح واحد من أفقر بلدان العالم ساحة لتجريب أحدث الأسلحة الحديثة إلى جانب أبشع أساليب القسوة البدائية.
وقد وجّه الوزير الأمريكي ماركو روبيو انتقادًا صريحًا لدور الإمارات في دعم قوات الدعم السريع، داعيًا الدول الغربية إلى اتخاذ موقف مماثل. أما الرئيس دونالد ترامب، المنشغل بتهديداته في نيجيريا، فعليه إن كان جادًا في مساعيه الجديدة لصنع السلام أن يستخدم نفوذه لحثّ حلفائه في المنطقة على دعم مسار التفاوض في السودان.
إن امتداد دائرة العنف من منطقة الساحل إلى القرن الأفريقي والشرق الأوسط ينذر بموجة لجوء جديدة نحو أوروبا، ما يجعل تجاهل المأساة السودانية خطأً استراتيجيًا وإنسانيًا جسيمًا.
وكما هو الحال في غزة وأوكرانيا، فإن الأولوية القصوى يجب أن تكون إيصال المساعدات الإنسانية فورًا إلى المدنيين المنكوبين وهي مهمة شبه مستحيلة وسط القتال وانهيار البنية التحتية. ولا سبيل لذلك إلا عبر وقف إطلاق نار فعلي، رغم عدم وجود مصلحة لأي طرف حاليًا في التهدئة.
قد يبدو الأمل ضعيفًا، لكن الاستسلام لليأس أخطر من الحرب نفسها. على المجتمع الدولي أن يواصل جهوده الدبلوماسية مهما بدت الطريق مسدودة، لأن كل تأخير يعني ببساطة أن مزيدًا من الأبرياء سيُدفنون في رمال دارفور المنقوعة بالدم.