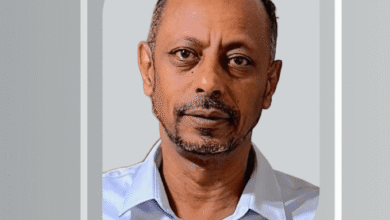الفساد كعادة اجتماعية لا كجريمة

بقلم : نسرين علي
في المجتمعات التي تطول فيها الأزمات، يصبح الفساد في نهاية المطاف أكثر من مجرد ممارسة خاطئة، يتحوّل إلى عادةٍ اجتماعية مشروعة، تُمارَس بلا خجل، وتُبرَّر بلا حرج.
حين يختفي القانون أو يتراجع أمام الحاجة، يخرج الفساد من الظل، ويجلس في قلب الحياة اليومية كأنه جزء من “الذكاء الاجتماعي” أو “فن تدبير المصلحة”.
نحن لا نعيش فقط مع الفساد، بل نعيش به.
من “الإكرامية البسيطة” إلى “الخدمة السريعة”، من “التسهيل” إلى “المجاملة”، نلتفت حول القوانين والنظام، تتسع الدائرة حتى يصبح من يرفض المشاركة فيها هو الغريب، لا من يمارسها.
بهذا الشكل، تتحول الجريمة الأخلاقية إلى ثقافة اجتماعية، ويصبح الفساد شكلاً من أشكال التكيّف لا الجريمة.
* ثقافة التبرير حين تُجمّل الرشوة باسم الذكاء أو الفهلوة
كل فسادٍ يحتاج إلى قصة تبرّره.
القصص جاهزة دومًا: “كل الناس بتعمل كده”، “الحياة صعبة”، “الراتب ما بكفي”، “لو ما عملت كده بتتعطل أمورك”. “أجيب من وين؟ نعمل شنو؟”.
بهذه الجمل الصغيرة نُعيد تعريف الجريمة على مقاسنا، ونحوّلها من فعل مدان إلى وسيلة للبقاء.
لكن الخطر ليس فقط في الفعل، بل في المخيال/الوعي الجمعي الذي يرافقه.
حين يُصبح “الفساد الصغير” وسيلة لتسيير الحياة، يُعاد إنتاجه في كل المستويات: الموظف يبرره لأنه لا يجد العدالة، والمسؤول يراه ضرورة، والتاجر يراه “شطارة”، والمجتمع يراه “واقع الحال”.
تتحول المصلحة إلى دينٍ جديد، لا يُحاسَب عليه أحد.
* من المصلحة إلى المنظومة
في الدول التي تضعف فيها المؤسسات، ينشأ ما يمكن تسميته بـ”اقتصاد الفساد”.
كل شيء له سعر، من الأوراق الرسمية إلى العدالة ذاتها.
حينها لا تعود الرشوة سلوكًا فرديًا، بل نظامًا اقتصاديًا غير معلن – شبكة مصالح تغذّي نفسها بنفسها.
في هذا النظام، لا يهم القانون، بل من تعرفه.
ولا تهم الكفاءة، بل الولاء.
تتبدل المعايير، ويتحوّل الفساد إلى أداة للترقي الاجتماعي بدل أن يكون عارًا.
من هنا يبدأ الانهيار الأخلاقي الصامت، لا أحد يعترف بأنه فاسد، لكن الجميع يعرف أن اللعبة تقوم على الفساد.
* متى أصبح الفساد جزءًا من أخلاق البقاء؟
هذا السؤال المؤلم ليس تنظيريًا بل واقعيًا.
فحين يعيش الناس في ظروف من الخوف والفقر والحرمان، يصبح “التحايل” مهارة بقاء.
لكن حين يُطبع هذا التحايل ثقافيًا ويُدرّس ضمنيًا في الحياة اليومية، ينتقل المجتمع من تبرير الفساد إلى تبنّيه كقيمة.
الذكاء يُقاس بقدرتك على “تجاوز النظام”، لا بالالتزام به.
والبقاء يُقاس بقدرتك على “معرفة من يُسهّل لك الأمور”، لا بإيمانك بالحق.
في لحظةٍ ما، ينسى الناس أن القانون وُجد أصلًا ليحميهم من هذا المنطق، لا ليُكسر في سبيله.
* الفساد كمرآة للخلل الأكبر
الفساد لا ينشأ من الفراغ؛ هو انعكاس لعطبٍ أعمق في توزيع السلطة والثروة والثقة.
حين يشعر المواطن أن جهده لا يُكافأ، وأن المؤسسات لا تعمل إلا لمن يملك النفوذ، يصبح الفساد تعويضًا رمزيًا عن الإحباط العام.
لكن هذا التعويض قصير العمر: لأنه يقتل آخر ما تبقّى من معنى العدالة والانتماء.
كل مرة ندفع فيها رشوة صغيرة أو نقبل “واسطة” نضيف حجرًا جديدًا في جدار الفساد الجماعي، حتى يصبح من المستحيل اقتلاعُه بلا ألمٍ شامل.
* ما بعد الإدانة: نحو ثقافة مقاومة الفساد
لا يكفي أن نلعن الفساد، المطلوب أن نفهم كيف نحاربه ثقافيًا، لا إداريًا فقط.
التربية الأخلاقية يجب أن تُبنى على فكرة “الحق العام”، لا على “الذكاء الفردي”.
الإعلام يجب أن يسلّط الضوء على النماذج النزيهة لا فقط على الفضائح.
والدولة يجب أن تُكافئ الشفافية بنفس الحماس الذي تُعاقب به الفساد.
الإصلاح يبدأ من القاعدة الاجتماعية: من الأسرة التي تعلّم أبناءها أن shortcut اليوم هو انهيار الغد، ومن المدرسة التي تزرع أن العدالة ليست خيارًا بل كرامة.
خاتمة
الفساد لا يُهزم بالمحاكم فقط، بل بتغيير معنى المصلحة ذاتها.
حين يدرك الناس أن المصلحة الحقيقية هي في النظام، لا في كسره أو محاربته ، يبدأ المجتمع في التعافي.
فالفساد ليس مجرد جريمة قانونية — إنه عطب أخلاقي جماعي، لا يُشفى إلا بإرادة اجتماعية ترى في النزاهة قوة وسلوك سوي، لا ساذج .
وفي النهاية، السؤال هو:
هل ما يزال الفساد جريمة في وعينا، أم أصبح أحد فنون البقاء؟