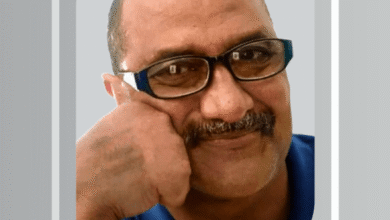الخرطوم بعد ألف يوم موت… هل يكفي الأمل لإعادة مدينة من تحت الركام؟
الزين عثمان
بعد ألف يوم ثقيلة من الموت المجاني، قالت الأمم المتحدة إن ملايين المدنيين في السودان لا يزالون يدفعون ثمن حرب لم يختاروها. ألف يوم صنعت فيها الحرب ما صنعت، وحوّلت الخرطوم، مدينة الحياة، إلى مدينة ميتة، يصارع سكانها يوميًا من أجل البقاء على قيد الحياة.
في هذا المشهد الملبّد بالرماد، يصل رئيس وزراء حكومة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كامل إدريس، إلى الخرطوم، متوسدًا حلمًا اسمه “الأمل”، ومعلنًا من قلب العاصمة مباشرةً بدء حكومة “الأمل” مهامها رسميًا.
وخلال مخاطبته حشدًا جماهيريًا في منطقة الكدرو بالخرطوم بحري، قال كامل إدريس إن عودة الحكومة إلى العاصمة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار، وتفعيل العمل التنفيذي، ومتابعة شؤون المواطنين من داخل الخرطوم نفسها. وتعهد رئيس الوزراء بأن تعمل حكومته على توفير الخدمات الأساسية، وتحسين خدمتي الكهرباء والمياه، وتأهيل المدارس، وإعادة الجامعات إلى العمل.
وأكد إدريس أن هذا العام سيكون “عام السلام”، واصفًا إياه بأنه “سلام الفرسان والشجعان والمنتصرين”، مضيفًا: “نبشركم بالانتصار في المعارك واستدامة التنمية”. وأوضح أن ميزانية هذا العام تستهدف خفض معدل التضخم بنسبة قد تصل إلى 70 في المئة، وزيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المئة، إلى جانب العمل على محاصرة السعر الموازي لصرف العملة.
وتعود هذه الخطوة في ظل حقيقة أن الحكومة السودانية كانت قد اضطرت، منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، إلى نقل مقارها وأعمالها التنفيذية خارج الخرطوم، عقب معارك عنيفة شهدتها العاصمة، وأسفرت عن أضرار واسعة بالمؤسسات الحكومية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات السودانية أكثر من مرة عن خطط لإعادة مؤسسات الدولة إلى الخرطوم بصورة تدريجية، بالتوازي مع تحسن نسبي في الوضع الأمني ببعض المناطق، وبدء أعمال تأهيل للمقار الحكومية والخدمية.
غير أن وصول رئيس وزراء “الأمل” إلى الخرطوم أعاد سريعًا طرح الأسئلة الكبرى: هل تصلح الخرطوم للحياة؟ سؤال سبقه آخر حول مدى قدرة كامل إدريس نفسه على البقاء في مدينة تحاول بالكاد استعادة الحد الأدنى من الحياة، في ظل أزمات الكهرباء والمياه، وندرة الوظائف، وتعقيدات الوضع الأمني الناتجة عن تداعيات الحرب، فضلًا عن الغياب شبه الكامل للقانون.
بالنسبة لكثيرين، فإن الخرطوم اليوم ليست خرطوم الأمس القريب، ولا حتى تلك التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع في ذروة الحرب ومواجهاتها. كما لا يمكن عقد مقارنة بينها وبين المدينة التي كانت تحتضن الجميع قبل الطلقة الأولى في الخامس عشر من أبريل. إنها مدينة لا تزال تسدد فاتورة الحرب، وستظل تدفعها لوقت ليس بالقصير.
ويرى هؤلاء أن قرار الحكومة العودة إلى الخرطوم يمكن أن يشكل لبنة يُبنى عليها مستقبلًا، وخطوة على طريق التعافي، لكنه في الوقت ذاته لا يصلح أساسًا لتبني خيار العودة بالنسبة للمواطنين، وهي عودة يربطها كثيرون بكونها “خيارًا شخصيًا” لا قرارًا عامًا.
ورغم عودة عدد من النازحين إلى العاصمة الخرطوم، إلا أن تحديات ومخاطر جسيمة لا تزال تواجه المدنيين، من بينها خطر الذخائر غير المنفجرة. غير أن هذا الخطر، في نظر البعض، يبدو أقل فتكًا من انفجارات أخرى غير مرئية تنتظر العائدين إلى المدينة.
وبالتزامن مع ما يجري على الأرض، كتب طارق أبو دبارة، القيادي في منظومة دولة البحر والنهر، تغريدة قال فيها: “ستعود الخرطوم بإذن الله، أما من تسبب فيما حدث”، محددًا مجموعات قبلية بعينها، “فلتكن عداوة الدهر وثأرًا لا ينتهي”. وهو خطاب يكشف طبيعة المعركة التي قد يواجهها العائدون إلى الخرطوم في الأيام المقبلة، معركة يرتبط جزء كبير منها بتمدد خطاب الكراهية كأحد إفرازات الحرب، مقترنًا بتوظيف القانون سياسيًا عبر دعاوى الاتهام بالتعاون مع قوات الدعم السريع، إلى جانب عامل بالغ الأهمية يتمثل في تراجع دور الشرطة لصالح القوات والمليشيات المشاركة في الحرب، حيث يسود قانون القوة، وتتراجع أمام مجد البندقية هيبة القانون.
وفي هذا السياق، تتصاعد مطالب مواطنين للسلطات بضرورة مغادرة منسوبي الأجهزة النظامية المنازل التي استولوا عليها، حتى يتسنى لأصحابها العودة إليها. لكن الملهاة تعيد نفسها؛ فالبيوت التي كانت تحتلها قوات الدعم السريع تحولت إلى ثكنات لقوات نظامية أخرى بعد تغير معادلة السيطرة في الميدان، ما يجعل بقاء منسوبي القوات النظامية أحد أبرز العقبات أمام عودة المواطنين إلى خرطومهم في الوقت الراهن.
ويضع هذا الواقع السلطة نفسها أمام امتحان عسير يتعلق بقدرتها على فرض النظام والقانون على حملة السلاح، خصوصًا وأن معظمهم من المستنفرين أو المليشيات المساعدة التي تشارك في الحرب تحت شعار تفكيك “المليشيا الكبرى”، في مشهد يؤكد سريالية أوضاع السودان في زمن الحرب.
وفي محاولة لبعث رسالة طمأنة، تعهد كامل إدريس بالبقاء في الخرطوم باعتبار ذلك خطوة أولى في سبيل استعادة الحياة، مؤكدًا أنه لن يغادرها. غير أن هذا الإعلان أعاد طرح سؤال آخر أكثر عمقًا: أي خرطوم يقصد؟
فالمدينة التي كان مركزها الخرطوم، وتحديدًا وسط الخرطوم قبل اندلاع الحرب، شهدت نشوء مراكز بديلة فرضتها ظروف القتال. وحتى الوزارات التي عادت للعمل، لم تفعل ذلك من مقارها الأصلية، بل من مقار مؤقتة، في وقت تمددت فيه أم درمان لتتحول فعليًا إلى المركز الخرطومي الجديد، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
الخرطوم القديمة، في صورتها المعهودة، لم يعد لها وجود في الوقت الراهن. والحياة فيها باتت قطعة من الجحيم، حقيقة يمكن تلمسها من مشهد مصور لأحد المواطنين طُلب منه أن ينادي الناس للعودة إلى منازلهم، لكنه رفض “بيع الوهم”، مؤكدًا أن الخرطوم اليوم لا تستطيع توفير الحياة للجميع، في ظل انعدام الوظائف، وصعوبة الحصول على مصادر رزق تؤمن الطعام، وتردي الخدمات الصحية، ونقص المستشفيات، وشح محاليل علاج الحميات المنتشرة.
ومع ذلك، وبموازاة حديث “الجوكر”، تبرز مشاهد أخرى من من داخل المدينة توحي بمحاولات خجولة لاستعادة الحياة؛ من إعادة فتح بعض المطاعم المعروفة في بري، إلى عودة النشاط في سوق الكلاكلة، وصولًا إلى استئناف حركة الطيران في مطار الخرطوم، عبر إحدى طائرات الشركات المحلية.
غير أن هذا التحليق بدوره أعاد طرح سؤال الحماية، وتحديدًا مسألة توفير منظومات مضادات جوية، في ظل استمرار حرب المسيّرات، التي كانت قد أوقفت إعلان العودة في وقت سابق بعد استهداف المطار. وسرعان ما يتسع هذا السؤال ليأخذ بعده الخارجي المتعلق بقدرة السلطة على الحصول على منظومات دفاع متقدمة، لحماية خطوة العودة، بوصفها جزءًا من رسم خارطة جديدة لميدان الحرب السودانية، التي بدأت تتخذ طابعًا إقليميًا، مع تحول أطرافها المتصارعين إلى مجرد رقع شطرنج يجري تحريكها من خارج الحدود.