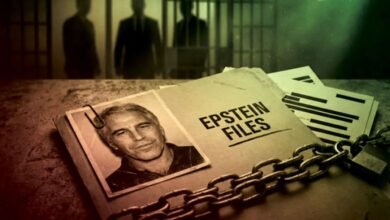من وهم التأسيس إلى فوضى السلاح: مأزق الدولة السودانية

بقلم : محمد عمر شمينا
منذ الاستقلال في عام 1956، ظلّ السودان يعيش داخل بنية دولة لم تُبنَ على أسس وطنية متوازنة، بل على ميراثٍ إداري وثقافي مستعار ورثه عن الحكم الثنائي البريطاني-المصري. هذه الدولة التي يُطلق عليها مجازًا دولة ٥٦ لم تكن دولة مواطنة ، بل جهازًا سلطويًا يتركز في المركز، ويمتد نحو الأطراف بوصفها مناطق تابعة. ومن ثم، فإن كل ما تلا ذلك من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية لم يكن سوى تجليات متكررة لفشل التأسيس الأول، لا حوادث معزولة عن جذره البنيوي.
لقد ولدت الدولة السودانية الحديثة ضمن مشروع حكم ثنائي لم يكن معنيًا ببناء وطن، بل بتشييد جهاز للضبط والإدارة والسيطرة. كان همّ الحكم الثنائي أن يخلق إدارة فعّالة تحمي مصالحه، لا مجتمعًا سياسيًا متجانسًا. فركّز التنمية والتعليم والخدمات في مناطق محددة حول وادي النيل الأوسط، وأبقى الأطراف في حالة تهميشٍ دائم، بحيث ظلت بعيدة عن المشاركة في القرار أو التنمية. بهذا المعنى، فإن الاستقلال السياسي في عام 1956 كان استقلالًا ناقصًا؛ إذ غادر الحكم الثنائي ، لكن ظله المؤسسي والفكري بقي ماثلًا في الدولة الجديدة. وعليه تحوّلت السلطة إلى نخبة صغيرة ورثت أدوات الحكم نفسها وهي البيروقراطية المركزية، والخطاب الثقافي الأحادي الذي ربط الهوية الوطنية بالعروبة والإسلام، وأقصى ما سواهما.
وفي هذا السياق التاريخي الطويل، تكشف تجربة دارفور قبل سقوط سلطنتها مثالًا مبكرًا على كيفية اشتغال منطق (مركز الحكم الثنائي) الواحد ان (جاز التعبير):حين واجهت سلطنة علي دينار ضغوط الحرب العالمية الأولى، لم يكن خيارها السياسي قائمًا على تحريض محلي أو نخبوية نيلية كما يُشاع، بل على رؤية سلطنة كانت تربطها بالأستانة روابط دينية ورمزية ممتدة. ومع ذلك، فإن الإنجليز تعاملوا مع موقف السلطان بوصفه تحديًا مباشرًا، فحُملت دارفور كلها تبعاته. ومنذ ضم الإقليم، اتُّبعت سياسات إدارية واقتصادية تركت آثارًا عميقة من التهميش، وأسست لعلاقة مشوهة بين (مركز الحكم الثنائي)والأطراف النيلية الأخرى، علاقة أورثت دولة ٥٦ حساسياتها وانقساماتها اللاحقة.
لقد كان نمط الحكم القائم على تماهي الدولة مع المركز هو السبب الجوهري في انقسام السودان إلى طبقتين سياسيتين واجتماعيتين: نخبة مركزية حاكمة، وأغلبية مهمّشة في الأطراف. فشل المركز في إنتاج دولة مواطنة عادلة، واكتفى بتكريس نفوذه من خلال السيطرة على القرار السياسي والثروة الوطنية. وهكذا تكرّس الانقسام بين (السودان الحاكم) و(السودان المحكوم)، بين من يملك أدوات القرار ومن يعيش نتائجه.
وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى مليشيا الدعم السريع بوصفها الوجه الخشن والمتوحش لدولة ٥٦، لا قطيعةً معها. فالمليشيا التي نشأت في عهد نظام الإنقاذ لم تأتِ خارج المنطق التاريخي للدولة السودانية، بل هي الامتداد الطبيعي لذلك المنطق حين يفقد غطاءه البيروقراطي ويتحوّل إلى عنف مباشر ومجسّد. أنشأتها الدولة المركزية لتكون ذراعًا أمنية تحمي النظام من خصومه، لكنها سرعان ما تحولت إلى كيان قائمٍ بذاته، يعيد إنتاج مركز القوة الخشنة خارج المؤسسات. بهذا المعنى، لم تخرج مليشيا الدعم السريع عن نموذج الدولة الغنائمية التي تُدار بالعصبية (القبلية) والولاء، لا بالمؤسسة والعقد الاجتماعي.
اما على المستوى الرمزي، ورغم أنّ معظم تكوين مليشيا الدعم السريع جاء من مناطق الهامش، فإنّ خطابها السياسي والثقافي يميل إلى استعارة مفردات العروبة والإسلام السياسي التي تشكّلت في المركز منذ عقود. ذلك لأن الشرعية في المخيال السياسي السوداني ما تزال تُستمد من هذه الرموز، لا من مفهوم المواطنة. فالمليشيا القادمة من الأطراف تسعى بشكل مفارق إلى الاعتراف من المركز عبر لغته وثقافته، أي أنها تعيد إنتاج ذات المنظومة التي أقصتها يومًا ما. وهكذا تصبح مليشيا الدعم السريع، رغم اختلاف خلفيتها الاجتماعية، تظل استمرارًا للمنطق الثقافي والسياسي والاقتصاديّ نفسه الذي أفرز دولة ٥٦، ولكن في صورة أكثر خشونة ووضوحًا.
لقد كان من الممكن أن يشكّل صعود مليشيا الدعم السريع لحظة مراجعة جذرية لمعادلة المركز والهامش، لكن ما حدث هو العكس تمامًا. فبدل أن تتجه التجربة نحو تأسيس دولة جديدة، إلا أنها أعادت إنتاج النسق القديم بوسائل خشنة. فالمليشيا باتت تمارس الدور نفسه الذي مارسه المركز من قبل فى احتكار القرار، فرض الولاء، وتهميش الآخر. الفرق الوحيد أنّ المركز القديم حكم بالقانون والإدارة، أما المركز (المدعي والمدعوم) الجديد فيحكم بالسلاح والقوة الميدانية. بهذا المعنى، يمكن القول إنّ مليشيا الدعم السريع ليست خروجًا على دولة ٥٦، بل تطورًا طبيعيًا لها حين تتعرّى من مؤسساتها.
أما في الحرب الراهنة، فإن هذا التناقض بلغ ذروته. فالمعركة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع ليست صراعًا بين دولة ومليشيا كما يبدو ظاهريًا، بل بين نموذجين من الدولة القديمة: نموذج المركز البيروقراطي الذي يحتمي بالمؤسسة، ونموذج المركز المسلح الذي يحتكر القوة الميدانية. كلاهما يتحرك داخل الإطار نفسه، حيث لا مكان فعليًا للمواطن كفاعل سياسي مستقل، وحيث تظل مفردات العروبة والإسلام والشرعية السياسية أدوات للهيمنة لا لبناء الشراكة.
إنّ أخطر ما في تجربة مليشيا الدعم السريع ليس عنفها المباشر فحسب، بل كونها تكشف استمرار الأزمة الجوهرية في الدولة السودانية وهو غياب المشروع الوطني الجامع. فالدولة ما تزال تُعاد صياغتها من داخل منطق الامتلاك، لا من منطق الشراكة. تتبدل الوجوه واللاعبون، لكن البنية العميقة تبقى كما هي، مركزٌ يحتكر القوة، وهامشٌ يبحث عن اعتراف.
لذلك فإن تجاوز مأزق دولة ٥٦ لا يتم بإسقاط المركز القديم أو هزيمة المليشيا الجديدة فحسب، بل بإنشاء عقد اجتماعي وطني جديد يعيد تعريف الدولة نفسها كدولة تقوم على مفهوم المواطنة المتساوية، والعدالة في توزيع السلطة والثروة، والفصل الحقيقي بين السلطة والدين، بحيث لا تكون العروبة أو الإسلام مصدر شرعية سياسية، بل جزءًا من تنوع ثقافي واسع يحتضنه الدستور.
بهذا الفهم، يصبح مشروع إعادة بناء السودان ليس مشروع سلطة، بل مشروع وعي. وعيٌ يدرك أن الدولة الحديثة لا تُبنى بالسلاح، ولا تُستعار من المركز، بل تُؤسَّس من قاعدةٍ شعبية ترى في نفسها شريكًا لا تابعًا، ومواطنًا لا رعية.
فمليشيا الدعم السريع، في نهاية المطاف، ليس إلا مرآة مكبّرة لدولة ٥٦، والخروج من هذه المرآة هو التحدي الأكبر أمام أي محاولة لتأسيس سودانٍ جديد.