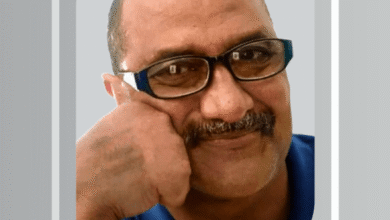الفنون كوسيلةٍ للمقاومة والبقاء في زمن الخراب
أحمد الليثي
حين ينهار النظام الأخلاقي للعالم، وتفقد اللغة معناها تحت ضجيج القذائف، يبقى للفنّ دوره القديم الجديد: أن يقول ما لا يمكن قوله، وأن يمنح المقهورين مرآةً يرون فيها وجوههم المطموسة.
الفنّ ليس ترفًا في زمن الخراب، بل هو فعل بقاءٍ روحيّ، يذكّر الإنسان بأنه — رغم كلّ شيء — ما زال قادرًا على تخيّل الجمال، ولو من قلب الجحيم.
وحين تضيق الأرض بالخُطى وتُطمر المعاني تحت ركام المدن وأشلاء الذاكرة، يصبح الفنّ آخر ما يتشبّث به الإنسان ليذكّر نفسه بأنه ما زال إنسانًا.
فالفنّ في لحظات الإنهيار ليس زينةً لزمنٍ آمن، بل مقاومةٌ ناعمة ضدّ موت المعنى، وصرخةٌ في وجه العدم تقول: ما زلتُ أرى، وأحسّ، وأحلم.
في كلّ حربٍ، حين يصمت الحديد ويتكلم الرماد، ينهض الفنّ ليحفظ الذاكرة من المحو، وليحمل عن الإنسان ما يعجز عن قوله. إنه لا يحارب بالرصاص، بل بالخيال؛ لا يقتل أحدًا، لكنه يُبقي العالم قابلًا للحياة.
فحين يعجز السلاح عن منح الخلاص، ينهض الفنّ ليحمل الذاكرة على كتفيه، ويحوّل البقاء نفسه إلى شكلٍ من أشكال المقاومة.
- *الفن كذاكرةٍ مضادة للنسيان*
تُكتب الحروب بلغة المنتصرين، لكن الفنّ يكتبها بلغة الذين لم يجدوا من يروي عنهم.
حين تسعى الأنظمة والجيوش إلى محو الذاكرة، يظهر الفنّ كأرشيفٍ وجدانيّ للضحايا.
الأغنية، القصيدة، الصورة، التمثال، الجدارية — كلها ليست ترفًا، بل وثائق حياة تصرخ ضد النسيان.
في فلسطين، كان الفنّ هو الشكل الأصدق للمقاومة المستمرة منذ أكثر من سبعين عامًا.
من رسومات ناجي العلي إلى أغاني ريم البنّا ومارسيل خليفة، تحوّل الإبداع إلى وثيقةٍ سياسية وشهادةٍ روحية في آنٍ واحد.
كل لوحةٍ لطفلٍ يحمل حجرًا هي ترجمةٌ بصرية لعبارةٍ واحدة: “لن نُمحى.”
وفي مخيمات الشتات، كانت الجدران نفسها تتحوّل إلى دفاتر ذاكرةٍ جماعية، تُكتب عليها أسماء الشهداء كأنها فصولٌ من روايةٍ لا يريد أصحابها أن تنتهي.
- *الفن كمقاومةٍ ناعمة*
المقاومة ليست دائمًا في الجبهات. أحيانًا تكون في بيتٍ صغيرٍ يعزف فيه أحدهم على عودٍ مكسور، أو في قصيدةٍ تُتلى سرًّا تحت حظر التجوال.
الفنّ يقاوم عبر الجمال، والجمال بدوره يعيد تعريف القوة.
فحين يُقصف المسرح، يبنيه الناس من جديد، لأنهم يدركون أن سقوط الخشبة يعني سقوط الذاكرة.
في يوغسلافيا خلال التسعينيات، كانت المدن المحاصَرة تحيي حفلات موسيقية في الأقبية تحت القصف. في سراييفو مثلاً، غنّى الناس في الظلام لأن الغناء كان يعني: لن نموت بصمت.
وفي السودان، ظلّت الأغنية أداة الوعي الجمعي والمقاومة السلمية. من محمد وردي إلى مصطفى سيد أحمد، لم يكن اللحن مجرد موسيقى، بل سلاحًا ضد الخوف. فحين ضاقت الساحات، فتحت القصيدة منفذًا إلى الحرية.
- *الفن كعلاجٍ للروح الجماعية*
الحرب لا تدمّر الحجر فقط، بل الذاكرة والعصب النفسي للشعوب.
الفنّ يصبح هنا علاجًا جماعيًا — لغةً للبوح حين يعجز اللسان.
في المسرح، يُعاد تمثيل الفجيعة ليُشفى الوعي منها. في الموسيقى، يتحول البكاء إلى إيقاعٍ مشتركٍ للنجاة.
الفنّ لا يزيل الألم، لكنه يغيّر موقعه في القلب، فيصبح قابلًا للفهم، وربما للحياة معه.
- *الفن كجسرٍ نحو المستقبل*
الفن هو ما يبقى حين يزول كل شيء.
حين تنتهي الحرب، لا ينجو إلا من إمتلك القدرة على الحلم وسط الركام، والفن هو تجسيد ذلك الحلم.
إنه الجسر الذي تعبر عليه الأمم من مأساة الدمار إلى إمكانية التجدد.
لذلك، لم يكن غريبًا أن تبدأ نهضات الشعوب بعد الحروب بمعارض، وأغانٍ، ومسرحيات، وأفلام تستعيد الحكاية — لا لتبكيها، بل لتصوغ منها معنى جديدًا للحياة.
- *الفن كتذكيرٍ بالجوهر الإنساني*
في النهاية، لا شيء يواجه القسوة المطلقة سوى الجمال.
حين يعزف طفلٌ على الكمان في شارعٍ مهدّم، أو ترسم امرأةٌ على جدارٍ محروق زهرةً حمراء، فذلك ليس فعلاً بسيطًا — إنه إعلان وجود.
إعلان بأن الروح لم تُهزَم، وأن الفن هو آخر قلاع الإنسانية حين تسقط المدن.
- *الفن كجسرٍ نحو العدالة والمصالحة: تجربة جنوب أفريقيا*
حين سقط نظام الفصل العنصري، كان الجنوب أفريقيون أمام خيارين: النسيان أو الإنتقام. فإختاروا الثالث: التذكر عبر الفن.
الفنّ هناك لم يكن ترفيهًا بعد الحرب، بل كان روح العدالة نفسها.
في الأغاني، حملت مريام ماكيبا وهيو ماسكيلا أصوات ملايين المقموعين.
في المسرح، قدّم أثول فوجارد شخصياتٍ تواجه ماضيها بلا أقنعة.
وفي الفنون التشكيلية، تحوّلت الجراح إلى رموزٍ للجمال والكرامة، لا للعار.
إرتبط مشروع “الحقيقة والمصالحة” بروحٍ فنيةٍ عميقة: الإصغاء إلى الحكايات بدل كبتها، تحويل الألم إلى سرد، والسرد إلى شفاءٍ جماعي.
هكذا صار الفنّ أداةً للعدالة الروحية، لأن العدالة لا تكتمل بالقانون وحده، بل بحاجةٍ إلى خيالٍ يعيد للإنسان ثقته بذاته.
- *صرخة الحرية: البلوز كفلسفةٍ للتحرّر*
في أمريكا، لم تولد موسيقى البلوز في المسارح ولا في القاعات المضيئة، بل في ظلال حقول القطن، حيث كان الإنسان الأسود يغنّي ليدفع عن نفسه العدم.
كانت أنينًا جماعيًا لأناسٍ سُلبوا من كل شيء — من أرضهم، من لغتهم، ومن أسمائهم — فحوّلوا الألم إلى إيقاع، والعبودية إلى لحنٍ يحمل نُطفة الحرية.
البلوز لم يكن مجرد غناءٍ عن الحب أو الفقد، بل عن الكرامة المسروقة والحرية المؤجلة.
من صرخات العبيد في مزارع المسيسيبي إلى أصوات بي. بي. كينغ وما ريني وبيلي هوليداي، ظلّ البلوز ذاكرةً موسيقيةً للتاريخ الأسود — سجلًا وجدانيًا لكلّ ما لم يكتبه المؤرخون.
وحين غنّت بيلي هوليداي “Strange Fruit”، تلك القصيدة التي تصف أجساد السود المعلّقة على الأشجار، لم تكن تؤدي أغنية، بل تفتح جرحًا في ضمير العالم.
كان صوتها صدى لصرخةٍ لم تهدأ منذ قرون، جعل من الموسيقى وثيقةَ إدانةٍ بقدر ما كانت نشيدَ بقاء.
تلك النغمة الموجوعة هي التي أنجبت لاحقًا الجاز والسول والهيب هوب — كلها امتدادات لصرخةٍ واحدة بدأت من العبودية وانتهت إلى الوعي بالحرية.
لقد كانت موسيقى البلوز مدرسةً في تحويل القهر إلى جمال، والذلّ إلى طاقةٍ إبداعية، تمامًا كما فعلت الفنون في فلسطين وجنوب أفريقيا والسودان.
ففي خلفية كل ثورةٍ ضد الظلم، ثمة وترٌ حزينٌ يعزف ما لا تستطيع السياسة قوله.
هكذا أصبح البلوز أولَ فلسفةٍ موسيقيةٍ للتحرّر الحديث — فنًّا نبت من جرحٍ، لكنه غيّر نغمة العالم.
- *الفن بين الدمار والبعث: تجربة يوغسلافيا*
في حرب البلقان، حين كان الموت اليومي يلتهم المدن، وُلدت “أوركسترا سراييفو” تحت القصف، كرمزٍ للكرامة وسط الفوضى.
كانت الحفلات تُقام بين أنقاض المسارح، وكان الفنانون يعزفون مقطوعات باخ وشوبان كأنهم يعلنون أن الإنسانية لن تُقصف.
بعد الحرب، تحوّل الفنّ إلى وسيلةٍ للمصالحة بين الإثنيات المتناحرة — لغةً محايدة تعيد للأرض صوتها بعيدًا عن السياسة والدين.
من اللوحات التي دمجت رموز الصرب والبوسنيين والكروات في شكلٍ واحد، إلى المهرجانات المشتركة، كان الفنّ لغة ما بعد الدم.
- *الفن كصوتٍ في العاصفة: تجربة السودان*
في السودان، لم يكن الفنّ يومًا على هامش الوجدان الجمعي، بل في صُلبه.
حين عجزت السياسة عن جمع الناس، جمعهم اللحن والكلمة والصورة.
في زمن الحرب، تحوّلت الأغنية إلى وسيلة للبقاء، والقصيدة إلى ملاذٍ من القهر، واللوحة إلى وثيقةٍ ضد النسيان.
من محمد وردي الذي غنّى “أصبح الصبح” كأنها نشيد ميلادٍ جديد، إلى محجوب شريف الذي جعل من الكلمة سلاحًا ووردًا في آنٍ واحد، ومن حميد الذي أعاد للشعر العاميّ روحه الثائرة، إلى مصطفى سيد أحمد الذي مزج الحنين بالرفض، ظلّ الفنّ السوداني صوت الوجدان لا صدى السلطة.
في الثورة السودانية، كانت الجداريات والشعارات وأناشيد “حرية، سلام، وعدالة” امتدادًا لهذا الإرث — تواطؤًا جميلًا بين الفنّ والحلم، بين اللحن والدم.
اليوم، ومع اتساع الحرب وتفتت المدن، ما زال للفنّ السوداني دوره: أن يوحّد ما فرّقته البنادق، وأن يحفظ ذاكرة الذين سقطوا دون أن يصبحوا مجرّد أرقام.
في وجه الظلام، يبقى الفنان السوداني حامل الضوء الأخير، كما كان الطيب صالح حين كتب عن النيل كذاكرةٍ للروح، وكما يفعل شباب اليوم حين يحوّلون صور النزوح إلى معارض مفتوحة على الأسفلت.
الفنّ السوداني في زمن الحرب هو دعوةٌ للكرامة قبل العدالة، وللحلم قبل السياسة — امتدادٌ لما فعله الجنوب أفريقيون والفلسطينيون واليوغسلافيون: تحويل الجرح إلى لغة، واللغة إلى وطنٍ مؤقتٍ حتى يعود الوطن الحقيقي.
- *الفن كخلاصٍ إنساني*
في النهاية، الفنّ لا يوقف الحروب، لكنه يمنعها من الانتصار الكامل.
حين يصمت السياسيون ويكذب المؤرخون، يظلّ الفنان وحده يكتب الحقيقة بلونٍ لا يُمحى.
الفنّ هو الذاكرة الحيّة التي تقف بين الموت والمعنى.
إنه فعل حبٍّ في زمن الكراهية، وومضةُ ضوءٍ في ليلٍ طويل.
“حين تصمت البنادق، يبدأ الفن في قول الحقيقة.”