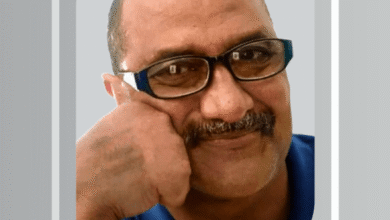أعداء النجاح.. في ظاهرة الحسد السوداني
بقلم: طارق فرح
﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله﴾
النساء: 54
الحسد شعورٌ عاطفيّ يتمنّى صاحبه زوال نعمةٍ أو إنجازٍ أو ميزةٍ من غيره، وأن تزول عن الآخرين فحسب. وهو يختلف عن الغبطة التي تعني تمني النعمة دون زوالها عن المغبوط. لكنّ الحسد، حين يستوطن النفس، يتحوّل إلى حقدٍ وكراهيةٍ عميقة تُطفئ البصيرة، وتزرع في القلب مرارةً لا تنتهي.
وينقسم الحسد إلى نوعين:
- الحسد المذموم (الضار): كراهية الخير لغيرك وتمنّي زواله، وما يصاحبه من أذى وعداء.
- الحسد المحمود (الإيجابي) أو الغبطة: أن تتمنى مثل نعمة الآخرين دون زوالها عنهم، فيتحول الشعور إلى طاقة إيجابية محفزة على السعي والإجتهاد والمنافسة الشريفة.
الحسد بما يصاحبه من حقدٍ وكراهية، ضاربٌ في عمق النفس الإنسانية منذ البدء. فهو أول خطيئةٍ عرفها الوجود حين حسد إبليسُ آدمَ على منزلته، ثم تجلى في قصة قابيل وهابيل عندما حمل الحسدُ قابيلَ على قتل أخيه. فكانت أول جريمة قتل في التاريخ، وكان باعثها الحسد المتحوّل إلى كراهية قاتلة.
لكن في السودان، لم يَعُد الحسد مجرّد عاطفة بشرية؛ بل تجاوز ذلك ليصبح نمطًا ثقافيًا متجذّرًا، مقرونًا بالكراهية والحقد، حتى كأنه سمة إجتماعية موروثة. تسلّل إلى النفوس متخفيًا خلف المديح والغيرة “المشروعة”، ثم خرج إلى العلن في صورٍ متكررة: بين السياسيين والناشطين، وفي ميادين الفكر والثقافة والصحافة والشعر والفن والمجتمع، بل حتى في بيئات العمل وبين النساء والأصدقاء.
الحسد لا يُوجَّه لشخصٍ بعينه، بل لكل من ينجح. فالنجاح لا يُقاس بما تُنجزه، بل بما تُثيره من الغيرة. وهو طاقة كامنة للعداء ضد التميّز، تمتزج فيها الغيرة بالحقد، فتُغلق باب الإنصاف حتى يصبح الهدم أسهل من البناء. إن الحسد حين يصاحبه الحقد والكراهية لا يهدم الأفراد فحسب، بل يسرق من الأمم مستقبلها. لقد تحوّل الحسد في السودان من شأن فردي إلى جريمة جماعية ضد الوطن نفسه.
وكلّما صعد نجم أحدهم، تسابق الناس، لا لتكريمه، بل لتفكيك سيرته، ونبش ماضيه، وبث الشبهات حوله. وإن لم يجدوا فيه عيبًا، إخترعوه. فإذا سقط، هدأت النفوس وإطمأنّت القلوب، يبدأ الدور ذاته مع ضحيةٍ جديدة.
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيَهُ
فالقومُ أعداءٌ له وخصومُ
عبّر عدد من المفكرين والأدباء السودانيين عن ظاهرة الحسد بذكاء وسخرية، كلٌّ من زاويته:
- الدكتور منصور خالد (مفكر ودبلوماسي وسياسي بارز) شبّه الحساد في السودان بـ“كلب القرية الذي يلهث خلف كل عربة مارة، فإذا توقفت صدّ عنها منتظرًا أخرى.”
- الأديب عبدالله الطيب (لغوي وأديب ومفسّر وشاعر) لاحظ أن المثقف قد يتحوّل إلى ألدّ أعداء المثقف، وأن العقل المتعلّم قد يُصاب بأمراض العامة نفسها لكنه يبررها بذكاء أكبر. وزاد ساخرًا: “إن بجزيرة العرب عشر قبائل إشتهرت بالحسد، هاجرت منها تسع إلى السودان!”
- إبراهيم منعم منصور (وزير مالية سابق) روى أن المفتش الإنجليزي بيتر هوق قال لوالده منعم منصور، ناظر دار حمر: “الحسد منتشر بين السودانيين، مما يصعّب عليهم حكم أنفسهم.”
- وأحد رجال الأعمال السودانيين وصف الحسد بأنه: “مثل من يتسابقون إلى قمة الجبل، فإذا تقدّمتهم لا ينافسونك في الصعود، بل يسحبونك من قدمك لتقع.”
في السياسة، لم نعد نختلف، بل نُقصي. تُلغى الإتفاقيات لا لأنها ناقصة، بل لأن من صاغها ليس من “جماعتنا”. تعمل الأحزاب كشلليات مغلقة، تتحالف لا من أجل الوطن، بل من أجل إقصاء الآخر. لا مشروع وطني، بل سباق على من يبقى ومن يُبعد.
وفي بيئات العمل، تُبعد الكفاءات خوفًا من بروزها، وتُعطّل المواهب لأن نجاحها يزعج أصحاب الشجون الصغرى.
أما في عالم النساء الناجحات، فالقصة أكثر تعقيدًا: حسدٌ يتخفّى خلف المجاملة والنفاق الإجتماعي، حقدٌ يختبئ في الصمت، وكراهيةٌ تتنكر في إبتسامة. صراعاتٌ خفية تستهلك طاقة مجتمعٍ بأكمله بدل أن تُستثمر في بنائه. وقد تعددت وجوه الحسد: بين السياسيين في صراعات الإقصاء، وبين المثقفين في منافسات الظهور، وبين الفنانين في بسط النفوذ، وحتى بين النساء في ميادين الجمال والمكانة الإجتماعية. ويمكن لأي مراقب أن يرى هذا الإتساع اليوم على منصات التواصل الإجتماعي: حيث تتزاحم أمامك صورٌ من الحسد والحقد والكراهية ما أنزل الله بها من سلطان. مظاهر لا تفسير لها إلا أنّها إمتداد لحالة إجتماعية متفشية.
هكذا أصبحنا بلدًا يطرد كفاءاته ببطء، ويعاقب المتفوق لأنه متفوق، ثم نتساءل ببراءة: لماذا لا نتقدم؟
كيف لوطنٍ يخاف من متفوّقيه أكثر مما يخاف من فاسديه؟ فيخسر الجميع، والوطن أولهم.
الحسد إذا تحوّل إلى حقدٍ جماعي وكراهية، يصبح طاقة عداءٍ دائمة للتميّز، تشتت الناس عن البناء، وتدفعهم لمطاردة بعضهم البعض، فالأمم لا تنهض بالكراهية، بل بالتكامل. ولا تصنع مستقبلها بالشماتة، بل بالإعتراف بفضل الناجحين ودعمهم.
﴿ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض﴾
النساء: 32
تُذكّر هذه الآية بأن الفضل موزّع بعدلٍ إلهي لا يغيّره حسدٌ ولا تُبطله غيرة. وما خُصّ به غيرك هو إمتحانٌ لك: أتُحسَد أم تتعلّم؟
فالسودان مشكلته ليست في موارده ولا جغرافيته، بل في عقولٍ وقلوبٍ تعمل لإسقاط الناجحين، وفي مجتمع يعاقب المختلف لأنه يفضح التقصير، ويحارب المتميز لأنه يذكّر غيره بجهله.
نحتاج إلى إدراك أن النجاح الجماعي يبدأ حين نتوقف عن إسقاط الناجحين. ويبدأ ذلك بثقافة تعترف بالفضل، وتربّي الأجيال على الرضا، وعلى فهم الفارق بين الغبطة والحسد. كما نحتاج إلى خطابٍ دينيٍّ راشد يعلي من قيمة الإجتهاد وتكافؤ الفرص، ويعيد الناس إلى ميزان العدل بدل المقارنات المَرَضية.
﴿وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾
المطفّفين: 26
ولعلّ أول خطوةٍ في شفاء هذا الوطن المنهك، أن نكسر هذه العادة السامة: أن نبارك لا نحسد، أن نصلح لا نهدم، أن نصعد معًا لا نجرّ بعضنا إلى الأسفل. فالوطن هو الخاسر حين تُهدم الجسور بين أبنائه، وتُستبدل روح المنافسة بروح الكراهية.
هذه ليست حكايات معزولة، بل ملامح لأزمة وعيٍ أعمق: أزمة مجتمعٍ لم يتعلّم بعد أن النجاح جماعي، وأن تفوق أحدنا لا ينتقص من الآخر.
وما لم نكسر هذه الدائرة المريضة، سيظل الوطن مكانًا يُقصى فيه المتميزون، ويُكرَّم فيه الفاسدون، وتظل الغيرة سياسةً رسمية، والحسد نظامَ حكمٍ غير معلن.