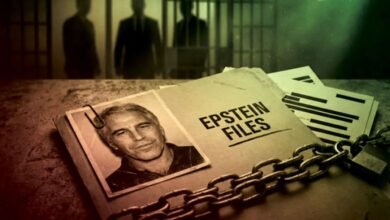على ماذا ترتكز هوية السودان؟

محمد عمر شمينا
في المقال السابق تناولنا أزمة الهوية السودانية الممزقة، وكيف ظل البلد منذ الاستقلال يتأرجح بين ثلاثة أبعاد كبرى: العروبة، الأفريقانية والإسلام، دون أن ينجح في صياغة مشروع جامع. وخلصنا إلى أن السودانوية تمثل المخرج الممكن من هذا المأزق، لأنها لا تنكر أيّاً من هذه الأبعاد، لكنها في الوقت ذاته ترفض اختزال الهوية في واحد منها. واليوم نطرح سؤالاً جوهرياً على ماذا ترتكز هوية السودان؟
هذا السؤال ليس نظرياً مجرداً، بل هو عملي وملحّ، لأنه يحدد طبيعة الدولة ويصوغ علاقتها بمواطنيها. فكل محاولة لتعريف الهوية ستنعكس مباشرة في الدستور، في التعليم، في الإعلام، وفي توزيع السلطة والثروة. والسودان جرب في تاريخه الحديث أن يرتكز على أسس مختلفة مرة على العروبة، مرة على الإسلام، ومرة على الأفريقانية، لكن النتيجة كانت دوماً انقساماً وحروباً وتمزقاً.
حين ارتكزت الهوية على العروبة، أُهملت المكونات الأفريقية العميقة في المجتمع السوداني. ورغم أن الثقافة العربية والإسلامية شكلت جانباً أصيلاً من هوية الشمال والوسط، إلا أن فرضها بوصفها الهوية الوحيدة جعل الجنوب والشرق والغرب يشعرون بأنهم غرباء في وطنهم. وحين ارتكزت الهوية على الإسلام، خاصة في ظل صعود الإسلام السياسي، تم إقصاء المكونات المسيحية والروحانية واللادينية، كما تحوّل الدين إلى أداة للهيمنة السياسية. بدل أن يكون الإسلام مصدر تسامح جامع، استُخدم كحدّ فاصل يقسم المجتمع إلى مؤمنين وغير مؤمنين، وفتح الباب أمام استقطابات مريرة حتى بين المسلمين أنفسهم. أما حين طُرح خيار الأفريقانية، فقد بدا كرد فعل على إقصاء العروبة والإسلام، أكثر من كونه مشروعاً متكاملاً. صحيح أن السودان إفريقي بجغرافيته وتاريخه العرقي والثقافي، لكن التركيز على الأفريقانية وحدها لم يكن كافياً ليشكل هوية جامعة، لأنه ببساطة يستبعد عمق السودان العربي والإسلامي المتجذر.
كل هذه التجارب أظهرت أن الارتكاز على عنصر واحد يجعل الهوية أداة إقصاء، لا أداة توحيد. والنتيجة كانت تمردات، حروب أهلية، وانقسامات متكررة تهدد كيان الدولة من أساسه. ومن هنا تصبح الحاجة ملحّة إلى أساس بديل للهوية، أساس لا يقوم على عرق أو دين أو لغة بمفردها، بل على عقد اجتماعي جديد يجعل من التنوع نفسه قاعدة للهوية. هذا العقد لا يلغي العناصر الثلاثة، لكنه يعيد ترتيبها داخل إطار أوسع هو المواطنة المتساوية.
لكن ماذا نعني بالعقد الاجتماعي الجديد؟ ببساطة هو اتفاق وطني يُبنى على مشاركة جميع المكونات في صياغة الدولة، لا أن يُفرض من فوق. دستور جديد لا يكتب في غرف النخب المغلقة، بل يولد من عملية تشاور واسعة تشمل ممثلين حقيقيين لكل الأقاليم والإثنيات والثقافات. بهذا يصبح الدستور انعكاساً لإرادة الناس، لا وثيقة لإعادة إنتاج سيطرة المركز. العقد الاجتماعي هنا هو الأساس الذي يترجم مبدأ السودانوية من فكرة ثقافية إلى مشروع سياسي.
المواطنة في هذا العقد ليست مجرد نصوص على الورق، بل ممارسة فعلية تقوم على المساواة أمام دولة حكم القانون، وعلى العدالة في توزيع الموارد والسلطة. فالمواطن لا يُعرّف فقط بحقه في التصويت أو الترشح، بل أيضاً بحقه في التعليم بلغته الأم، وبفرصته العادلة في التنمية والخدمات، وبشراكته المتساوية في الثروة الوطنية. إن العقد الاجتماعي يجعل من الاعتراف بالتنوع مقدمة لازمة لتحقيق العدالة. فالتنوع إذا حُمل على قاعدة المساواة يصبح مصدر قوة، أما إذا أُدير بعقلية الغلبة والإقصاء فإنه يتحول إلى بذرة انقسام.
العقد الجديد يعني أيضاً أن الدولة يجب أن تنظر إلى نفسها كخادمة لكل مواطنيها بلا تمييز. فالدستور الذي يعترف باللغات المحلية إلى جانب العربية لا يقدم منحة ثقافية، بل يؤكد مبدأ أن اللغة جزء من هوية الإنسان وكرامته. والمناهج التعليمية التي تدرّس تاريخ وثقافات جميع الأقاليم لا تفعل ذلك لمجرد التعدد الشكلي، بل لأنها ترسّخ شعور الانتماء المشترك. والإعلام المتوازن الذي يفتح منابره للهامش كما للمركز لا يمارس رفاهية ديمقراطية، بل يترجم مبدأ العقد الاجتماعي في الممارسة اليومية. وحتى التنمية الاقتصادية العادلة ليست مجرد سياسة مالية، بل تجسيد لفكرة أن المواطنة لا تكتمل إلا حين يشعر الناس أن ثروات البلاد توزع بعدل بينهم.
بهذا يصبح العقد الاجتماعي أكثر من مجرد اتفاق سياسي، بل هو مشروع هوية في حد ذاته. فحين يتفق السودانيون على أن المواطنة المتساوية هي المرجعية الأولى، يصبح بإمكانهم استيعاب العروبة والأفريقانية والإسلام معاً داخل إطار واحد. وحين يتشاركون كتابة الدستور وإدارة التنوع، يتحول السودان من بلد يتمزق بهوياته المتنازعة إلى بلد يوحّده اعترافه بتنوعه.
الهوية ليست شيئاً ثابتاً كالصخرة، بل عملية مستمرة من التفاعل وإعادة التشكل. والسودان، بموقعه الجغرافي بين أفريقيا والعالم العربي، وبإرثه الإسلامي المتجذر، محكوم عليه بالتعدد. لذلك فإن أي محاولة لحصره في خانة واحدة هي حكم على نفسه بالانقسام. الهوية المرنة تعني أن السودان يمكن أن يكون عربياً وأفريقياً وإسلامياً في آن واحد، لكن ليس عبر الجمع الميكانيكي لهذه العناصر، بل عبر صياغة وعي جديد يرى في هذا التداخل مصدر ثراء.
وهنا تبرز التجارب المقارنة. فالهند، رغم تعدد أديانها ولغاتها وأعراقها، استطاعت أن تجعل من هذا التنوع قوة لبناء دولة ديمقراطية. لم يكن الحل في محو الاختلافات، بل في الاعتراف بها وصياغة عقد اجتماعي يجعل الجميع شركاء في وطن واحد. السودان أيضاً يمكن أن يسلك هذا الطريق، إذا جعل السودانوية أساساً جامعاً، وإذا ارتكزت هويته على المواطنة المتساوية.
إذن، على ماذا ترتكز هوية السودان؟ الجواب أنها ترتكز على عقد اجتماعي جديد يجعل من المواطنة المتساوية أساساً، ومن السودانوية إطاراً جامعاً، لا على عرق، ولا على دين، ولا على لغة منفردة. هذا هو الخيار الممكن للخروج من دوامة الصراع ولتأسيس دولة حديثة تستوعب كل أبنائها. فالهوية ليست معركة حول من يسيطر على تعريف السودان، بل عقد شراكة بين الجميع ليبقى السودان نفسه قائماً. فإذا واصلنا الدوران في صراع العروبة والأفريقانية والإسلام، سيظل التمزق قائماً. أما إذا ارتكزنا على السودانوية، فربما نمنح هذا البلد أخيراً فرصة للسلام والإستقرار