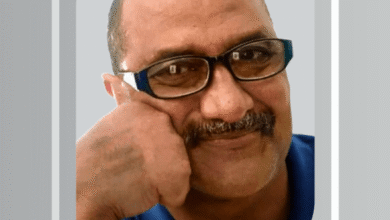القتل على الهوية.. أيام كالحة في تاريخ السودان
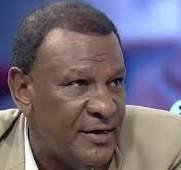
حيدر المكاشفي
إنّ الذي حدث في عدة مناطق بولاية الجزيرة بعد استعادة عاصمتها مدني بواسطة الجيش والقوى المتحالفة معه، لهو قتل على الهوية وخارج إطار القانون بكل المقاييس، وفي كل الشرعات والشرائع، ولست هنا بمعرض إعادة صور القتل والتنكيل وبقر البطون والإلقاء في النيل، تلك الصور والفيديوهات الدموية البشعة التي طالت مجموعة من سكان الكنابي وغيرهم من مواطنين عزل، التي تدل على وحشية ولا إنسانية من ولغوا فيها، إذ يكفي الناس ما أصابهم من أذى ونكد وألم عند مشاهدتهم لها في المرة الأولى، ولن نزيد أوجاعهم وأذاهم مرة أخرى، فالقتل وبشاعة التنكيل الذي وقع على هؤلاء المواطنين العزل، يعكس النظرة العصبية المستعلية التي كانت متغلغة في دماء وعروق العرب في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام أحق الحق وأبطل الباطل، وقرر أنه لا نصرة لظالم بمشاركته في الظلم لأن الأصل في الشريعة الإسلامية أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وعليه فلا يجوز لأحد من الناس أو جماعة منهم اضطهاد الآخرين بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو العرق أو أي سبب كان على النحو الذي حدث في بعض مناطق الجزيرة، لخروج ذلك عن أصول الإسلام، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين، رجلًا من الأنصار ــ أي ضربه على مؤخرته ــ فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما بال دعوى الجاهلية» قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار، فقال: «دعوها فإنها منتنة» فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العقاب على الهوية بأنها خصلة منتنة وهي عبارة تدعو للتنفير من هذا الأمر، ومن جهة أخرى فإن هؤلاء المواطنين العزل وبافتراض أن هناك شكوك حول دعمهم للمليشيا يعتبروا أسرى بعد القبض عليهم أحياء، فقائد المليشيا نفسه إذا قبض عليه حيا يعتبر أسيرًا فما بالك بهؤلاء المواطنين العزل، والطامة الكبرى أن قتلة هؤلاء المواطنين لم يكتفوا بإزهاق أرواحهم، بل مضوا شوطًا أبعد في الخسة والدناءة بتصوير جثامينهم وعرضها على الجمهور متفاخرين ومكبرين الله على جرمهم الشنيع الذي حرمه الله، رغم أنهم كانوا أسرى لديهم ورغم ما تكفله كل الشرائع والمواثيق من حقوق للأسرى، إذ توجب كل الشرائع الدينية وعلى رأسها الإسلام والمواثيق الدولية كاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، معاملة إنسانية، تحفظ كرامتهم، وترعى حقوقهم، وتصون إنسانيتهم، حيث يعتبر الأسير من الفئات الضعيفة التي تستحق الشفقة والإحسان والرعاية، كما تقع مسؤوليته على الدولة، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسير، ويحظر على هذه الدولة أن تقترف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكًا جسيمًا لهذه الاتفاقية، كما لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته، وبالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.. وعطفًا على ما تقدم تكون حكومة الأمر الواقع في بورتسودان وقيادة الجيش هي المسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بإعدام هؤلاء الأسرى والتمثيل بهم خارج إطار القانون، وعليه يبقى المطلوب من حكومة الأمر الواقع وقيادة الجيش، أن يكبحوا منسوبيهم ومليشياتهم الغادرة ويلجموها من التعدي على حدود الله والقانون، وقبل ذلك عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم الكاملة عن تلك الجرائم، ولن يعفيهم عن ذلك التبرير بأنها جرائم فردية كما جاء في بيان الجيش، وقد تكرر مثل هذا التبرير الفج كثيرًا من قبل، حيث درجت كل الأجهزة النظامية من جيش وشرطة ومخابرات ومسلحي حركات، على تبرير ما يرتكبه منسوبوها من تجاوزات وتعديات وانتهاكات ضد مواطنيين عزل، بأنه تصرف فردي معزول ولا علاقة للمؤسسة به، ثم بعد هذا التبرير الفطير يعلنون على طريقة (عدي من وشك) توقيف المعتدين وإخضاعهم للتحقيق توطئة لمحاكمتهم، وتنتهي القضية عند هذا الحد دون معاقبة المجرمين، ونقول مجرمين لأن ما يرتكبه هؤلاء هو جريمة مكتملة الأركان، بل ومركبة يقاضي عليها القانون العسكري والقانون الجنائي المدني أيضًا، وكانت قد تكاثرت بشكل لافت ومقلق اعتداءات بعض الأفراد النظاميين على المواطنين المدنيين العزل، بل أن الاعتداءات على الأطباء لم تتوقف حتى بعد صدور القانون الذي يوفر الحماية للأطباء، ورغم ذلك كلما وقع اعتداء من نظامي على مدني أعزل، تخرج علينا المؤسسة التي يتبع لها هذا النظامي لتبرر الاعتداء بأنه (تصرف فردي لا علاقة للمؤسسة به)، ومن كثرة ما كررت الأجهزة النظامية هذا المبرر حتى صار بائخًا وغير مبرر وغير مبرئ لذمة الأجهزة النظامية، وهذا ما يفرض على هذه الأجهزة أن تضبط تصرفات أفرادها وفقًا للقانون، وأن تخصص لهم من بين دوراتها التدريبية دورات مكثفة عن حقوق الإنسان، يتعلم فيها النظامي عدم الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، ويعرف كيف يصون حياة الناس وسلامتهم البدنية، وأن لا يأخذ القانون بيده حتى في حالة ضبط المجرمين.
الشاهد أن بلادنا عانت في تاريخها القريب عددًا من ارتكاب جرائم على الهوية، نعرض هنا بعضها على سبيل المثال، منها ما عرف اصطلاحًا بـ(احداث الاثنين الأسود)، وكانت هذه الأحداث المأساوية البشعة وقعت في أعقاب مقتل جون قرنق في حادث الطائرة المشهور منتصف عام 2005، بعد وقت قصير من توقيع اتفاقية نيفاشا وتنصيب قرنق نائبًا للرئيس، وقد أفجع موت قرنق قطاع واسع من الشعب السوداني وليس فقط الإخوة الجنوبيين، ولكن الإخوة الجنوبيين وبسسب صدمتهم من الحادث خرجوا زرافات ووحدانا إلى الشوارع يضربون ويخربون ويحرقون كل ما يلاقيهم ويعتبرونه من الشمال ومن أهل الشمال، وكأن أهل الشمال هم من قتلوه، علمًا بأن الطائرة يوغندية وتحركت من مطار يوغندي ويقودها طاقم يوغندي، وكانت تلك الحشود الضخمة من الجنوبيين المؤيدين لقرنق الذين كانوا قد استقبلوه استقبال الأبطال عندما أصبح نائبًا أول للرئيس، انتشروا في شوارع الخرطوم ملوحين بالسكاكين والقضبان الحديدية ونهبوا المتاجر وأشعلوا الحرائق واشتبكوا مع الشرطة، وكانوا يضربون كل من يرون أنه شمالي أو يشبه العرب، وقتل من جراء هذا الشغب العشرات من المواطنين العزل الأبرياء وحرقت عشرات السيارات والمحال، فاضطرت السلطات لفرض حظر التجوال، ولم تكد الخرطوم تلملم جراحها وتواري قتلاها إذا بغارة أخرى مضادة تندلع في اليوم التالي مباشرة ضد الجنوبيين وكل ما هو جنوبي فيما عرف اصطلاحًا بـ(أحداث يوم الثلاثاء الأسود)، وحدث فيه للجنوبيين ذات الذي حدث منهم للشماليين، وكلا الحادثين الأسودين يندرجان تحت توصيف جرائم مرتكبة على الهوية، كما نذكر أيضًا ما عرف اصطلاحا بـ(غزوة أمدرمان) التي شنتها حركة العدل والمساوة بقيادة خليل إبراهيم الذي اغتيل لاحقًا بضربة صاروخية نالت منه في إحدى مناطق كردفان، فبعد دحر الغزوة عمدت السلطات على إلقاء القبض على كل من يبدو من سحنته أو لهجته أنه من دارفور، واعتباره مجرمًا ونصيرًا ومتعاونًا وطابور خامس وخلية نائمة للعدل والمساواة، كما نذكر على أيام التظاهرات الثورية الحملة الشرسة التي شنتها السلطات الأمنية ضد طلاب دارفور باعتبارهم عملاء وخونة وطابور خامس، ولكن الثوار بوعيهم انتبهوا لهذا الفعل الخسيس وانتجوا الهتاف الشهير (يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور)، وغير هذه الأمثلة التي ذكرناها هناك العديد من الأمثلة الأخرى التي تكشف مدى الاستهانة بأرواح الناس وقتلهم بدم بارد خارج إطار القانون، وتقف على رأس هذه الأمثلة ما يمكن تعريفه بالقتل على الهوية السياسية، ونعني حادثة فض الاعتصام البشعة التي ستظل الأكثر سوادًا، وستبقى محفورة فى ذاكرة الأجيال تجترها في أسى جيلًا بعد جيل، وستبقى تلك الجريمة النكراء وصمة لا تمحى وعارًا لن يزول على القيادات العسكرية الذين احتمى بسوح قيادتهم العامة وأقاموا اعتصامهم حولها أولئك الشباب والشابات البواسل، لقد كانت عملية فض الاعتصام القذرة، جريمة مكتملة الأركان، خطط لها المجرمون السفاحون بعناية وكانوا فى كامل الاستعداد والجاهزية بالسلاح والعتاد، بينما كان الضحايا سلميين ومسالمين عزل، بل كانوا يستشعرون الأمان لكونهم فى استجارة من ظنوا إنها قواتهم المسلحة حامية الأرض والعرض، فتخير المجرمون القتلة ساعة السحر حين كان المعتصمون نائمين وهم صيام لتنفيذ جريمتهم البشعة الانتقامية الدموية الشيطانية بلا رحمة ولا وازع من دين ولا أخلاق، وهذا ما يكشف أن هذه الجريمة لم تتم على عجل وإنما بتخطيط وتنسيق وخطة محكمة وتأهيل وتهيئة للمنفذين حتى لا يرأفوا أو تأخذهم شفقة بالمعتصمين. فطاحوا فيهم تقتيلًا وسحلًا ودهسًا واغتصابًا لبعض الحرائر وإلقاء بعض الجثث فى مياه النيل وبعض آخر ما يزال فى عداد المفقودين لا يعرف حتى الآن إن كانوا أمواتًا فينعون أو أحياء يرجون، كما أن تاريخ النظام البائد القمعي مليء بجرائم القتل والسحل وإزهاق الأرواح، إذ كان القتل هو أسهل الطرق التي كان يستخدمها النظام للبقاء في الحكم والتخلص من الخصوم ودفنهم بليل جماعات وفرادى، ومن هذه الجرائم الجريمة التي اصطلح على تسميتها (مجزرة العيلفون)، هذا غير العديد من جرائم القتل التي ولغ فيها النظام، نذكر منها على سبيل المثال مجزرة بورتسودان التي قتل فيها النظام أكثر من عشرين نفسًا، وحادثة كجبار والأعوج بالنيل الأبيض وغيرها من جرائم القتل واستسهال إزهاق الروح وليس بغريب عليهم ولا جديد الذي حدث في ولاية الجزيرة.